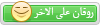بعد هذا الرد ، هنا حذف ، هل لم تره ، فلماذا؟!الأمر حقا مضحك ، بل مثير للشفقة ، أن يخرج علينا من تصفه كتب التاريخ بأنه "بدوي همجي" أو "شبه بدوي يعيش في عزلة اختيارية"، ليشرع في انتقاد العرب واتهامهم بالبدوية!! ، حتى ابن خلدون، الذي يعد مرجعا لا يشكك فيه ، وصف البربر بأنهم قبائل متناحرة ، شديدة التوحش ، يعسر انقيادهم ، ويقل استعدادهم للتحضر ، في مقابل العرب الذين امتازوا بقدرة واضحة على التنظيم السياسي وبناء الدول ، فكيف بمن وصف بهذه الصورة أن يخرج ساخرا من الخيمة والجمل؟!.
الأسوأ من السخرية ، أنه لم يدرك ، أو لعله يدرك ويتجاهل ، أن العرب أنفسهم هم من انتشلوه من خيمته إن كان من بدو البربر ، أو من كهفه ومحراثه إن كان "حضريا" معزولا في قرى الجبال ، ثم بعد كل هذا ، نبتت للصغار أنياب ، فعضوا اليد التي أحسنت إليهم!! ، وهذا حال العرب ، مأكولون مذمومون ، يشاركوننا في المغنم ، هذا أن لم يسلبوه تماما ، كما فعلوا في كل ماعلمناهم ، وينسبون لنا الخسارة ، لصوص حتى في الرجال، فهذا طارق بن زياد بن عبدالله ، والذي قال خطبة ، لا يمكن أن يقولها بربري ، ولو نشأ وتربى في قبيلة بني سعد بن بكر عمره كله ، فلا يمكن لعاقل أن ينسب شخص له اسم ثلاثي عربي أصيل ، لبربري بلا أي هوية عربية ، يخطب خطبة ، عصماء في مفرداتها ، ومع ذلك ، هؤلاء البربر ، كذبوا وصدقوا انفسهم.
أما أن يفخر العراقي أو الشامي أو المصري أو الفارسي، بل وحتى الهندي، بحضارته، فذاك أمر طبيعي ومفهوم ، لكن أن يتطاول من لم يعرف معنى التحضر إلا بعد مجيء العرب، وفقا لما تقره كل المصادر التاريخية ، ويصف العربي بالبدوي تهكما، فهذه هي المهزلة بعينها.
لقد كانت الحضارة على مرمى حجر من قبيلته، ماثلة أمامه في المدن الرومانية المزدهرة على سواحل شمال إفريقيا ، لكنه لم يقترب منها ، ولم يحاول أن يتقن فنونها ، حتى دخل العرب حاملين معهم الإسلام واللغة والنظام، ليجعلوا من المغرب والجزائر وتونس بلادا ذات شأن حضاري.
أما الرومان، فلم يكترثوا للبربر بالمرة ، رأوهم متوحشين يكرهون الاستقرار ويتجنبون العمران، فتركوهم حيث هم، في الجبال والصحراء.
تثبيت التطبيق
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
لماذا نجح التعريب في مصر والشام والمغرب... وفشل في فارس وتركيا؟
- بادئ الموضوع بأحث في التاريخ
- تاريخ البدء
راجع وأنظر من ضرب لها التحية ، فقد تشمل نفسك فيما ذكرتكلمه اينما حل العرب حل الخراب كلمه تدل على جهل و غباء قائلها
دمشق و بغداد و قرطبه و غيرهم لا تدل على اي خراب
و للمره المليون لم يتم حذف اي مشاركه من الموضوع و لم اطلب اي حذف
راجع وأنظر من ضرب لها التحية ، فقد تشمل نفسك فيما ذكرت
وجهه نظر تحترم بصراحه لكن حضرتك تتكلم عن المغرب بس انا كلامي عن المغرب الاكبر الي بيمتد من سيوه للمحيط و طبعا التغيير في كل منطقه يختلف عن الاخرى نظرا للظروف الي موجوده ساعتها
انا عامل إعجاب بردو على مشاركه تناقض ما طرحه الأخأولاً – عن الوجود العربي في شمال أفريقيا
فعادي الاعجاب مش لازم اكون متوافق مع كله ما يقوله 100% ممكن إعجاب علشان طرح كلام مغير عن ما هو مدرج او لانه عمل ليا إعجاب فبردها ليه و غيرها من الأسباب
و كمان من ردي هتلاحظ سبب اعطائي له لايك
كون انك بتتحس من كلمه او جمله و تطرق طرح كامل فده شئ يخصك و لا يشغلني
انا عموما وضحت رائي في الجمله لواحدها يعني
هتيجي تحسبها العرب و البربر ظروفهم متشابهه في مرحله النشاءه كلاهم اعتمد على البداوه او الفلاحه في مناطق نائيه و كلاهما لم يشيد مدن ذات قيمه و كلاهما لم يخضع لسلطه خارجيه مباشره و كلاهما اعتمد على القبليه و غيرها
لكن الي فضل الله بيه العرب هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم منهم و بينهم و توحيده للعرب تحت رأيه واحده و دين واحد عظيم جعلهم امه عظيمه
حتى الدول العربيه كالامويه و الخلافه الراشده و العباسيه في بدايتها عندما جمعت كلمه العرب و وحدتهم كان للعرب مكانه عظيمه و دور فعال
لكن بعد ما تفرقوا و رجعوا لما كانوا عليه قبل الإسلام غاب دور الجزيره العربيه لمده الف سنه عن معترك الحضاره و بقت مناطق البربر و غيرهم منبع مهم للحضاره و الثقافه الاسلاميه سواء بمساهمه عربيه او من قوميات محليه او غيرها في النهايه تتطور تلك المناطق و أصبحت منبع حضاري هام بينما جزيره العرب رجعت لما كانت عليه ممكن ماعدا مكه و المدينه و بعض المدن بسبب المشاعر المقدسه لكن باقي الجزيره معدش ليها اي اهميه
غير لما توحدت على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله و رجع وحد كلمتهم و جمعهم تحت رأيه واحده و بقوا في الخير الي هما فيه حاليا و ان شاء الله هيفضلوا عليه خصوصا ان النعرات القبليه و غيرها الي كانت سبب لتتفرق و المصائب يعتبر انتهت
كلامك غير صحيح، بل مجانب تماما للحقيقة ، العرب شيدوا حضارات موثقة في قلب الجزيرة : حضارة العلا ، مملكة كندة في الفاو ، حضارة المقر ، وتدمر ، ومدائن صالح ، وشارك الغساسنة والمناذرة في الحضارة الرومانية والفارسية ، وامتدت جذورهم العرقية إلى أكاد وآشور وبابل وكنعان (الفينيقيين)، وممالك الشام والعراق، ثم تأتي وتقول إنهم 'متشابهون' مع غيرهم؟!.
بل الأدهى من ذلك أنك الآن تتحدث إلي بجزء من حضارتي ، بلغتي، ومن داخل ثقافتي التي أنشأها العرب، وبلغوها للعالم ، تقول إن العرب غابوا؟!، لقد استمر حضورهم حتى عندما كانت أسماء الحكام غير عربية ، كانوا في الفقه والشريعة والعلم والتاريخ ، وفي عمق العمارة ، بل وحتى في الأزهر الذي تفتخر به ، وكان ولا يزال منارة عربية إسلامية بلسان عربي مبين ، ما يجب أن تفخر به كمصري ، هو الأهرامات والقبور ، واللغة القبطية.
بل الأدهى من ذلك أنك الآن تتحدث إلي بجزء من حضارتي ، بلغتي، ومن داخل ثقافتي التي أنشأها العرب، وبلغوها للعالم ، تقول إن العرب غابوا؟!، لقد استمر حضورهم حتى عندما كانت أسماء الحكام غير عربية ، كانوا في الفقه والشريعة والعلم والتاريخ ، وفي عمق العمارة ، بل وحتى في الأزهر الذي تفتخر به ، وكان ولا يزال منارة عربية إسلامية بلسان عربي مبين ، ما يجب أن تفخر به كمصري ، هو الأهرامات والقبور ، واللغة القبطية.
التعديل الأخير:
انا عامل إعجاب بردو على مشاركه تناقض ما طرحه الأخ
فعادي الاعجاب مش لازم اكون متوافق مع كله ما يقوله 100% ممكن إعجاب علشان طرح كلام مغير عن ما هو مدرج او لانه عمل ليا إعجاب فبردها ليه و غيرها من الأسباب
و كمان من ردي هتلاحظ سبب اعطائي له لايك
كون انك بتتحس من كلمه او جمله و تطرق طرح كامل فده شئ يخصك و لا يشغلني
انا عموما وضحت رائي في الجمله لواحدها يعني
صدقني ، أنا مصدقك ، ولكني أخشى عليك من الفتنة ، أخشى أن يأتي من لا يصدقك ، ولا يعرفك على حقيقتك ، ويقول أنك كذاب ، وإلا فأنا أعرف أنك حقاني.
الأمر حقا مضحك ، بل مثير للشفقة ، أن يخرج علينا من تصفه كتب التاريخ بأنه "بدوي همجي" أو "شبه بدوي يعيش في عزلة اختيارية"، ليشرع في انتقاد العرب واتهامهم بالبدوية!! ، حتى ابن خلدون، الذي يعد مرجعا لا يشكك فيه ، وصف البربر بأنهم قبائل متناحرة ، شديدة التوحش ، يعسر انقيادهم ، ويقل استعدادهم للتحضر ، في مقابل العرب الذين امتازوا بقدرة واضحة على التنظيم السياسي وبناء الدول ، فكيف بمن وصف بهذه الصورة أن يخرج ساخرا من الخيمة والجمل؟!.
الأسوأ من السخرية ، أنه لم يدرك ، أو لعله يدرك ويتجاهل ، أن العرب أنفسهم هم من انتشلوه من خيمته إن كان من بدو البربر ، أو من كهفه ومحراثه إن كان "حضريا" معزولا في قرى الجبال ، ثم بعد كل هذا ، نبتت للصغار أنياب ، فعضوا اليد التي أحسنت إليهم!! ، وهذا حال العرب ، مأكولون مذمومون ، يشاركوننا في المغنم ، هذا أن لم يسلبوه تماما ، كما فعلوا في كل ماعلمناهم ، وينسبون لنا الخسارة ، لصوص حتى في الرجال، فهذا طارق بن زياد بن عبدالله ، والذي قال خطبة ، لا يمكن أن يقولها بربري ، ولو نشأ وتربى في قبيلة بني سعد بن بكر عمره كله ، فلا يمكن لعاقل أن ينسب شخص له اسم ثلاثي عربي أصيل ، لبربري بلا أي هوية عربية ، يخطب خطبة ، عصماء في مفرداتها ، ومع ذلك ، هؤلاء البربر ، كذبوا وصدقوا انفسهم.
أما أن يفخر العراقي أو الشامي أو المصري أو الفارسي، بل وحتى الهندي، بحضارته، فذاك أمر طبيعي ومفهوم ، لكن أن يتطاول من لم يعرف معنى التحضر إلا بعد مجيء العرب، وفقا لما تقره كل المصادر التاريخية ، ويصف العربي بالبدوي تهكما، فهذه هي المهزلة بعينها.
لقد كانت الحضارة على مرمى حجر من قبيلته، ماثلة أمامه في المدن الرومانية المزدهرة على سواحل شمال إفريقيا ، لكنه لم يقترب منها ، ولم يحاول أن يتقن فنونها ، حتى دخل العرب حاملين معهم الإسلام واللغة والنظام، ليجعلوا من المغرب والجزائر وتونس بلادا ذات شأن حضاري.
أما الرومان، فلم يكترثوا للبربر بالمرة ، رأوهم متوحشين يكرهون الاستقرار ويتجنبون العمران، فتركوهم حيث هم، في الجبال والصحراء.
الرد الذي بعد هذا أوجع البربر ، فحذف بقصد ، ولكن ، الذي حذفه ، لم يوجعه ، ماقيل فينا من قبل البربر.
كالعاده تجادل في الفاضي و تذكر كلام علي لساني لم اذكرهكلامك غير صحيح، بل مجانب تماما للحقيقة ، العرب شيدوا حضارات موثقة في قلب الجزيرة : حضارة العلا ، مملكة كندة في الفاو ، حضارة المقر ، وتدمر ، ومدائن صالح ، وشارك الغساسنة والمناذرة في الحضارة الرومانية والفارسية ، وامتدت جذورهم العرقية إلى أكاد وآشور وبابل وكنعان والفينيقيين، وممالك الشام والعراق، ثم تأتي وتقول إنهم 'متشابهون' مع غيرهم؟
بل الأدهى من ذلك أنك الآن تتحدث إلي بجزء من حضارتي ، بلغتي، ومن داخل ثقافتي التي أنشأها العرب، وبلّغوها للعالم ، تقول إن العرب غابوا؟!، لقد استمر حضورهم حتى عندما كانت أسماء الحكام غير عربية ، كانوا في الفقه والشريعة والعلم والتاريخ، وفي عمق العمارة ، بل وحتى في الأزهر الذي تفتخر به، وكان ولا يزال منارة عربية إسلامية بلسان عربي مبين ، ما يجب أن تفخر به كمصري ، هو الأهرامات والقبور ، واللغة القبطية.
مكتوب بكل وضوح في مشاركتي كلمه مساهمه عربيه و مكتوب بكل وضوع في مشاركتي كلمه الجزيره العربيه و لم اقل غاب العرب كعرق الف سنه
و الحضارات العربيه الي انت ذكرتها كلها حضارات لها الاحترام و انا ذكرتها في الموضوع عادي لكن هل كان لهم تاثير علي الحضاره البشريه كما فعل العرب بعد الاسلام الاجابه لا
انا كمصري فخري اني مسلم اما غيرها من الامور فاشياء تستحق التامل و التدير و العلم سواء سالبيها او ايجابيها لكن لا اعطيعها اكبر من حجمها
كم قلت انا لم اطالب باي حذف و تقدر ترجع للاشراف و الادراه لو لقوا مني طلب حذف امني يعروفنا هنا ليخلصونا من مظلوميتكالرد الذي بعد هذا أوجع البربر ، فحذف بقصد ، ولكن ، الذي حذفه ، لم يوجعه ، ماقيل فينا من قبل البربر.
لا يهم تصدقيك او تكذيبك في النهايه نحن في منتدي و بندردش مش معانا قدريه سحريه لتغيير التاريخ يعني علي حسب الي بنكتبهصدقني ، أنا مصدقك ، ولكني أخشى عليك من الفتنة ، أخشى أن يأتي من لا يصدقك ، ولا يعرفك على حقيقتك ، ويقول أنك كذاب ، وإلا فأنا أعرف أنك حقاني.
لكن بعد ما تفرقوا و رجعوا لما كانوا عليه قبل الإسلام غاب دور الجزيره العربيه لمده الف سنه عن معترك الحضاره
كالعاده تجادل في الفاضي و تذكر كلام علي لساني لم اذكره
مكتوب بكل وضوح في مشاركتي كلمه مساهمه عربيه و مكتوب بكل وضوع في مشاركتي كلمه الجزيره العربيه و لم اقل غاب العرب كعرق الف سنه
و الحضارات العربيه الي انت ذكرتها كلها حضارات لها الاحترام و انا ذكرتها في الموضوع عادي لكن هل كان لهم تاثير علي الحضاره البشريه كما فعل العرب بعد الاسلام الاجابه لا
انا كمصري فخري اني مسلم اما غيرها من الامور فاشياء تستحق التامل و التدير و العلم سواء سالبيها او ايجابيها لكن لا اعطيعها اكبر من حجمها
الم تقل هذا الكلام :
لكن بعد ما تفرقوا و رجعوا لما كانوا عليه قبل الإسلام غاب دور الجزيره العربيه لمده الف سنه عن معترك الحضاره
كيف غاب العرب ، وإرثهم موجود؟!.
لم أقل أنه أنت ، فلم تتهم نفسك؟!.كم قلت انا لم اطالب باي حذف و تقدر ترجع للاشراف و الادراه لو لقوا مني طلب حذف امني يعروفنا هنا ليخلصونا من مظلوميتك
لا يهم تصدقيك او تكذيبك في النهايه نحن في منتدي و بندردش مش معانا قدريه سحريه لتغيير التاريخ يعني علي حسب الي بنكتبه
قلت أني مصدقك يامسلم ، دوك ولا تزعل: 🌹
مكتوب بشكل واضح غاب دور الجزيره العربيه هل مذكور غاب العرق العربيالم تقل هذا الكلام :
كيف غاب العرب ، وإرثهم موجود؟!.
تقدر طول الالاف السنه بعد صعود الترك و الفرس في الدوله العباسيه دور مهم لدوله نشائت في جزيره العرب الاجابه لا
لكن كعرب استمر حضورهم ثقافيا و علميا و اداريا حتي انهم اسسوا دول نشائت خارج الجزيره العربيه
ههه سياق الكلام مفهوم المقصود منهلم أقل أنه أنت ، فلم تتهم نفسك؟!.
و لو مش قصدك فالحمدلله انك اخيرا فهمت
اعيد ما ذكرته ، من الرد المحذوف ، مع أضافة تكملة جديدة مفيدة :
========================
"قليل من المدن والقصور في إفريقية والمغرب، لأن هذه الجهات كانت للبربر آلاف السنين … جميع حضارتهم كانت حضارة بدوية … لم يكن لهم فنّ يعرفونه … لم يكن لهم اهتمام بالبناء ولا المدن."
— ابن خلدون، المقدمة.
========================
قول ابن خلدون:
"قليل من المدن والقصور في إفريقية والمغرب، لأن هذه الجهات كانت للبربر آلاف السنين … جميع حضارتهم كانت حضارة بدوية … لم يكن لهم فنّ يعرفونه … لم يكن لهم اهتمام بالبناء ولا المدن."
— ابن خلدون، المقدمة.
أقوال الباحثين الغربيين:
- ميشيل برنت (Michael Brett) وإليزابيث فينتريس (Elizabeth Fentress)
الدراسة: The Berbers (1996)"كان السكان البربر الأصليون في شمال أفريقيا في الغالب بدوًا أو شبه بدويين ولم يؤسسوا مدنًا. كانت المراكز الحضرية على الساحل المتوسطي، مثل قرطاج، قد أسسها وطورها الفينيقيون ثم الرومان. ولم تبدأ المجتمعات البربرية في تجربة التنمية الحضرية والتحول الثقافي إلا بعد الفتح العربي في القرن السابع." - جون رايت (John Wright)
الدراسة: North Africa: A History from Antiquity to the Present (1995)"قبل الفتوحات العربية، كانت مجتمعات البربر في الغالب ريفية وقبلية، تفتقر إلى بنى تحتية حضرية مهمة. كانت المدن الكبرى في المنطقة تراثًا للفينيقيين والرومان. قدم العرب الإسلام وهياكل اجتماعية جديدة مكنت البربر من التطور ثقافيًا وحضريًا." - برنارد لويس (Bernard Lewis)
الدراسة: The Arabs in History (1993)"كانت المجتمعات البربرية قبل وصول العرب شبه بدوية، ولم يكن لديهم اهتمام واضح بالبناء الحضري أو المعمار. المدن الكبرى في شمال أفريقيا كانت من صنع الفينيقيين والرومان، ولم يبدأ التوسع الحضري الحقيقي إلا بعد وصول العرب."
الدراسات الحديثة (بعد التسعينات):
- جون فانسا (John V.ansah)
الدراسة: The History of Berber Societies and Their Civilization (2006)"كانت المجتمعات البربرية في شمال أفريقيا قبل الفتح العربي تعتمد على الحياة البدوية والقبائلية بشكل أساسي. لم يكن هناك تطور حقيقي في بناء المدن أو الحضارة الحضرية؛ بل كانت المراكز الحضرية على الساحل ناتجة عن الاستعمار الفينيقي والروماني. كانت حضارة البربر بدوية بطبيعتها ولم تشرع في التحولات الكبرى إلا بعد انتشار الإسلام." - هارولد إيمس (Harold Eames)
الدراسة: The Arabs and the Berbers: A Historical Relationship (2012)"في الفترة ما قبل الفتح العربي، لم تكن لدى المجتمعات البربرية تقاليد حضرية متطورة كما كانت الحال في الإمبراطوريات الكبرى في البحر الأبيض المتوسط مثل الإمبراطورية الرومانية. المدن الساحلية مثل قرطاج كانت تحت سيطرة الفينيقيين والرومان، بينما كانت غالبية البربر تعيش في مجتمعات ريفية. الفتح العربي هو الذي بدأ في تغيير هذا الواقع، مع دخول الإسلام وأثره في تكوين حضارة أكثر تحضرًا." - ماتيو ستاين (Mathew Stein)
الدراسة: Berbers Before Islam: The Nomadic Roots (2018)"عاش البربر لآلاف السنين في مجتمعات قبلية وبدوية، ولم يعرفوا البناء الحضري أو المعمار المتقدم قبل وصول العرب. المدن الكبرى التي وجدت في المنطقة كانت من بناء الفينيقيين والرومان. بمجرد وصول العرب، بدأ البربر في الانخراط في شكل من أشكال الحياة الحضرية بمساعدة من التحولات الثقافية والدينية المرتبطة بالإسلام."
ملاحظات إضافية:
- يشير معظم المؤرخين إلى أن المجتمعات البربرية كانت تفتقر إلى التحضر في الجوانب المعمارية والحضرية قبل الفتح العربي، مع تأكيد على تأثير الفينيقيين والرومان في تأسيس المدن الكبرى على الساحل.
- يلاحظ أن التحولات الحقيقية في المجتمعات البربرية بدأت مع دخول العرب والإسلام، وهو ما أدى إلى تطور ثقافي وحضري كبير.
الطرافة الحقيقية ، هي أن تركن لمن يكتب عنك ، وتمثل جسرا بين الكاتب والمحاور ، ثم تحدثني وتحاضرني عن من "يلتقط بلا صنعة" ، فهذا مخالف لتلك الجملة "القوية" بكل تأكيد.
أما موضوع الكهوف والقصيبات والبيوت الطينية ، فهي واقع تاريخي لهم ، لا مفر لهم منه ، وليست عيباً يخجلوا منه ، فهذا حالهم كما نقلناه لهم ، ونحن تعلمنا أن نفخر بخيامنا وأبلنا ، فلماذا لا يتعلم الآخرون أن يتعايشوا مع واقعهم كما نحن فعلنا؟! ، فهل تستطيع أن ترجع للـ chatgpt ، وتطلب منه أن يكتب لك شيء يواسي من ظن أنه ملك الدنيا ولمس السماء ، فقط ، لترشده للطريق القويم ، بدل من ممارسة دور المحامي عن الأخرين؟!.
، وأما "الجبن" ، فلا أدري من أين تلقفته ، لذا ، أرجع للـ chatgpt ، وسله ما قصته ، بدل من ارباك النقاش عن الجبن والقشطة؟!.
من يظن أن الطرافة في الاستناد على غيره، فذلك رأيه، أما أنا فأكتب وأفكر وأعبّر بما أراه جديرًا، ولم أحتج إلى جسر ولا وصاية لبلاغتي. أما ما تتحدث عنه من كهوف وبيوت طين، فهي تراث لا يُنكر، والتاريخ ليس عيبًا، بل هو شاهد على تطور الأمم. كما نفتخر بخيامنا وإبلنا، من العدل أن يُفتخر كل طرف بماضيه مهما كان شكله، فهذا واقع لا يعيب أحدًا.
أما الإشارة إلى من يظن نفسه مَلِكَ الدنيا وقد لمس السماء، فليتذكر أن العلوّ لا يكون بالانتقاص من الآخرين، بل بالسمو على النفس وتواضع الفكر. ومن أراد الطريق القويم، فليترك الغرور جانبًا، وليعتبر أن القيمة الحقيقية تُقاس بما نزرعه من أثر، لا بما ندعيه من مجد. فإن كان عندك نقدٌ حقيقي، فهاتِه، وإلا فالصمت أبلغ من إثارة قشور لا تغني عن جوهر.
أما الإشارة إلى من يظن نفسه مَلِكَ الدنيا وقد لمس السماء، فليتذكر أن العلوّ لا يكون بالانتقاص من الآخرين، بل بالسمو على النفس وتواضع الفكر. ومن أراد الطريق القويم، فليترك الغرور جانبًا، وليعتبر أن القيمة الحقيقية تُقاس بما نزرعه من أثر، لا بما ندعيه من مجد. فإن كان عندك نقدٌ حقيقي، فهاتِه، وإلا فالصمت أبلغ من إثارة قشور لا تغني عن جوهر.
مكتوب بشكل واضح غاب دور الجزيره العربيه هل مذكور غاب العرق العربي
تقدر طول الالاف السنه بعد صعود الترك و الفرس في الدوله العباسيه دور مهم لدوله نشائت في جزيره العرب الاجابه لا
لكن كعرب استمر حضورهم ثقافيا و علميا و اداريا حتي انهم اسسوا دول نشائت خارج الجزيره العربيه
أولا : يجب أن تفهم ياعزيزي ، أن الحضارة أرث إنساني ، خصوصا في العالم القديم ، هذا بخلاف حضارات العالم الجديد ، فتلك الحضارات ، هي الوحيدة ، التي ممكن أن نطلق عليها أرث لعرقية واحدة ، مهما تعددت ممالكها.
ثانيا : أغلب الحضارات التي نشأت ، كانت من عرقية سامية ، هاجرت من الجزيرة العربية ، موطن الساميين الأصلي ، وهذا لا ينفي أن هنالك عرقيات أخرى تداخلات معها ، مثل العرقية السومرية ، والتي تنسب لعرق مجهول لحد اللحظة ، وكل هذا التداخل ، أثرى هذا الإرث بصورة جمعية ، وحق علينا ، أن نرد على أي كان في استصغر وضعنا ، أو عرقنا ، وتبين الحقيقة للجميع ، فعندما يأتي الفارسي يفخر بإرثه ، ويزدري البدوي العربي ، فهو لا يعرف ، أو لا يريد أن يعرف ، أنه جاء من بيئة بدوية أساسا ، سيطر على منطقة ، كانت فيها حضارات قديمة جدا ، حضارات كان أغلب من أسسها العرق السامي من الجزيرة العربية ، ومن ثم ، كان لزام علينا أن نعرفه حقيقته ، وكيف كان وضع أجداده ، ومن ورث الحضارة منه ، مثله مثل البربري ، ومثل بقية الأمم.
ثالثا : أنا لا أسخر من أحد ، ولا أحب ذلك ، ولكن ، في بعض المرات ، صيغة الحوار ، هي من تجعل النص يميل إلى السخرية المضادة ، والمثير ، أن من يبدأ بالسخرية ، هو أول من يبكي!!.
رابعا : عندما ذكرت في أحد المواضيع أن الجنس العربي ، هو جنس مقدم على غير ، الغالبية من الجهلة ضحكوا ، ولم يدركوا أن هذا مبني على حديث صحيح ، ولهذا ، المرء يتساءل ، لِمَ ، على سبيل المثال ، المصريين يحفظون حديثا عن رفعة مصر ورجالها ، وهو حديث موضوع ، ويستغربون وينفون الحديث الصحيح.
خامسا : في أغلب الأحيان ، تكون ردودي جافة وموجهة ، ولكني ، في الحقيقة ، لا أكن إلا الخير للطرف المقابل ، ولم أنبذ أي شخص هنا بتاتا ، إلا شخص واحد فقط ، قال مقولة ، لا يطهرها المطر عشرين قرن ، وأما البقية ، فلهم عندي كامل الاحترام ، والاختلاف في الرأي ، لا يفسد للود قضية.
ثانيا : أغلب الحضارات التي نشأت ، كانت من عرقية سامية ، هاجرت من الجزيرة العربية ، موطن الساميين الأصلي ، وهذا لا ينفي أن هنالك عرقيات أخرى تداخلات معها ، مثل العرقية السومرية ، والتي تنسب لعرق مجهول لحد اللحظة ، وكل هذا التداخل ، أثرى هذا الإرث بصورة جمعية ، وحق علينا ، أن نرد على أي كان في استصغر وضعنا ، أو عرقنا ، وتبين الحقيقة للجميع ، فعندما يأتي الفارسي يفخر بإرثه ، ويزدري البدوي العربي ، فهو لا يعرف ، أو لا يريد أن يعرف ، أنه جاء من بيئة بدوية أساسا ، سيطر على منطقة ، كانت فيها حضارات قديمة جدا ، حضارات كان أغلب من أسسها العرق السامي من الجزيرة العربية ، ومن ثم ، كان لزام علينا أن نعرفه حقيقته ، وكيف كان وضع أجداده ، ومن ورث الحضارة منه ، مثله مثل البربري ، ومثل بقية الأمم.
ثالثا : أنا لا أسخر من أحد ، ولا أحب ذلك ، ولكن ، في بعض المرات ، صيغة الحوار ، هي من تجعل النص يميل إلى السخرية المضادة ، والمثير ، أن من يبدأ بالسخرية ، هو أول من يبكي!!.
رابعا : عندما ذكرت في أحد المواضيع أن الجنس العربي ، هو جنس مقدم على غير ، الغالبية من الجهلة ضحكوا ، ولم يدركوا أن هذا مبني على حديث صحيح ، ولهذا ، المرء يتساءل ، لِمَ ، على سبيل المثال ، المصريين يحفظون حديثا عن رفعة مصر ورجالها ، وهو حديث موضوع ، ويستغربون وينفون الحديث الصحيح.
خامسا : في أغلب الأحيان ، تكون ردودي جافة وموجهة ، ولكني ، في الحقيقة ، لا أكن إلا الخير للطرف المقابل ، ولم أنبذ أي شخص هنا بتاتا ، إلا شخص واحد فقط ، قال مقولة ، لا يطهرها المطر عشرين قرن ، وأما البقية ، فلهم عندي كامل الاحترام ، والاختلاف في الرأي ، لا يفسد للود قضية.
من يظن أن الطرافة في الاستناد على غيره، فذلك رأيه، أما أنا فأكتب وأفكر وأعبّر بما أراه جديرًا، ولم أحتج إلى جسر ولا وصاية لبلاغتي. أما ما تتحدث عنه من كهوف وبيوت طين، فهي تراث لا يُنكر، والتاريخ ليس عيبًا، بل هو شاهد على تطور الأمم. كما نفتخر بخيامنا وإبلنا، من العدل أن يُفتخر كل طرف بماضيه مهما كان شكله، فهذا واقع لا يعيب أحدًا.
أما الإشارة إلى من يظن نفسه مَلِكَ الدنيا وقد لمس السماء، فليتذكر أن العلوّ لا يكون بالانتقاص من الآخرين، بل بالسمو على النفس وتواضع الفكر. ومن أراد الطريق القويم، فليترك الغرور جانبًا، وليعتبر أن القيمة الحقيقية تُقاس بما نزرعه من أثر، لا بما ندعيه من مجد. فإن كان عندك نقدٌ حقيقي، فهاتِه، وإلا فالصمت أبلغ من إثارة قشور لا تغني عن جوهر.
ياسلام عليكم ، أو بالأصح ، "ياسلام عليه".
عزيزي العيناوي القديم ، وأنت تحمل هذه الدرر ، لِمَ لم توجهها للطرف المقابل؟! ، الطرف المقصود من هذه الدرر؟!.
كل الذي ذكره الـ chatgpt ، هو أنه شدد على ماقلته أنا أساسا ، فحبذا أن ترجع له ، وتسأله : الخطاب موجه لمن؟! ، قبل أن تنقله!!.
عزيزي العيناوي القديم ، وأنت تحمل هذه الدرر ، لِمَ لم توجهها للطرف المقابل؟! ، الطرف المقصود من هذه الدرر؟!.
كل الذي ذكره الـ chatgpt ، هو أنه شدد على ماقلته أنا أساسا ، فحبذا أن ترجع له ، وتسأله : الخطاب موجه لمن؟! ، قبل أن تنقله!!.
🌹
الكلام على الكل مش شخص أو فئه معينه لواحدهاياسلام عليكم ، أو بالأصح ، "ياسلام عليه".
عزيزي العيناوي القديم ، وأنت تحمل هذه الدرر ، لِمَ لم توجهها للطرف المقابل؟! ، الطرف المقصود من هذه الدرر؟!.
كل الذي ذكره الـ chatgpt ، هو أنه شدد على ماقلته أنا أساسا ، فحبذا أن ترجع له ، وتسأله : الخطاب موجه لمن؟! ، قبل أن تنقله!!.
🌹
اعيد ما ذكرته ، من الرد المحذوف ، مع أضافة تكملة جديدة مفيدة :
========================
قول ابن خلدون:
"قليل من المدن والقصور في إفريقية والمغرب، لأن هذه الجهات كانت للبربر آلاف السنين … جميع حضارتهم كانت حضارة بدوية … لم يكن لهم فنّ يعرفونه … لم يكن لهم اهتمام بالبناء ولا المدن."
— ابن خلدون، المقدمة.
أقوال الباحثين الغربيين:
الدراسة: The Berbers (1996)
الدراسة: North Africa: A History from Antiquity to the Present (1995)
الدراسة: The Arabs in History (1993)
الدراسات الحديثة (بعد التسعينات):
الدراسة: The History of Berber Societies and Their Civilization (2006)
الدراسة: The Arabs and the Berbers: A Historical Relationship (2012)
الدراسة: Berbers Before Islam: The Nomadic Roots (2018)
ملاحظات إضافية:
الزليج ، كان البربر ، في السابق ، قبل مجيئ العرب ، يزينون به خيامهم ، وبالطبع ، كان له أسم خلاف "الزليج" ، اسم بربري عتيق ، جاء الغزاة ، وأخذوه وسجلوه باسم عربي!!.
المواضيع المشابهة
- الردود
- 60
- المشاهدات
- 7K
- الردود
- 1
- المشاهدات
- 764
- الردود
- 116
- المشاهدات
- 17K
- الردود
- 0
- المشاهدات
- 2K