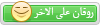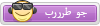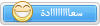تحياتي استاذي الغاليموضوع جميل
ومجهود كبير
شكرا لك استمتعت بالقراءه
تثبيت التطبيق
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
لماذا نجح التعريب في مصر والشام والمغرب... وفشل في فارس وتركيا؟
- بادئ الموضوع بأحث في التاريخ
- تاريخ البدء
في انتظار اضافاتك استاذي و ان شاء الله تبقي حاجه مبهره و مفيدهالعفو اخي الكريم وشكرا على مجهودك
ولكن سأضيف معلومات اكثر فيما يخص العراق
و بردو لو اي عضو هيكون عندو اضافه او معلومه للاسف غابت عني او شئ هكون مبسوط جدا باضافتها
موضوع رااااائع وجميل جدا
سوف اقرأه بتمعن واضع تعليقي عليه في ما بعد
سوف اقرأه بتمعن واضع تعليقي عليه في ما بعد
اولا شكرا يا غالي على الموضوع الرائع والجميل ومجهودك وتعبك
ثانيا احب اضيف ان اللغة العربية تتميز عن باقي اللغات علي المستوي العالمي
العربية تحتوي على عدد هائل من المفردات، حتى أن بعض التقديرات تذكر أن معجمها يتجاوز 12 مليون كلمة، وهذا يمنحها قدرة على التعبير عن أدق المعاني والفروق اللغوية.
2. الجذر الثلاثي
أغلب الكلمات تُشتق من جذر ثلاثي (وأحياناً رباعي)، ما يجعل اللغة مرنة جدًا في توليد كلمات جديدة من أصل واحد، مثل: كتب → كاتب، مكتوب، مكتبة، كتاب، كتابة… إلخ.
3. الإعجاز البلاغي
نظامها النحوي والصرفي يعطي إمكانيات هائلة للتلاعب بالألفاظ، وتقديم الجمل وتأخيرها دون الإخلال بالمعنى، وهو ما جعل القرآن الكريم يتحدى العرب بفصاحته.
4. الترابط بين الصوت والمعنى
كثير من الألفاظ العربية لها أصوات توحي بمعناها، مثل كلمة "خرير" للماء، أو "زقزقة" للعصافير.
5. غنى التصريف
يمكن للفعل الواحد أن يُصرف في عشرات الأشكال ليدل على الزمن، والعدد، والجنس، والحالة، والضمير، وهو ما لا يتوفر في كثير من اللغات الحديثة.
6. الخط العربي الجمالي
الحروف العربية متصلة، مما أتاح تطوير فنون خطية (كالكوفي، والثلث، والديواني) تُعد من أجمل الفنون البصرية في العالم.
7. لغة حية منذ قرون
العربية الفصحى ما زالت مفهومة منذ أكثر من 1400 سنة، بخلاف كثير من اللغات التي تغيرت جذريًا عبر الزمن.
8. انتشار عالمي وديني
هي لغة القرآن الكريم، ويتحدث بها أو يدرسها أكثر من 400 مليون شخص، إضافةً إلى مليار ونصف مسلم حول العالم يقرؤون بها القرآن في صلواتهم.
9. الدقة في التعبير عن المعاني
يمكن للعربية أن تفرق بين معانٍ متقاربة جدًا، فمثلاً لها عشرات الأسماء للسيف، وللجمل، وللحب، ولكل درجة معنى خاص.
ثانيا احب اضيف ان اللغة العربية تتميز عن باقي اللغات علي المستوي العالمي
العربية تحتوي على عدد هائل من المفردات، حتى أن بعض التقديرات تذكر أن معجمها يتجاوز 12 مليون كلمة، وهذا يمنحها قدرة على التعبير عن أدق المعاني والفروق اللغوية.
2. الجذر الثلاثي
أغلب الكلمات تُشتق من جذر ثلاثي (وأحياناً رباعي)، ما يجعل اللغة مرنة جدًا في توليد كلمات جديدة من أصل واحد، مثل: كتب → كاتب، مكتوب، مكتبة، كتاب، كتابة… إلخ.
3. الإعجاز البلاغي
نظامها النحوي والصرفي يعطي إمكانيات هائلة للتلاعب بالألفاظ، وتقديم الجمل وتأخيرها دون الإخلال بالمعنى، وهو ما جعل القرآن الكريم يتحدى العرب بفصاحته.
4. الترابط بين الصوت والمعنى
كثير من الألفاظ العربية لها أصوات توحي بمعناها، مثل كلمة "خرير" للماء، أو "زقزقة" للعصافير.
5. غنى التصريف
يمكن للفعل الواحد أن يُصرف في عشرات الأشكال ليدل على الزمن، والعدد، والجنس، والحالة، والضمير، وهو ما لا يتوفر في كثير من اللغات الحديثة.
6. الخط العربي الجمالي
الحروف العربية متصلة، مما أتاح تطوير فنون خطية (كالكوفي، والثلث، والديواني) تُعد من أجمل الفنون البصرية في العالم.
7. لغة حية منذ قرون
العربية الفصحى ما زالت مفهومة منذ أكثر من 1400 سنة، بخلاف كثير من اللغات التي تغيرت جذريًا عبر الزمن.
8. انتشار عالمي وديني
هي لغة القرآن الكريم، ويتحدث بها أو يدرسها أكثر من 400 مليون شخص، إضافةً إلى مليار ونصف مسلم حول العالم يقرؤون بها القرآن في صلواتهم.
9. الدقة في التعبير عن المعاني
يمكن للعربية أن تفرق بين معانٍ متقاربة جدًا، فمثلاً لها عشرات الأسماء للسيف، وللجمل، وللحب، ولكل درجة معنى خاص.
مافيك تقول نجح بشام بنسبة 100 بلمية لان لحد هلق منحكي كلمات سريانية بلهجتنا ومتداولةبسم الله الرحمن الرحيم
منذ أربعة عشر قرنًا، لم يكن ما حدث في الشرق والغرب مجرد فتحٍ عسكري، بل كان تحوّلًا حضاريًا غيّر وجه الزمان والمكان. ففي غضون قرون قليلة، غيّرت اللغة العربية خريطة شعوبٍ كاملة، فصارت لسان المصريين، والشوام، والعراقيين، وسكان المغرب العربي من ليبيا إلى موريتانيا، بعد أن كانت هذه الشعوب تتكلم القبطية والآرامية والبربرية ولغات أخرى طُمست أو انكمشت أمام سطوة العربية.
لكن الغريب أن هذا التحوّل لم يحدث في مناطق أخرى دخلها الإسلام مبكرًا، مثل فارس الكبرى والبلاد التركية الممتدة من الأناضول إلى ما وراء النهر. فقد بقي الفرس على لغتهم، وصمدت الفارسية أمام العربية رغم أن القرآن كُتب بها، والحكم الإسلامي استمر في بلادهم لقرون. وكذلك الترك، من السلاجقة إلى الغزنويين والقراخانيين، حافظوا على لسانهم رغم اندماجهم العميق في قلب الحضارة الإسلامية.
وقد جاء هذا الموضوع بدافعٍ من الجدل المتكرّر الذي يثور كلما طُرح سؤال التعريب:
هل حدث بسرعة؟ هل فُرض بالقوة؟ هل كان نتيجة استبدال ثقافي قسري؟
يتكرر الطعن والتشكيك من أكثر من جهة: بعض القوميين العرب يرونه دليلًا على قوة ثقافتهم وهيمنتها الحضارية، وبعض القوميين غير العرب يرونه جرحًا في الهوية وطمسًا لخصوصيات الشعوب. وبين الطرفين، تضيع الحقائق التاريخية تحت سطوة الأيديولوجيا والانفعالات.
قال المؤرخ عبد العزيز الدوري:
وقال ابن خلدون:
أما المستشرق إرنست رينان فأقر بدهشة:
هذا الموضوع محاولة لقراءة التجربة كما حدثت: لا تمجيدًا للعروبة، ولا تباكيًا على الهويات، بل فهمًا لما جرى. كيف كانت تلك الشعوب قبل الإسلام؟ ما الذي جعل بعضهم يتحدثون العربية دون قسر؟ ولماذا حافظ آخرون على ألسنتهم؟ ومتى تكون اللغة جسرًا للتلاقي، ومتى تُصبح ساحةً للتنازع؟
رحلة نبدأها من الجاهلية وتمتد إلى العصر الحديث، لفهم كيف تغيّرت ألسنة أمم، وكيف احتفظت أمم أخرى بلسانها… رغم وحدة الدين والمصير.
مافيك تقول نجح بشام بنسبة 100 بلمية لان لحد هلق منحكي كلمات سريانية بلهجتنا ومتداولة
ذكرت ده اخي الكريم طبعا التغيير عمره ما هيكون مئه في المئه بس مقارنه بالفرس و الترك فلا في تغير اتمنى حضرتك تكون فهمت قصدي
المرحلة الخامسة: ولادة لهجة الشام العربية
مع ذوبان اللغات القديمة، وخصوصًا السريانية، في العربية، وُلدت لهجة شامية مميزة. كان التأثير السرياني واضحًا في بعض الأصوات، مثل قلب القاف همزة في المدن، وبعض المفردات مثل "بكّير" (مبكر)، و"شوب" (حر)، و"شتي" (مطر).
المقدسي لاحظ هذا في القرن الرابع الهجري فقال:
لكن العربية الفصحى ظلت قوية في الكتابة والأدب، مما جعل اللهجة قريبة منها نسبيًا.
المرحلة السادسة: اكتمال التعريب – انحسار اللغات القديمة
بحلول القرن الثالث الهجري، كانت العربية قد أصبحت لغة الشعب، واليونانية والسريانية انحصرتا في الكنائس وبعض الأديرة. المؤرخ البكري يصف دمشق في زمنه قائلاً:
هذا التحول كان نتيجة تضافر سلطان الدولة، وجاذبية الدين، والتجارة، والهجرات العربية التي جعلت العربية في الشام ليست مجرد لغة رسمية، بل هوية مشتركة.
ان شاء الله يعجبك في انتظار تعليقاتك و النقاش الي هينتج عنها و ان شاء الله نستفادموضوع رااااائع وجميل جدا
سوف اقرأه بتمعن واضع تعليقي عليه في ما بعد
هي من أعظم اللغات بصراحه و نعمه كبيره ان احنا مولودين و احنا عرفينهااولا شكرا يا غالي على الموضوع الرائع والجميل ومجهودك وتعبك
ثانيا احب اضيف ان اللغة العربية تتميز عن باقي اللغات علي المستوي العالمي
العربية تحتوي على عدد هائل من المفردات، حتى أن بعض التقديرات تذكر أن معجمها يتجاوز 12 مليون كلمة، وهذا يمنحها قدرة على التعبير عن أدق المعاني والفروق اللغوية.
2. الجذر الثلاثي
أغلب الكلمات تُشتق من جذر ثلاثي (وأحياناً رباعي)، ما يجعل اللغة مرنة جدًا في توليد كلمات جديدة من أصل واحد، مثل: كتب → كاتب، مكتوب، مكتبة، كتاب، كتابة… إلخ.
3. الإعجاز البلاغي
نظامها النحوي والصرفي يعطي إمكانيات هائلة للتلاعب بالألفاظ، وتقديم الجمل وتأخيرها دون الإخلال بالمعنى، وهو ما جعل القرآن الكريم يتحدى العرب بفصاحته.
4. الترابط بين الصوت والمعنى
كثير من الألفاظ العربية لها أصوات توحي بمعناها، مثل كلمة "خرير" للماء، أو "زقزقة" للعصافير.
5. غنى التصريف
يمكن للفعل الواحد أن يُصرف في عشرات الأشكال ليدل على الزمن، والعدد، والجنس، والحالة، والضمير، وهو ما لا يتوفر في كثير من اللغات الحديثة.
6. الخط العربي الجمالي
الحروف العربية متصلة، مما أتاح تطوير فنون خطية (كالكوفي، والثلث، والديواني) تُعد من أجمل الفنون البصرية في العالم.
7. لغة حية منذ قرون
العربية الفصحى ما زالت مفهومة منذ أكثر من 1400 سنة، بخلاف كثير من اللغات التي تغيرت جذريًا عبر الزمن.
8. انتشار عالمي وديني
هي لغة القرآن الكريم، ويتحدث بها أو يدرسها أكثر من 400 مليون شخص، إضافةً إلى مليار ونصف مسلم حول العالم يقرؤون بها القرآن في صلواتهم.
9. الدقة في التعبير عن المعاني
يمكن للعربية أن تفرق بين معانٍ متقاربة جدًا، فمثلاً لها عشرات الأسماء للسيف، وللجمل، وللحب، ولكل درجة معنى خاص.
لذلك مش من العجيب انها لغه القرآن الكريم
ما زالت عملية التعريب لم تنجح لا ايديولوجيا و لا لغويا و لا عرقيا في المغرب
الدارجة ما زالت تغلب عليها مصطلحات امازيغية من منطقة الى منطقة تجد اختلاف في النطق
ريف المغرب و وسط المغرب ان لم اقل كلهم فهم يتحدثون الامازيغية و العربية يتخدونها لغة الدين لا غير
العرب منذ القدم في المغرب كان يتم طردهم في عهد الثورات الامازيغية و عهد المرينيين لاسباب تاريخية من بينها معاملة الامازيغ المسلمين كاشخاص من درجة الثانية رغم انهم قبلوا الاسلام و الكتاب و حاربوا الى جانب العرب و ساهموا في الادخال الاسلام الى باقي المناطق في المغرب
التاريخ لم يذكر اي من معارك الردة في المغرب و فوز المرتدين بالمناسبة , التاريخ باهت جدا في هذه النقطة على اي من تلك اللحظة و اهل المغرب يفضلون الحصول على خصوصيتهم في هذا الجانب معمار و لغة و خط و مساجد و لباس خاص بهم لا خارج ثقافتهم
الدارجة ما زالت تغلب عليها مصطلحات امازيغية من منطقة الى منطقة تجد اختلاف في النطق
ريف المغرب و وسط المغرب ان لم اقل كلهم فهم يتحدثون الامازيغية و العربية يتخدونها لغة الدين لا غير
العرب منذ القدم في المغرب كان يتم طردهم في عهد الثورات الامازيغية و عهد المرينيين لاسباب تاريخية من بينها معاملة الامازيغ المسلمين كاشخاص من درجة الثانية رغم انهم قبلوا الاسلام و الكتاب و حاربوا الى جانب العرب و ساهموا في الادخال الاسلام الى باقي المناطق في المغرب
التاريخ لم يذكر اي من معارك الردة في المغرب و فوز المرتدين بالمناسبة , التاريخ باهت جدا في هذه النقطة على اي من تلك اللحظة و اهل المغرب يفضلون الحصول على خصوصيتهم في هذا الجانب معمار و لغة و خط و مساجد و لباس خاص بهم لا خارج ثقافتهم
ما زالت عملية التعريب لم تنجح لا ايديولوجيا و لا لغويا و لا عرقيا في المغرب
الدارجة ما زالت تغلب عليها مصطلحات امازيغية من منطقة الى منطقة تجد اختلاف في النطق
ريف المغرب و وسط المغرب ان لم اقل كلهم فهم يتحدثون الامازيغية و العربية يتخدونها لغة الدين لا غير
العرب منذ القدم في المغرب كان يتم طردهم في عهد الثورات الامازيغية و عهد المرينيين لاسباب تاريخية من بينها معاملة الامازيغ المسلمين كاشخاص من درجة الثانية رغم انهم قبلوا الاسلام و الكتاب و حاربوا الى جانب العرب و ساهموا في الادخال الاسلام الى باقي المناطق في المغرب
التاريخ لم يذكر اي من معارك الردة في المغرب و فوز المرتدين بالمناسبة , التاريخ باهت جدا في هذه النقطة على اي من تلك اللحظة و اهل المغرب يفضلون الحصول على خصوصيتهم في هذا الجانب معمار و لغة و خط و مساجد و لباس خاص بهم لا خارج ثقافتهم
ده كلامي اخي الكريم عن تعريب المغرب و اظنه يتفق مع ما جئت بهمن السواحل البيزنطية إلى قلب الصحراء: كيف تعرّب المغرب العربي؟
على أعتاب الفتح: أرض القبائل والمدن الساحلية
قبل أن يلوح لواء الإسلام في الأفق، كان المغرب العربي أرضًا شاسعة تتناوب عليها القوى، لكنها لم تخضع يومًا لسيطرة كاملة. في السواحل، كانت الحاميات البيزنطية تحكم المدن الكبيرة مثل قرطاج وسبتة وطنجة، تحرس الموانئ وتجمع الضرائب باسم الإمبراطور، بينما في الداخل تمتد ممالك وقبائل أمازيغية لا تعترف إلا بسلطانها وعاداتها.
الأمازيغ، بصلابتهم المعهودة، عاشوا بين الجبال والهضاب والسهول، يحافظون على لغتهم وعاداتهم، لا يغيّرها زمن ولا غزو. أما المدن الساحلية، فقد عاشت ازدواجية لسانية؛ اللاتينية في الإدارة والكنيسة، والأمازيغية في الأسواق والمنازل. الروم والبيزنطيون تركوا أثرهم في الحجر، لكن اللسان بقي أمازيغيًا في الغالب. كما يقول ابن خلدون:
العربية تخطو أولى خطواتها في أرض الأطلس
حين وصل عمرو بن العاص إلى برقة، لم يكن يدرك أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام قرون من التحولات. الفتح الإسلامي لم يكن ضربة خاطفة، بل موجات متتابعة: الأولى في العهد الراشدي، والثانية مع عقبة بن نافع الذي أسس القيروان عام 50هـ، لتكون قلب العرب النابض في المغرب، وقلعة لغتهم.
في القيروان، اجتمع العرب القادمون من مصر واليمن والحجاز، ومعهم الفقهاء والقراء، فكانت العربية تُتلى في المساجد وتُكتب في الدواوين. ومن هناك، انتشرت القوافل الحاملة للسلع، وفي ثناياها الحروف العربية التي تتسلل إلى ألسنة الناس.
ابن خلدون وصف القيروان بأنها:
لكن الطريق لم يكن سهلًا. الأمازيغ في الداخل قاوموا في البداية، وبعضهم احتفظ بلغته قرونًا بعد الفتح. ومع ذلك، كانت العربية تكسب أرضًا كل يوم، لا بالسيف وحده، بل بالقرآن والتجارة والمصاهرة.
من لهجة القبائل إلى لغة المدن: اكتمال التعريب
على مر القرون، انصهرت الأمازيغية والعربية في بوتقة واحدة، فظهرت لهجات عربية بلكنة أمازيغية، وكلمات أمازيغية اختبأت في ثنايا العربية. المدن الكبرى مثل فاس وتلمسان ومراكش تعربت سريعًا، وأصبح أهلها يتحدثون العربية في الأسواق والمجالس، وإن ظل كثير منهم يعرف الأمازيغية ويحتفظ بها في بيته.
البكري، في وصفه لفاس في القرن الخامس الهجري، قال:
الهجرات الكبرى مثل قدوم بني هلال وبني سليم في القرن الخامس الهجري عجّلت بانتشار العربية في البوادي، حتى صار الرعاة والمزارعون يتحدثون بها كما يتحدث بها القاضي في مجلسه. وبحلول القرن السابع، أصبحت العربية لغة العلم والشعر والإدارة، وصار من الصعب التفريق بين العربي والأمازيغي في الهوية واللسان.
ابن خلدون يلخص الأمر قائلاً:
وهكذا، من سواحل المتوسط حتى عمق الصحراء، أصبحت العربية لسانًا جامعًا، حمل معها الدين والفقه والشعر، وفتح للمغرب أبواب الأندلس والمشرق، وجعل منه جزءًا حيًا من الحضارة الإسلامية.
عموما المقصود بكلامي ليس المغرب الحالي فقط بل من سيوه للمحيط يا عزيزي و يختلف طبعا التأثير من كل منطقه للاخري و طبعا لكل منطقه خصوصيتها و ثقافتها انا هنا اتحدث عموما عن اللغه فقط لكن كعماره و ثقافه و علم فطبعا الموضوع اغوط و مليان تفاصيل عن كده
العفو اخي الغاليشكرا يا باحث . معلومات قيمة و جهد مشكور
العقال وغطاء الرأس السومري ( اقدم توثيق)
نقش حجري سومري مهم يوضح غطاء الراس للرجال ٢٥٠٠ قبل الميلاد وجد في مدينة أور في العراق،،
مكان العثور/ اور،، العراق
مكان العرض/ المتحف البريطاني،، لندن
الرقم المتحفي ١١٨٥٦١
بلاد الرافدين ،، العراق
نقش حجري سومري مهم يوضح غطاء الراس للرجال ٢٥٠٠ قبل الميلاد وجد في مدينة أور في العراق،،
مكان العثور/ اور،، العراق
مكان العرض/ المتحف البريطاني،، لندن
الرقم المتحفي ١١٨٥٦١
بلاد الرافدين ،، العراق
نرام سين ذكرهم ببابل
شلمنصر الثالث غرب الفرات
سرجون الثاني ذكرهم ببابل
سنحاريب ذكرهم ببابل
اشوربانيبال ذكرهم غرب الفرات
عمر العرب بين٥٢٠٠ الى ٥٥٠٠ سنه من الان تقريبا (وقت النشوء اقدم من تاريخ الذكر) ولانهم ذكروا مشيخات وامارات
لم تكن اي دولة إسمها جزائر آنذاك او وهرانأولًا: العراق قبل الإسلام – قلب الإمبراطوريات وملتقى الشعوب
كان العراق، أو بلاد الرافدين كما عرفها المؤرخون، واحدًا من أقدم وأغنى المراكز الحضارية في التاريخ الإنساني. فمنذ فجر الحضارة السومرية والأكدية، كان وادي دجلة والفرات مركزًا للزراعة، التجارة، والفكر. لكن عند اقتراب عصر الفتح الإسلامي، كان العراق قد أصبح حجر الزاوية في الإمبراطورية الساسانية.
في ظل الساسانيين، كانت المدائن – عاصمة ملك الملوك – رمزًا للقوة والفخامة، حيث قصور كسرى المذهّبة، وأروقة مكللة بالأحجار الكريمة، وبلاط يعج بالوزراء وقادة الجند ورجال الدين الزرادشتيين. كتب المؤرخ الطبري عن المدائن وثرائها قائلًا: "لم يكن في أرض المشرق أعظم سلطانًا، ولا أكثر مالًا وعددًا، من ملك فارس بالمدائن".
لم تكن بلاد الرافدين مجرد عاصمة سياسية، بل كانت ملتقى طرق العالم القديم؛ فمن الشرق كانت تأتِي قوافل الهند والصين عبر فارس، ومن الغرب كانت تصل تجارة الشام ومصر، ومن الجنوب يطل الخليج العربي كنافذة بحرية تربطها ببحر العرب والمحيط الهندي. لكن هذا الموقع الاستراتيجي جعلها أيضًا ميدانًا دائمًا للصراع؛ فقد تناوب الفرس والروم على السيطرة على أطرافها، وكانت الحرب الباردة بينهما لا تهدأ.
اجتماعيًا، كان المجتمع العراقي فسيفساء معقدة: طبقة أرستقراطية فارسية تهيمن على الحكم، فلاحون آراميون يزرعون الأرض، تجار يهود ومسيحيون في المدن، ورهبان سريان يملؤون الأديرة بالعلم، وعرب من بني لخم والمناذرة يحكمون الحيرة نيابة عن الفرس. هذا التنوع منح العراق ثراءً ثقافيًا لا مثيل له، لكنه أيضًا جعل هويته السياسية والثقافية عرضة للتأثيرات الخارجية.
ثانيًا: الألسنة في بلاد الرافدين – من لغات الملوك إلى لغات الأسواق
اللغة في العراق قبل الإسلام لم تكن موحدة، بل كانت طبقات متراكمة من التاريخ. في العصور الغابرة، كانت السومرية هي لغة الدين والإدارة، تبعتها الأكدية كلغة للملوك والأدب، حتى زاحمتها الآرامية منذ القرن السابع قبل الميلاد، فأصبحت لغة الحياة اليومية من الشمال إلى الجنوب.
المؤرخ اليعقوبي يذكر أن الآرامية "كانت مفهومة في جميع سواد العراق والشام"، بينما بقيت اللغات الأقدم محصورة في النقوش والطقوس. ومع قيام الدولة الساسانية، دخلت الفارسية الوسطى (البهلوية) لتكون لغة الدولة والدواوين، بينما ظلت الآرامية، خصوصًا في صورتها السريانية، لغة الكنائس والمدارس، ولغة التخاطب بين الناس.
لم تكن العربية غائبة، فقد كانت لهجات القبائل العربية حاضرة في الحيرة وعلى تخوم البادية، لكن تأثيرها كان محدودًا في المدن الكبرى قبل الإسلام. ومن الطريف أن المؤرخ المسعودي وصف أسواق العراق في القرن الثالث الهجري بأنها "مجمع الألسن: العربي، الفارسي، السرياني، اليوناني"، ما يوحي أن التعدد اللغوي كان تقليدًا قديمًا في هذه الأرض.
هذا التنوع اللغوي كان له أثر مزدوج: من جهة جعل العراق بوتقة ثقافية عظيمة، ومن جهة أخرى جعل فكرة التعريب لاحقًا عملية معقدة تتطلب وقتًا وجهدًا، بخلاف مناطق كانت لغتها أقرب إلى العربية أو أقل رسوخًا.
ثالثًا: العرب والعراق – من صحراء الحيرة إلى بوابة المدائن
علاقة العرب بالعراق لم تبدأ مع الفتح الإسلامي، بل ترجع إلى قرون سبقت ذلك. فمنذ القرن الثالث الميلادي، تأسست مملكة الحيرة على يد بني لخم، لتكون حليفًا استراتيجيًا للفرس الساسانيين ضد غارات القبائل البدوية، وضد حلفاء الروم من الغساسنة في الشام.
الحيرة لم تكن مجرد حصن حدودي، بل مركز حضارة عربية مبكرة. فيها بنى المناذرة القصور، وأقاموا مجالس الأدب والشعر، حتى قال الأعشى الكبير في مدح نعمان بن المنذر:
"ألم ترني وابنَ الكرامِ نعمانَ... نغادي ونمسي على سُرُر"
كما كانت الحيرة محطة على طريق التجارة بين الجزيرة والعراق، حيث تلتقي قوافل اليمن والحجاز بما يأتي من الهند وفارس. هذا الاحتكاك المستمر أوجد معرفة متبادلة بين عرب البادية وأهل العراق، ليس فقط في السلع، بل في اللغة والثقافة.
أما في الجنوب، فقد كان للعرب وجود في الأهوار والبوادي القريبة من البصرة، حيث كانوا يختلطون بالفلاحين والتجار الفرس والآراميين. وعند الفتح الإسلامي، لم يدخل العرب المسلمون أرضًا مجهولة، بل أرضًا يعرفون ملوكها، وطرقها، وأسواقها، ولهم فيها أقارب وحلفاء.
أولًا: بلاد المغرب قبل الإسلام – أرض الأمازيغ بين قرطاج وروما
قبل أن يفتح العرب المسلمون المغرب، كان هذا الإقليم يعيش على وقع قرون من الصراع بين القوى المتوسطية الكبرى، بينما ظل القلب النابض له هو الأمازيغ. ابن خلدون يصفهم في مقدمته بأنهم "أمة عظيمة جليلة، لهم قبائل وبطون، يضربون في البرية والجبال، ويعمرون القرى والحصون، ويتميزون بالشجاعة والصبر على المكاره".
منذ القرن التاسع قبل الميلاد، أسس الفينيقيون مستعمراتهم التجارية على سواحل شمال إفريقيا، وأهمها قرطاج التي تحولت إلى قوة بحرية عظيمة تنازع روما نفسها. الأمازيغ لم يكونوا مجرد متفرجين؛ بل اندمجوا في هذه الحضارة القرطاجية، وانخرط كثير منهم في جيوشها وتجارتها. المؤرخ الروماني سالوست ذكر أن ملوك الأمازيغ كانوا أحيانًا حلفاء وأحيانًا أعداء لقرطاج، لكنهم دائمًا حافظوا على استقلال نسبي في جبال الأطلس والصحراء.
بعد سقوط قرطاج سنة 146 ق.م في الحرب البونيقية الثالثة، بسط الرومان سيطرتهم على معظم السواحل. أسسوا مدنًا كبرى مثل لبدة الكبرى (في ليبيا الحالية) وتنجيس (طنجة) وقيصرية (شرشال)، وأدخلوا أنظمة إدارية وزراعية جديدة. لكن كما يذكر اليعقوبي في كتابه "البلدان"، فإن "جبال المغرب وصحراؤه كانت عصيّة على سلطان الروم، لا يدخلها جندي إلا عاد منها مريضًا أو مقتولًا".
مع القرن الخامس الميلادي، جاء الوندال الجرمانيون من إسبانيا، وسيطروا على السواحل لعدة عقود، لكنهم تركوا أثرًا ضعيفًا بسبب قلة عددهم وانقطاعهم عن الداخل. ثم جاء البيزنطيون ليستعيدوا بعض الموانئ، لكن سلطتهم كانت هشة، كما أقر البكري في "المسالك والممالك" حين قال: "وأما بلاد البربر، فسلطان الروم عليها اسم لا فعل، وإنما الأمر فيها لرؤساء القبائل".
ثانيًا: اللغة والهوية الثقافية في المغرب قبل الإسلام
الهوية اللغوية والثقافية للمغرب قبل الإسلام كانت غنية ومعقدة. اللغة الأم لمعظم السكان كانت الأمازيغية، بلهجاتها المختلفة، وهي لغة ضاربة في القدم، تُكتب أحيانًا بخط التيفيناغ في بعض المناطق الصحراوية. ابن خلدون أشار إلى ذلك بقوله: "ولهم لسان بربري لا يشاركهم فيه أحد من الأمم".
مع القرطاجيين، انتشرت البونية (الفينيقية الغربية) في المدن الساحلية، وأصبحت لغة التجارة والإدارة، خاصة في تونس وشرق الجزائر. ثم جاءت اللاتينية مع الرومان، فأصبحت لغة الدولة والكنيسة، وكتب بها مفكرون أمازيغ مثل أوغسطينوس من طاغاست. ومع ذلك، ظلت الأمازيغية قوية في الريف والجبال، حيث لم تستطع اللاتينية أن تمحوها.
البكري يصف هذا التعدد اللغوي عند حديثه عن طنجة في القرن الحادي عشر، إذ يقول: "وأهلها يتكلمون البربرية والرومية، ويفهمون من العربية ما يحتاجون إليه في التجارة". ورغم أن وصفه جاء بعد الفتح بقرون، فإنه يعكس حالة التنوع التي كانت موجودة من قبل الإسلام، مع فارق أن "الرومية" هنا تشير للاتينية المتأخرة.
هذا التعدد اللغوي جعل الهوية الأمازيغية متينة، لكنها منفتحة على التأثيرات الخارجية، فالمغرب لم يكن معزولًا، بل كان نقطة التقاء المتوسط بالصحراء، وهو ما أعدّ أرضيته لاستقبال العربية لاحقًا ودمجها في بنيته الثقافية.
ثالثًا: العرب وبلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي
رغم أن المغرب لم يعرف حكمًا عربيًا قبل الإسلام، إلا أن التواصل كان موجودًا. ابن خلدون يروي أن بعض بطون لخم وجذام وصلوا إلى برقة وطرابلس في أزمنة متفرقة قبل البعثة النبوية، استقروا قليلًا ثم اندمجوا مع السكان المحليين. هذه الهجرات لم تكن ضخمة، لكنها تركت أثرًا لغويًا محدودًا في بعض مفردات الساحل الشرقي للمغرب العربي.
التجارة كانت أهم وسيلة احتكاك. قوافل العرب كانت تحمل اللبان والتوابل من جنوب الجزيرة إلى أسواق قرطاج ولِبدة الكبرى، وتعود بالذهب والعاج والملح. البكري أشار إلى أن بعض تجار الحجاز كانوا يعرفون طرق الصحراء المؤدية إلى سجلماسة، وهي مدينة لم تكن موجودة قبل الإسلام لكنها قامت على طرق تجارة قديمة.
كما أن بعض الأخبار كانت تصل إلى المغرب عن طريق الحجاج الذين يمرون بمصر في طريقهم إلى الحجاز، وهو ما جعل بعض القبائل الأمازيغية على علم بظهور الإسلام قبل وصول الجيوش الإسلامية. لكن، وكما يصف اليعقوبي، "كانوا يرونه أمرًا بعيدًا، لا يصل إليهم إلا بعد سنين".
وعندما جاء الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، لم يأتِ العرب إلى أرض مجهولة تمامًا، لكنهم واجهوا شعبًا له هوية عريقة، اعتاد التفاعل مع القوى الكبرى، ويعرف كيف يتفاوض، وكيف يقاوم إذا لزم الأمر.
ده كلامي اخي الكريم عن تعريب المغرب و اظنه يتفق مع ما جئت به
عموما المقصود بكلامي ليس المغرب الحالي فقط بل من سيوه للمحيط يا عزيزي و يختلف طبعا التأثير من كل منطقه للاخري و طبعا لكل منطقه خصوصيتها و ثقافتها انا هنا اتحدث عموما عن اللغه فقط لكن كعماره و ثقافه و علم فطبعا الموضوع اغوط و مليان تفاصيل عن كده
تماما اخي الكريم انا وضحت اشكالية العرب الذين تم دمجهم من بني هلال
موضوع جميل بالمناسبة
موضوع جميل بالمناسبة
العراق بلد حضاري عظيم. كنت قبل فتره في مهمة عمل تستلزم مني القيادة لمسافات طويلة و كنت افتح اليوتيوب . احد هذه السلاسل التي كنت استمع لها كانت عن حضارات بلاد ما ببن النهرين. الحقيقة من كثر ما كنت منجذب للموضوع ما عاد حسيت بتعب القيادة و طول الطريق.العقال وغطاء الرأس السومري ( اقدم توثيق)مشاهدة المرفق 805827مشاهدة المرفق 805828
نقش حجري سومري مهم يوضح غطاء الراس للرجال ٢٥٠٠ قبل الميلاد وجد في مدينة أور في العراق،،
مكان العثور/ اور،، العراق
مكان العرض/ المتحف البريطاني،، لندن
الرقم المتحفي ١١٨٥٦١
بلاد الرافدين ،، العراق
اتمنى من كل قلبي ان تنهض هذه البلاد تحت حكم رشيد لتأخذ مكانها الذي تستحق . ارثها عظيم و لا يليق بها وضعها الحالي.
المقصود الي حاليا تسمى مش مقصود وقتها يعنيلم تكن اي دولة إسمها جزائر آنذاك او وهران
شكرا اخي الكريم و لو حضرتك عندك تعديل أو معلومه حابب تضيفها هكون شاكر لكتماما اخي الكريم انا وضحت اشكالية العرب الذين تم دمجهم من بني هلال
موضوع جميل بالمناسبة
أعظم و اول حضاره في رائي خصوصا في عصر ما بعد الطوفانالعراق بلد حضاري عظيم. كنت قبل فتره في مهمة عمل تستلزم مني القيادة لمسافات طويلة و كنت افتح اليوتيوب . احد هذه السلاسل التي كنت استمع لها كانت عن حضارات بلاد ما ببن النهرين. الحقيقة من كثر ما كنت منجذب للموضوع ما عاد حسيت بتعب القيادة و طول الطريق.
اتمنى من كل قلبي ان تنهض هذه البلاد تحت حكم رشيد لتأخذ مكانها الذي تستحق . ارثها عظيم و لا يليق بها وضعها الحالي.
لكن للأسف مظلومه و غير مسلط عليها الضوء و لا يوجد استكشفات اثريه هناك بكثره ده غير أن طبيعه الأرض و تحول مجري الأنهار اخفي حاجات كتير
المواضيع المشابهة
- الردود
- 60
- المشاهدات
- 7K
- الردود
- 1
- المشاهدات
- 764
- الردود
- 116
- المشاهدات
- 18K
- الردود
- 0
- المشاهدات
- 2K