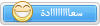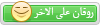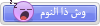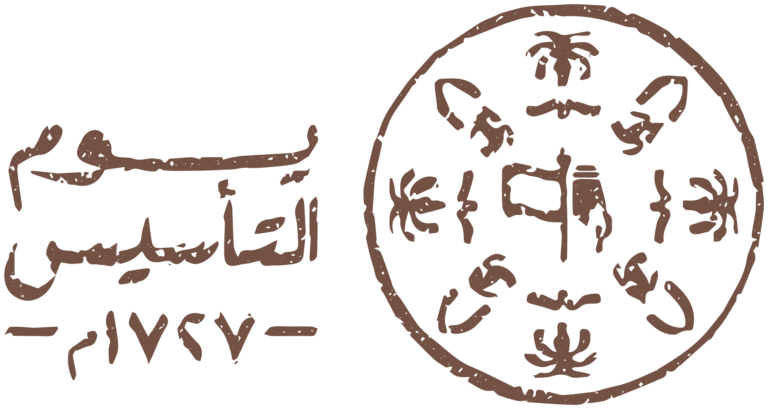هذه من الأمور التي تسبب لي لخبطة. من هم العرب؟مشاهدة المرفق 805834العمر التقريبي للعرب حسب ذكرهم من الاقدم الى الاحدث
نرام سين ذكرهم ببابل
شلمنصر الثالث غرب الفرات
سرجون الثاني ذكرهم ببابل
سنحاريب ذكرهم ببابل
اشوربانيبال ذكرهم غرب الفرات
عمر العرب بين٥٢٠٠ الى ٥٥٠٠ سنه من الان تقريبا (وقت النشوء اقدم من تاريخ الذكر) ولانهم ذكروا مشيخات وامارات
هل اسلافنا الساميين يصنفون عربا؟ هل العرب المذكورين حسب سردك تكلموا العربية الفصيحة (لغة القرآن). ماهو الفرق ببن العربية الجنوبية والشمالية الذي ذكرها المؤرخون اليونان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى عدنان فهل عدنان عربي؟ و ماذا كان قبله هل كانوا كنعانيين او ماذا.