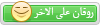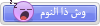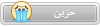بسم الله الرحمن الرحيم
في صباح السادس والعشرين من يناير عام 1952، احترقت القاهرة. لم يكن مجرد حريق في شوارع المدينة، بل زلزالًا حضاريًا اجتاح قلب مصر، لتبدأ البلاد بعدها رحلة انحدار طويلة لم تتوقف حتى يومنا هذا. سُوّيت عشرات المعالم بالأرض: دور السينما، الفنادق الراقية، المتاجر الكبرى، مكتبات كانت منارات للثقافة، ونوادي مثلت روح التعايش والانفتاح… احترق كل شيء، ولم تنجُ إلا الرماد والمرارة.
كانت مصر قبل ذلك اليوم تقف على أعتاب حداثة حقيقية. ملكية دستورية بنظام برلماني، صحافة حرة، طبقة وسطى صاعدة، نخب ثقافية متألقة، واقتصاد منفتح على العالم. رغم الاحتلال البريطاني والفساد السياسي الذي أصاب النظام في سنواته الأخيرة، إلا أن ملامح المدنية كانت واضحة، والطبقات المتعلمة والطموحة تترقب إصلاحًا تدريجيًا من داخل الدولة لا من خارجها.
لكن النار لم تلتهم الجدران وحدها، بل التهمت معها الحلم. لم تمضِ أشهر حتى سقطت الملكية، لا لتُستبدل بجمهورية العدل والحرية، بل بنظام عسكري مركزي أحكم قبضته على كل شيء: السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والعقل الجمعي. جمهورية بدأت بشعارات كبرى، وانتهت إلى دولاب مغلق من القمع والفشل والجمود.
لقد احترقت القاهرة في ساعات، لكن ما تلا الحريق كان احتراقًا بطيئًا للدولة والمجتمع والهوية. كان ذلك اليوم، بلا مبالغة، لحظة فُتحت فيها أبواب المجهول، واختنق فيها المستقبل بدخان لم يتبدد حتى اليوم.
قبل أن تشتعل النيران في قلب القاهرة، كانت مصر الملكية تقف عند مفترق طرق حساس. كان الاحتلال البريطاني لا يزال حاضرًا بثقله، والملك فاروق محاطًا باتهامات بالتدخل والفساد، لكن خلف هذا المشهد المضطرب، كانت دولة في طور التكوين، تمتلك مؤسسات دستورية، ونخبة ثقافية، واقتصادًا قوميًّا بدأ يشق طريقه بثقة. الملكية المصرية لم تكن مجرد واجهة لحكم فردي كما يصورها خطاب ما بعد يوليو، بل كانت تجربة دستورية نادرة في العالم العربي، أُقرت منذ عام 1923 بدستور حديث يحدد سلطات الملك، ويؤسس لفكرة البرلمان المنتخب، ويرسخ الصحافة الحرة والسلطة القضائية المستقلة. وفي ذلك المناخ، كانت الصحف تعارض وتحاسب، وتُغلق أحيانًا وتعود أقوى، وكان من الطبيعي أن يتواجه رئيس الوزراء والملك في صراع سياسي دستوري داخل الإطار المدني، لا خلف ظهر المؤسسات بالبندقية, ورغم أن الملك فاروق اتُّهم كثيرًا بالتدخل في السياسة، إلا أن الحياة النيابية لم تكن شكلية، بل كانت ساحة حقيقية للصراع الوطني, حزب الوفد، مثلًا، كان حزبًا شعبيًا ضخمًا يضم العمال والفلاحين والطلبة، وكان بمقدوره إسقاط الحكومات في الشارع. وخصومه، مثل السعديين والأحرار الدستوريين، كانوا من النخبة الإصلاحية التي تتنافس على برامج حقيقية.
الملك فؤاد يفتتح البرلمان بحضور سعد باشا زغلول واحمد زيوار باشا سنه 1925
القاهرة في تلك الحقبة لم تكن مدينة عربية فحسب، بل مركزًا عالميًا نابضًا بالثقافة والتنوع والانفتاح. حيث وسط المدينة كان يعج بالحياة الفكرية،فكانت القاهرة تُناظر باريس في سحرها الأوروبي الشرقي. شارع فؤاد الأول (طلعت حرب حاليًا) كان يضجّ بمقاهي النخبة والمثقفين، من مقهى "جروبي" إلى "زهرة البستان". على الأرصفة، يجلس توفيق الحكيم يتأمل ويكتب، وتمر بجواره عربات أنيقة لسيدات من الطبقة الوسطى المتعلمة، يدرن أندية خيرية ومدارس أهلية.من مقاهي المثقفين في شارع فؤاد الأول، إلى دور السينما والمكتبات التي تعرض آخر نتاج الفكر الفرنسي والبريطاني، مرورًا بندوات الجامعات التي كان يحضرها طه حسين والعقاد وسلامة موسى. كانت الحياة الثقافية نشطة إلى درجة أن القارئ المصري العادي في حي شبرا أو مصر الجديدة كان يقرأ كل أسبوع مقالات مترجمة عن نيتشه وسارتر، في مجلات تُطبع في وسط البلد وتصل إلى الصعيد. في تلك الفترة كتب طه حسين عبارته الخالدة: "إن التعليم كالماء والهواء"، وكان يناضل من موقعه كوزير للمعارف من أجل مجانية التعليم، وهي فكرة رآها آنذاك كثير من نخب القصر خيالية، لكنها تحققت داخل الإطار الملكي، لا بعده.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد بدأت مصر تحرر نفسها من التبعية الخالصة للزراعة عبر مشروع قومي وطني تبنّاه طلعت حرب، حين أسس بنك مصر عام 1920. لم يكن البنك مجرد مؤسسة مالية، بل مشروعًا حضاريًا لبناء اقتصاد مصري مستقل، أنشأ أكثر من خمس وعشرين شركة في الصناعة والنقل والطيران والتأمين. في المحلة الكبرى وحدها، وقفت مصانع الغزل والنسيج كقلعة وطنية توظف الآلاف من أبناء الطبقة العاملة، برواتب حقيقية، وتغطية صحية، ونقابات حرة. كان هناك حلم واضح ببناء اقتصاد وطني منتج، لا ريعي ولا عسكري، وإنما ينهض على التصنيع والمنافسة والأسواق,وكان الاقتصاد المصري حينها يُعد من بين الأكثر تنوعًا في المنطقة، بل إن الجنيه المصري كان يعادل الجنيه الإسترليني في القيمة.
الملك فؤاد يجلس في السرادق المقام بشركة غزل ونسيج القطن بالمحلة الكبرى حيث كان يستمع إلى خطبة طلعت حرب
حتى أزمة الإقطاع التي يُبالغ البعض في تصويرها، كانت تُعالَج من داخل الدولة. ففي أواخر الأربعينيات، بدأت حكومة النحاس باشا – بدعم من الوفد – إعداد مشروع قانون لتحديد الملكية الزراعية بحد أقصى 200 فدان، وهو الحد ذاته الذي أُقر لاحقًا بعد الثورة. لكن الفرق أن مشروع الوفد كان يتم عبر البرلمان والتوافق والمشاورات، لا بالمرسوم والفرض القسري. وقد قال مصطفى النحاس في إحدى جلسات مجلس النواب: "نريد عدالة اجتماعية تُرضي الفلاح، دون أن نخنق الأرض المنتجة". كانت النية واضحة: إصلاح متدرج، لا هدم متهور.
الطبقة الوسطى، ابنة هذا الزمن، كانت في قمة حضورها. الشاب الذي تخرّج من السعيدية أو الخديوية، دخل كلية الحقوق أو الطب أو دار العلوم، ووجد نفسه موظفًا محترمًا في الحكومة أو في شركة مصر للطيران، يقرأ في المساء نجيب محفوظ ويستمع إلى أسمهان. لم يكن ابن التاجر الصغير أو الفلاح مكسور الحلم، بل كانت أمامه سلالم حقيقية للصعود، تؤمن بها الدولة وتدعمها الصحافة. وفي كل حي، كانت هناك جمعية ثقافية أو نادٍ أدبي، وكانت الجامعات تستقبل بعثات إلى فرنسا وبريطانيا، يعود أصحابها ليعملوا في الوزارات والجامعات، لا ليُقصوا ويُهمّشوا كما حدث لاحقًا مع العقول المستقلة,فخرجت لنا أجيالًا صعدت إلى قلب الحياة السياسية والثقافية. وكان التعليم العام مجانيًا، ذا مستوى مرتفع، حتى أن شهادة التوجيهية المصرية كانت تُعادل البكالوريا الفرنسية.
احد فصول محو الاميه للفتيات
حتى في الصحافة، كانت الكلمة تملك سلاحها. مجلة روز اليوسف، التي أسستها سيدة مسيحية مهاجرة من لبنان، تحولت إلى أكثر الصحف السياسية تأثيرًا، وكانت تنشر مقالات تنتقد الملك والاحتلال، وتناقش قضايا العدالة الاجتماعية، وترسم كاريكاتيرًا يُزلزل الحكومة. كانت الكلمة تُقاوِم، وكانت الحرية تُمارَس، وكانت السلطة تُنتقَد من داخل النظام، لا خارجه. وقد كتب توفيق الحكيم في مذكراته عن تلك المرحلة قائلًا: "كانت مصر تتحدث، وكان للحوار طعم، وللمعارضة معنى".
الحياة السياسية كانت نابضة، حتى وإن شوهها الاحتلال أو أفسدها القصر أحيانًا. حزب الوفد لم يكن نخبة بيروقراطية، بل حركة شعبية حقيقية لها جذورها في الشارع. وكانت الانتخابات تُجرى، وإن شابها التزوير أحيانًا، لكنها كانت قائمة، وكان النائب يُحاسب من دائرته. وفي لحظة نادرة في تاريخ المنطقة، كان الشعب المصري يعرف من يمثله، ويعرف إلى من يكتب الخطاب، ومن يقف له تحت قبة البرلمان.
وربما يلخص السياسي مكرم عبيد باشا روح تلك المرحلة حين قال في مجلس النواب ذات مرة:
"إننا لا نطلب أكثر من أن نُحكم من داخل مصر، لا من الخارج، وأن نُحاسب حكومتنا بألسنتنا لا بالسلاح".
كانت هناك مشكلات دون شك: فساد في بعض النخب، تباين طبقي، تردد الملك في بعض المواقف. لكن السياق العام كان يوحي بأن مصر تتغير — ببطء، نعم — لكنها تتغير بثقة. لم تكن بحاجة لزلزال، بل لإصلاح تدريجي, لكن ما لم يتوقعه أحد هو أن الزلزال سيأتي في صورة لهب، وأنه سيحرق ليس فقط مباني وسط البلد، بل كل هذا التراكم المدني والمؤسساتي الذي بناه المصريون عبر عقود.
مصر كانت تُبنى، صحيح أنها لم تكتمل، وصحيح أن الفساد تسرّب للنظام في أواخره، لكن الأهم أن هناك كان مسارًا مدنيًا إصلاحيًا واضحًا، طريقًا لم يستكمل، لا لأنه فشل، بل لأن النار أجهزت عليه. فحين احترقت القاهرة، لم تحترق مباني وسط البلد فقط، بل احترق مسار بأكمله: مسار برلماني، ثقافي، اقتصادي، مدني، كان يمكن له أن يُنتج تجربة مصرية حرة ذات طابع خاص. لقد احترقت مدينة، لكن على رمادها أُعلنت بداية النهاية.