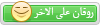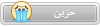بسم الله الرحمن الرحيم
منذ أربعة عشر قرنًا، لم يكن ما حدث في الشرق والغرب مجرد فتحٍ عسكري، بل كان تحوّلًا حضاريًا غيّر وجه الزمان والمكان. ففي غضون قرون قليلة، غيّرت اللغة العربية خريطة شعوبٍ كاملة، فصارت لسان المصريين، والشوام، والعراقيين، وسكان المغرب العربي من ليبيا إلى موريتانيا، بعد أن كانت هذه الشعوب تتكلم القبطية والآرامية والبربرية ولغات أخرى طُمست أو انكمشت أمام سطوة العربية.
لكن الغريب أن هذا التحوّل لم يحدث في مناطق أخرى دخلها الإسلام مبكرًا، مثل فارس الكبرى والبلاد التركية الممتدة من الأناضول إلى ما وراء النهر. فقد بقي الفرس على لغتهم، وصمدت الفارسية أمام العربية رغم أن القرآن كُتب بها، والحكم الإسلامي استمر في بلادهم لقرون. وكذلك الترك، من السلاجقة إلى الغزنويين والقراخانيين، حافظوا على لسانهم رغم اندماجهم العميق في قلب الحضارة الإسلامية.
وقد جاء هذا الموضوع بدافعٍ من الجدل المتكرّر الذي يثور كلما طُرح سؤال التعريب:
هل حدث بسرعة؟ هل فُرض بالقوة؟ هل كان نتيجة استبدال ثقافي قسري؟
يتكرر الطعن والتشكيك من أكثر من جهة: بعض القوميين العرب يرونه دليلًا على قوة ثقافتهم وهيمنتها الحضارية، وبعض القوميين غير العرب يرونه جرحًا في الهوية وطمسًا لخصوصيات الشعوب. وبين الطرفين، تضيع الحقائق التاريخية تحت سطوة الأيديولوجيا والانفعالات.
قال المؤرخ عبد العزيز الدوري:
"التعريب لم يكن صراعًا بين غالب ومغلوب، بل كان تفاعلاً طويلًا تشكلت فيه الهويات الجديدة من خلال اللغة."
وقال ابن خلدون:
"من غلب بلغة قوم، فقد غلبهم في أمرهم."
أما المستشرق إرنست رينان فأقر بدهشة:
"ما من لغة انتشرت في الأرض بسرعة مثل العربية، وما من لسان قاومها كما قاومتها الفارسية."
هذا الموضوع محاولة لقراءة التجربة كما حدثت: لا تمجيدًا للعروبة، ولا تباكيًا على الهويات، بل فهمًا لما جرى. كيف كانت تلك الشعوب قبل الإسلام؟ ما الذي جعل بعضهم يتحدثون العربية دون قسر؟ ولماذا حافظ آخرون على ألسنتهم؟ ومتى تكون اللغة جسرًا للتلاقي، ومتى تُصبح ساحةً للتنازع؟
رحلة نبدأها من الجاهلية وتمتد إلى العصر الحديث، لفهم كيف تغيّرت ألسنة أمم، وكيف احتفظت أمم أخرى بلسانها… رغم وحدة الدين والمصير.