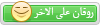الطبيعة الدينية للعرب قبل الدعوة: كيف مهد التوحيد الطريق للنور
على الرغم من الصورة الشائعة التي تصف العرب قبل الإسلام بأنهم عبدة أوثان غارقون في الجهل، فإن الحقيقة الدينية للمجتمع العربي آنذاك كانت أكثر تعقيدًا وثراءً، وتضمنت بذور توحيدية متأصلة في وجدان بعض الأفراد والقبائل، بل وكان هنالك وعي متنامٍ بأن الوثنية لا يمكن أن تكون الحق المطلق، وأن هنالك دينًا أصفى وأقرب إلى العقل والضمير.
لذلك من صحيح أن غالبية العرب عبدوا الأصنام، وتوزعت المعتقدات ما بين عبادة اللات والعزى ومناة وهُبل، وغيرها من المعبودات التي نصبت حول الكعبة أو في أرجاء الجزيرة، لكن كانت هناك أيضًا:
- أقليات من النصارى واليهود: خصوصًا في نجران ويثرب (المدينة) وخيبر وتيماء.
- بقايا حنيفية إبراهيمية: ظلّت موجودة في مكة وما حولها، تؤمن بإله واحد دون وسائط.
- أفراد موحدون بفطرة صافية: نبذوا عبادة الأصنام رغم غياب الوحي والنبوة في عصرهم.
لذلك من الواضح انه لم تكن الجزيرة العربية قبل الإسلام صحراء فكرية خالصة ولا صمّاء روحيّة مطبقة. صحيح أن مظاهر الجاهلية طبعت الحياة في أعماقها: الأصنام تحيط بالكعبة، والأحجار تُعبد، والذبائح تُنحر باسم اللات والعزى، والسحر والكهانة يملآن القلوب بالخوف، لكن وسط هذا الليل الكثيف، كانت هناك شعاعات نور تلوّح من بعيد. كانت هناك نفوس عربية لم ترضَ بالخرافة، وقلوب فطرت على التوحيد، وعيون شخَصت نحو السماء، تنتظر نبيًا يأتي بكلمة لا إله إلا الله.
في قلب مكة نفسها، وعلى بعد خطوات من هُبَل والأنصاب المحيطة بالحرم، كان يعيش رجل يُدعى زيد بن عمرو بن نفيل، من بني عديّ القرشيين، وكان ذا عقل نقيّ وفطرة سليمة. لم يكن نبيًا، ولم يكن تابعًا لأي كتاب، لكنه نبذ عبادة الأصنام، ورفضها علنًا، وكان يقول للمكيين: "يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري." وكان إذا رأى قومه يذبحون للآلهة، ابتعد عنهم وقال: "إني لا آكل مما ذُكر عليه اسم صنم." وسافر زيد باحثًا عن الدين، زار الشام والموصل، وقرأ وسأل الرهبان، لكن قلبه لم يطمئن إلا لما كان يسميه "دين إبراهيم". لم يُدرك بعثة النبي ﷺ، لكنه عاش مؤمنًا بأن الله واحد، لا يشبهه صنم ولا يحتاج إلى وساطة.لكنه كان قد قُتل قبل بعثة النبي ﷺ، وكان يقول:"اللهم إن كنت حرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ابني (سعيد بن زيد)."وهو ما كان؛ إذ أصبح ابنه من العشرة المبشرين بالجنة.
وكان هناك رجل آخر، يقرأ الكتب، ويبحث بين الأسفار، ويقيم الليالي يتأمل فيها أخبار الأنبياء... إنه ورقة بن نوفل، ابن عم خديجة بنت خويلد، من بقايا النصارى الموحدين الذين احتفظوا بشذرات من نور المسيحية الأولى قبل أن يشوبها التحريف. آمن بأن نبيًا سيأتي، ولما جاءه محمد ﷺ يرتجف مما رأى في غار حراء، قال له ورقة: "هذا الناموس الذي نزل على موسى." لم يكن الحديث غريبًا على ورقة، فقد كانت كتب أهل الكتاب تذكر بشائر النبي العربي، وكان ينتظر، لكنه مات قبل أن يُكمل الطريق.
وفي الطائف، كان أمية بن أبي الصلت، شاعرًا ومثقفًا، يتغنّى في شعره بوحدانية الله، ويكتب عن الموت والحساب واليوم الآخر، حتى قال عنه النبي ﷺ: "كاد أمية أن يسلم." لكنه توقف عند آخر خطوة، حسدًا أو كبرياء. أما قس بن ساعدة الإيادي، فهو الخطيب المفوّه الذي اعتلى منبر سوق عكاظ وقال كلمته المشهورة: "أيها الناس، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت..." كلمات تنضح بحكمة التوحيد والإيمان بالبعث، وكأنه كان يبشّر، من غير وحي، بقدوم الحق.
كل هؤلاء لم يكونوا أنبياء، ولا من أتباع دين سماوي كامل، لكنهم كانوا الحنفاء، أولئك الذين فطروا على رفض الشرك ومالت قلوبهم بالفطرة إلى الإله الواحد. لا كتاب لديهم، ولا رسول، لكنهم سئموا السجود للصنم، وأدركوا أن للحياة غاية أسمى من الذبح على أعتاب الحجارة.
وإذا كان الله قد اختار العرب لحمل رسالته الخاتمة، فلأنهم، رغم انغماسهم في الجاهلية، كانوا أنقى الأمم من الإرث الفلسفي الملوث، وأقربهم إلى الفطرة النقية، فلم يكن بينهم تعقيد فكر الرومان، ولا غموض ديانات الهنود، بل كانت أرضهم الروحية شاغرة تنتظر النور، وفي قلوبهم – رغم الغلظة – حس ديني داخلي لم يمت.
إنّ ظهور النبي محمد ﷺ في مكة لم يكن فجائيًا كما يظن البعض، بل كان تتمة طبيعية لحركة بحث داخلية صامتة، استمرت عقودًا، وربما قرونًا، حتى جاءت الكلمة التي انتظروها: اقرأ.