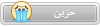السادات عميل امريكى؟لأن السادات كان هو الآخر عميل للأمريكان !!!!! أفتح موضوع عن عملية تطوير الهجوم يوم 14 أكتوبر لترى ما يسرك حول عمالة زعيم الحرب والسلام بتاعك وكيف كان يتخابر مع الأمريكان من بداية الحرب !!!!
الشهيد البطل انور السادات اشرف من انك تتكلم عنه بهذه الوقاحة ياقليل الرباية.