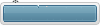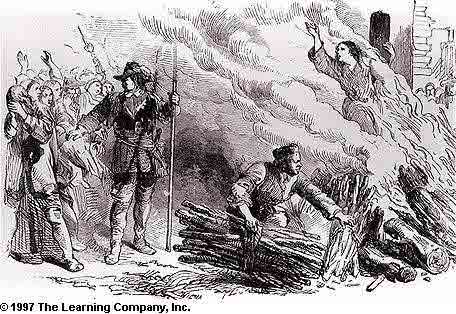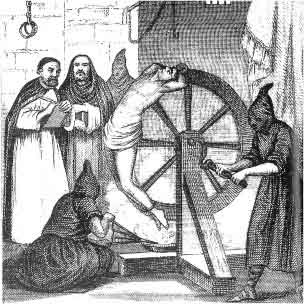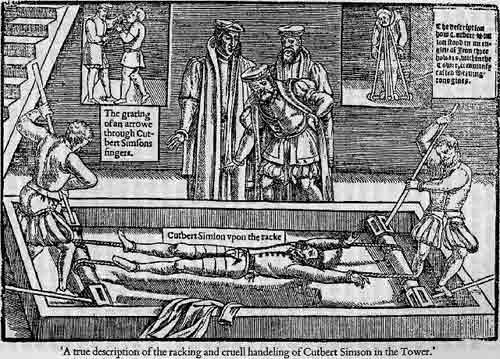الأندلس الإسلامية منذ سنة 711 إلى سنة 1492 كانت خاضعة للحكم السياسي الإسلامي ومرتبطة بتاريخ المغرب الوسيط. العدوتين كما وردت في الحوليات التاريخية شكلت طابعا خاصا في البحر الأبيض المتوسط، من حيث التأثير والتأثر في مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. فالمجال كان واسعا يشمل المغرب الأقصى بحدوده المحادية لغرب إفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية التي تشمل إسبانيا والبرتغال الحاليتين، وبحكم تقارب المجال، العلاقة بين الأندلس وساكنة المغرب الأقصى منذ قرون لها طابع إنتمائي، بحكم العلاقة المجتمعية المشتركة بين المجتمع الإسلامي الأندلسي والمجتمع المغربي، خاصة وأن الأندلس كانت خلال الفترة المرابطية والموحدية إقليم تابع للعاصمة مراكش، ويخضع لسيطرة مركزية تحدد ضرائبها وعمالها وقضائها، ويتم تسيير الأندلس مباشرة من ولي العهد أو من المقربين للملك أو الخليفة، فأصبحت الأندلس جزء من شرعية المركز، فنمى تقليد العبور عبرمضيق جبل طارق كلما تغير الحكم في المغرب الوسيط. ومن تقاليد العديد من المغاربة التركيز على أنسابهم الأندلسية والإفتخار بهذا الإنتماء. فالتاريخ المغربي بإمتداده المجالي وتحركاته البشرية عبر مختلف المناطق، خلق حالة ذهنية وفكرية تجسد الإنتماء للمحيط الأندلسي، الذي كان يعتبر جزء من الدولة المغربية المرابطية والموحدية، حتى أن إستعمال إسم العدوتين أو الدولة البربرية الأندلسية يحمل في طياته ذالك العمق التاريخي المترابط والمتشابك، لكونه تاريخ ثلاثة دول: مرابطية وموحدية ومرينية. الدول المغربية الوسيطية ألحقت الأندلس بمجالها الحيوي، فكان حظور الأندلس حظور إستراتيجي تتبناه الدولة ومختلف مكونات المجتمع. فالمسألة الإنتمائية حاضرة تاريخيا، ولكن يمكن أن نوضح بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات التي جمعت بين بعض المكونات المتميزة بخصوصياتها وربطها بالإنتماء والتاريخ المغربي لا شك أن الجوانب السياسية والدينية تشكل عناصر هامة لتفسير ظاهرة العصر الوسيط المغربي، ولكن سنحاول وضع إطار عام للتحركات البشرية وما يرتبط بها من ظواهر إجتماعية في الفترة المرابطية والموحدية
إن الوحدة السياسية التي دامت مدة طويلة، أي منذ أن أطلق أهل الرباط سنة 1090 سياسة ضم الأندلس إلى ملكهم، خلقت عمقا سياسيا وجغرافيا جاذبا نحو الوحدة إلي حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر. إن جعل الأندلس جزء من مجال الدولة المغربية خلال فترة المرابطين والموحدين، كرس وبامتياز فكرة العبور والمرابطة، وأصبحت الأندلس مركز قوة للسلطة المركزية، لذا إعتنت السلطة الوسيطية بمراكش بمختلف المناطق الأندلسية وأخضعتها لنفس التصورات السياسية والجبائية . لقد كان من نتائج الوحدة السياسية تسهيل عملية التحرك البشري بين ضفتي الأندلس والمغرب، فشكل تنقل الأشخاص والمجموعات البشرية نواة تلاقي إجتماعي، ساهم في جعل المغرب الأقصى والأندلس إمتدادا جغرافيا وبشريا لمركزين قادرين على صهر المكونات القادمة إليهما. التحركات البشرية في الغرب الإسلامي وخاصة بين الأندلس والمغرب الأقصى متعددة ومتصلة خلال حقبة العصر الوسيط، مما جعلها تأثر في مختلف المكونات الإجتماعية بشكل أو بآخر في إطار تحالفات محورية مدعومة بصراعات قبلية وكونفدرالية، تتسع وفقا لمعايير المصلحة والظروف الإقتصادية والسياسية. التحركات البشرية بين المغرب الأقصى والأندلس كانت متعددة الأطراف ومتنوعة المشارب، تحمل في تنقلاتها مخزونا يجمع بين العام المتعارف عليه في الغرب الإسلامي والخصوصية الذاتية المحلية الموروثة. غالبية التحركات البشرية في المصادر التاريخية تدخل في إطار ما قد نسميه بالإكتساح المجالي، لكون هذا النوع من التحركات يساهم في تغيير التحالفات والدول والسلطة المركزية، ومن الناحية العددية يخلق إختلالات في التوازن المجالي بين المدن والأرياف. فإنتقال الحكم من ملوك الطوائف لحساب المرابطين إلى وصول الموحدين للسلطة، كلها مراحل عرفت فيها التحركات البشرية بين الضفتين ديناميكية كبيرة، ذات صبغة قوية وشهرة سجلتها المصادر التاريخية الوسيطية، لذا فإن هذا العنصر البشري المساهم في التلاقي الإجتماعي، كانت له آلية سياسية وهي تغير السلطة وبروز سلطة جديدة، رافعة لشعار الجهاد، فالتحرك على هذا المستوى تحرك جماعي محارب، يجمع قبائل بأكملها وما تحمله من خصوصيات تنظيمية وإجتماعية
فبالإضافة إلى هذه التحركات البشرية فإن هناك تحركات مصاحبة ومواكبة للوضعية السياسية، ففي سنة 1125 حاول ألفونس الأول الوصول إلى غرناطة في إطار حملة إستردادية، إلا أنه فشل في مشروعه مما دفعه إلى التراجع، فحمل المرابطون للجالية المسيحية بالأندلس الإسلامية المسؤولية عما حدث لوقوفهم في صف العدو، فتبع ذلك قرار رسمي يقضي بترحيل الجاليات المسيحية خلال سنة 1126 وأعيد العمل به في سنة 1136، وإستقرت الجاليات المهجرة في العديد من المدن المغربية كمكناس وفاس ومراكش وسلا وغيرها
الحالة السياسية والعسكرية التي كانت تتميز بالمد والجزر، كفقدان قرطبة سنة 1263 وإشبيلية سنة 1248 ميلادية، دفع بالعديد من الأسر الغنية الأرستوقراطية إلى الهجرة نحو المغرب الأقصى، كما كان لفئة العلماء دور في إنتقال وإحتكاك المعارف بين الأندلس والمغرب، إذ تمت الهجرة بين العدوتين لتحصيل العلم، مع ما رافق ذلك من البحث على المناصب والعمل داخل البلاط المرابطي والموحدي، وكان في قمة هجرة العلماء رحيل الفيلسوف والعالم الجليل إبن رشد من مسقط رأسه قرطبة إلى مراكش
لعل من أهم ما يمكن الوقوف عنده هو حلقة الوصل التي شكلها الحكم المرابطي والموحدي في تاريخ الغرب الإسلامي برمته والأندلس خاصة، فلا أحد ينكر أننا أمام سلطتين تمكنت كل واحدة من خلق توازن جيوسياسي في الغرب الإسلامي، بتمكن كل من المرابطين والموحدين من مراقبة مجال واسع يمتد من السنغال إلى الأندلس، معتمدين في ذلك على نهج سياسي وحدوي، لذا أصبح المغرب الأقصى مركز القرار السياسي والإقتصادي لوجود السلطة المركزية بالعاصمة مراكش، التي كانت تسهر على جعل المجتمع الأندلسي مجتمعا إسلاميا ومعربا مندمجا في ما يسمى بالغرب الإسلامي. في نفس الوقت كانت مراقبة تجارة الذهب مع الجنوب وإدخالها في التعاملات التجارية والتبادلية بالمواد المغربية والأندلسية، عنصرا مساهما في حركة تنقل العنصر البشري والإقتصادي والثقافي، دعمته وتطورت من خلاله حركة ملاحية مزدهرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، فعرفت الموانئ المغربية والأندلسية حركة تنقل الأشخاص والبضائع بصورة مهمة، أثرت على التجارة الداخلية في المدن والأرياف والتجارة العابرة للصحراء. الجهد السياسي المرابطي والموحدي مكن من توفير فرص أمن الطرقات والموانئ، وخلق ديناميكية إقتصادية مرافقة للتحركات البشرية التي إنتقلت معها عادات البناء والملبس والثقافة بمختلف تنوعاتها وخصوصياتها المحلية، حيث أصبح العمران عمرانا أندلسيا مغربيا، نلاحظه في قصور ومساجد المرابطين والموحدين كمنارة الكتبية بمراكش والمسجد الكبير وإقامة الخلفاء بإشبيلية وغيرها في غرناطة ومرسية وفاس وتلمسان والأمثلة كثيرة. لقد حاول اهل الرباط وبالخصوص أهل التوحيد بناءا على عقيدتهم صهر المغرب والأندلس في وحدة جغرافية وثقافية، يشكل فيها العنصر الإجتماعي مقوما وحدويا رغم خصوصية كل جهة. الوحدة السياسية والجغرافية والثقافية التي رسختها الدول المغربية الوسيطية، نجحت إلى حد كبير في جوانب منها وأخفقت في الأخرى، تركت أثرها في الذاكرة المغربية، فأصبح إنتماء المغربي إلى البحر الأبيض المتوسط حقيقة وذاكرة تاريخية، هذا المحيط الجيوسياسي لعب فيه أهل المغرب الأقصى دورا رياديا وتاريخيا، ولعل ربط الأندلس بالمغرب هو الذي يدفع المغاربة إلى الإفتخار بالإنتماء إلى ماضي الغرب الإسلامي وبالخصوص الأندلسي، وهو إنتماء لمرحلة جيوسياسية كانت فيها مكونات المجتمع المغربي قادرة على صهر التنوع الثقافي والجهوي بإحتضان خصوصية كل جهة وكل عنصر بشري، وذلك عن طريق نهج سياسة المجال الجغرافي الممتد والموحد، لكون المغرب الأقصى والأندلس كانا يعيشان نفس الحقيقة السياسية خلال الحقبة الوسيطية، فكان نهج سياسة الوحدة من الثوابت، وكل ما يدخل في إطار الخصوصيات المحلية والثقافية والقبلية روافد تتغذى بها سياسية الوحدة القائمة
إن الوحدة السياسية التي دامت مدة طويلة، أي منذ أن أطلق أهل الرباط سنة 1090 سياسة ضم الأندلس إلى ملكهم، خلقت عمقا سياسيا وجغرافيا جاذبا نحو الوحدة إلي حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر. إن جعل الأندلس جزء من مجال الدولة المغربية خلال فترة المرابطين والموحدين، كرس وبامتياز فكرة العبور والمرابطة، وأصبحت الأندلس مركز قوة للسلطة المركزية، لذا إعتنت السلطة الوسيطية بمراكش بمختلف المناطق الأندلسية وأخضعتها لنفس التصورات السياسية والجبائية . لقد كان من نتائج الوحدة السياسية تسهيل عملية التحرك البشري بين ضفتي الأندلس والمغرب، فشكل تنقل الأشخاص والمجموعات البشرية نواة تلاقي إجتماعي، ساهم في جعل المغرب الأقصى والأندلس إمتدادا جغرافيا وبشريا لمركزين قادرين على صهر المكونات القادمة إليهما. التحركات البشرية في الغرب الإسلامي وخاصة بين الأندلس والمغرب الأقصى متعددة ومتصلة خلال حقبة العصر الوسيط، مما جعلها تأثر في مختلف المكونات الإجتماعية بشكل أو بآخر في إطار تحالفات محورية مدعومة بصراعات قبلية وكونفدرالية، تتسع وفقا لمعايير المصلحة والظروف الإقتصادية والسياسية. التحركات البشرية بين المغرب الأقصى والأندلس كانت متعددة الأطراف ومتنوعة المشارب، تحمل في تنقلاتها مخزونا يجمع بين العام المتعارف عليه في الغرب الإسلامي والخصوصية الذاتية المحلية الموروثة. غالبية التحركات البشرية في المصادر التاريخية تدخل في إطار ما قد نسميه بالإكتساح المجالي، لكون هذا النوع من التحركات يساهم في تغيير التحالفات والدول والسلطة المركزية، ومن الناحية العددية يخلق إختلالات في التوازن المجالي بين المدن والأرياف. فإنتقال الحكم من ملوك الطوائف لحساب المرابطين إلى وصول الموحدين للسلطة، كلها مراحل عرفت فيها التحركات البشرية بين الضفتين ديناميكية كبيرة، ذات صبغة قوية وشهرة سجلتها المصادر التاريخية الوسيطية، لذا فإن هذا العنصر البشري المساهم في التلاقي الإجتماعي، كانت له آلية سياسية وهي تغير السلطة وبروز سلطة جديدة، رافعة لشعار الجهاد، فالتحرك على هذا المستوى تحرك جماعي محارب، يجمع قبائل بأكملها وما تحمله من خصوصيات تنظيمية وإجتماعية
فبالإضافة إلى هذه التحركات البشرية فإن هناك تحركات مصاحبة ومواكبة للوضعية السياسية، ففي سنة 1125 حاول ألفونس الأول الوصول إلى غرناطة في إطار حملة إستردادية، إلا أنه فشل في مشروعه مما دفعه إلى التراجع، فحمل المرابطون للجالية المسيحية بالأندلس الإسلامية المسؤولية عما حدث لوقوفهم في صف العدو، فتبع ذلك قرار رسمي يقضي بترحيل الجاليات المسيحية خلال سنة 1126 وأعيد العمل به في سنة 1136، وإستقرت الجاليات المهجرة في العديد من المدن المغربية كمكناس وفاس ومراكش وسلا وغيرها
الحالة السياسية والعسكرية التي كانت تتميز بالمد والجزر، كفقدان قرطبة سنة 1263 وإشبيلية سنة 1248 ميلادية، دفع بالعديد من الأسر الغنية الأرستوقراطية إلى الهجرة نحو المغرب الأقصى، كما كان لفئة العلماء دور في إنتقال وإحتكاك المعارف بين الأندلس والمغرب، إذ تمت الهجرة بين العدوتين لتحصيل العلم، مع ما رافق ذلك من البحث على المناصب والعمل داخل البلاط المرابطي والموحدي، وكان في قمة هجرة العلماء رحيل الفيلسوف والعالم الجليل إبن رشد من مسقط رأسه قرطبة إلى مراكش
لعل من أهم ما يمكن الوقوف عنده هو حلقة الوصل التي شكلها الحكم المرابطي والموحدي في تاريخ الغرب الإسلامي برمته والأندلس خاصة، فلا أحد ينكر أننا أمام سلطتين تمكنت كل واحدة من خلق توازن جيوسياسي في الغرب الإسلامي، بتمكن كل من المرابطين والموحدين من مراقبة مجال واسع يمتد من السنغال إلى الأندلس، معتمدين في ذلك على نهج سياسي وحدوي، لذا أصبح المغرب الأقصى مركز القرار السياسي والإقتصادي لوجود السلطة المركزية بالعاصمة مراكش، التي كانت تسهر على جعل المجتمع الأندلسي مجتمعا إسلاميا ومعربا مندمجا في ما يسمى بالغرب الإسلامي. في نفس الوقت كانت مراقبة تجارة الذهب مع الجنوب وإدخالها في التعاملات التجارية والتبادلية بالمواد المغربية والأندلسية، عنصرا مساهما في حركة تنقل العنصر البشري والإقتصادي والثقافي، دعمته وتطورت من خلاله حركة ملاحية مزدهرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، فعرفت الموانئ المغربية والأندلسية حركة تنقل الأشخاص والبضائع بصورة مهمة، أثرت على التجارة الداخلية في المدن والأرياف والتجارة العابرة للصحراء. الجهد السياسي المرابطي والموحدي مكن من توفير فرص أمن الطرقات والموانئ، وخلق ديناميكية إقتصادية مرافقة للتحركات البشرية التي إنتقلت معها عادات البناء والملبس والثقافة بمختلف تنوعاتها وخصوصياتها المحلية، حيث أصبح العمران عمرانا أندلسيا مغربيا، نلاحظه في قصور ومساجد المرابطين والموحدين كمنارة الكتبية بمراكش والمسجد الكبير وإقامة الخلفاء بإشبيلية وغيرها في غرناطة ومرسية وفاس وتلمسان والأمثلة كثيرة. لقد حاول اهل الرباط وبالخصوص أهل التوحيد بناءا على عقيدتهم صهر المغرب والأندلس في وحدة جغرافية وثقافية، يشكل فيها العنصر الإجتماعي مقوما وحدويا رغم خصوصية كل جهة. الوحدة السياسية والجغرافية والثقافية التي رسختها الدول المغربية الوسيطية، نجحت إلى حد كبير في جوانب منها وأخفقت في الأخرى، تركت أثرها في الذاكرة المغربية، فأصبح إنتماء المغربي إلى البحر الأبيض المتوسط حقيقة وذاكرة تاريخية، هذا المحيط الجيوسياسي لعب فيه أهل المغرب الأقصى دورا رياديا وتاريخيا، ولعل ربط الأندلس بالمغرب هو الذي يدفع المغاربة إلى الإفتخار بالإنتماء إلى ماضي الغرب الإسلامي وبالخصوص الأندلسي، وهو إنتماء لمرحلة جيوسياسية كانت فيها مكونات المجتمع المغربي قادرة على صهر التنوع الثقافي والجهوي بإحتضان خصوصية كل جهة وكل عنصر بشري، وذلك عن طريق نهج سياسة المجال الجغرافي الممتد والموحد، لكون المغرب الأقصى والأندلس كانا يعيشان نفس الحقيقة السياسية خلال الحقبة الوسيطية، فكان نهج سياسة الوحدة من الثوابت، وكل ما يدخل في إطار الخصوصيات المحلية والثقافية والقبلية روافد تتغذى بها سياسية الوحدة القائمة