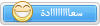بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير واشنطن
الجمعة 19 سبتمبر 2008
7:00:00 GMT
وفق دراسة أعدتها جيسيكا دروم من معهد مونتيري للدراسات الدولية
حقيقة الصراع السعودي الإيراني من منظور أميركي
واشنطن: مثل تصاعد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط- لا سيما عقب الإحتلال الأميركي للعراق عام 2003- مصدر قلق كبير للعديد من الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، التي رأت في تنامي النفوذ الإيراني بالعراق من ناحية، وسعيها الدؤوب لإمتلاك تكنولوجيا نووية – وفق التصريحات الغربية لا سيما الأميركية - من ناحية أخرى تهديدًا حقيقيًّا لمصالحها القومية. ولهذا حاولت الرياض أن تحقق توازنًا مع طهران من خلال القيام بدور إقليمي فاعل يهدف إلى محاصرة النفوذ الإيراني واحتوائه، وهذا ما تركز عليه جيسيكا دروم، الباحثة المساعدة بـمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ومركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، في دراسة بعنوان " التنافس من أجل النفوذ. رد الفعل السعودي على البرنامج النووي الإيراني المتقدم ".
من التحالف إلى العداء
ترصد جيسيكا في بداية دراستها تطور العلاقات السعودية الإيرانية، فتقول : إنَّها مرت بفترات من المد والجذر خلال العقود الماضية، متأرجحة بين التعاون وربما التحالف في فترات تاريخية معينة، وبين العداء الشديد الذي وصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية.
ارتبطت البلدان بعلاقات تعاون قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث كان الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، والحكومة السعودية حليفين للولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس نيكسون، استنادًا إلى مبدأ نيكسون، الذي أكد أنَّ السلام لن يتحقق بصورة مُثلى في المنطقة إلا من خلال إقامة شراكة بين حلفاء الولايات المتحدة. ولهذا كانت واشنطن المصدر الرئيس للمساعدات والواردات العسكرية للبلدين، ففي الفترة من 1970-1975، ارتفعت مبيعات السلاح الأميركية للبلدين من مليار دولار إلى عشرة مليارات دولار أميركي.
مع قيام الثورة الإسلامية في إيران، قطعت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لإيران، بينما استمرت في تقديم تلك المساعدات للمملكة. ودخلت العلاقات بين الرياض وطهران مرحلة من التوتر؛ لدعوة الثورة الإيرانية المواطنين السعوديين إلى الإطاحة بالأسرة الحاكمة، لذلك خشيت السعودية، وفق ما تراه الكاتبة من انتفاضة للأقلية الشيعية المتمركزة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط. وقد زادت التوترات بين البلدين للدعم الذي قدمته طهران للثورات في الدول المجاورة، في ظل سياسة تصدير الثورة التي اتبعتها إيران الإسلامية في السنوات الأوائل من حكم الملالي، بالإضافة إلى التوترات والاضطرابات التي قام بها شيعة المملكة. وعلى الرغم من الجهود الإيرانية المضنية لم تتم الإطاحة بالأسرة الحاكمة، ولا حتى إعادة تنظيم الهيكل السياسي للمملكة، وتمتعت الأقلية الشيعية بقدر ضئيل من الثروة والموارد، على الرغم من محاولات السعودية لإرضائها.
ووقوف المملكة بجانب العراق في حربه مع إيران وسع الهوة بين البلدين، ووصل التوتر إلى ذروته عندما قطعت المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 1988. وتضيف الكاتبة إلى مصادر التوتر السابقة في العلاقات بين البلدين قضية الحجاج الإيرانيين التي أسهمت في تعكير صفو العلاقة بين البلدين لفترات طويلة. فدائمًا ما كان الحجاج الإيرانيون يثيرون الشغب أثناء مواسم الحج، ما حدا بالسلطة السعودية في بعض الأوقات إلى رفض استقبالهم، وحدوث عدد من المواجهات بين قوات الأمن السعودية والحجاج الإيرانيين، وقد أسفرت إحدى تلك المواجهات عن جرح عشرين حاجًّا إيرانيًّا في عام 1981. واستمر هذا التجاذب لعدة سنوات، حيث كان يسمح بعدد محدود فقط من الحجاج الإيرانيين، علاوة على مراقبة أنشطتهم عن قرب.
شهدت العلاقات بين البلدين تحسنًا ملحوظًا خلال فترة رئاسة كل من أكبر هاشمي رافسنجاني (1989-1997)، ومحمد خاتمي (1997-2005)، إلا أنَّ فوز أحمدي نجاد، ذي الخلفية المحافظة، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2005، أدى إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ومنذ ذلك الحين اتسمت العلاقات بين البلدين- كعادتها- بالشد والجذب، فعلى الرغم من التوتر الذي ساد بين البلدين نتيجة استمرار طهران في أنشطتها النووية، فقد كانت هناك عدة بوادر إيجابية من قبيل اللقاء المشترك الذي جمع العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بالرئيس الإيراني أحمدي نجاد في 4 مارس 2007. لكنها زالت لإحجام الطرفين في اللقاء عن الاتفاق على أي خطط ملموسة للتصدي لتصاعد الأزمات السياسية والطائفية في الشرق الأوسط ، بل تضمنت تحذيرًا من قِبل العاهل السعودي للرئيس الإيراني أحمدي نجاد من التدخل في الشؤون العربية، أو الاستخفاف بالتهديدات العسكرية الأميركية. وحاليًا تشهد العلاقات بين البلدين توترًا ملحوظًا، تدعمه الشكوك والاختلافات بين الطرفين حول قضايا المنطقة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان.
صحوة إقليمية سعودية
تنتقل الكاتبة إلى دراسة الدور الإقليمي السعودي في المنطقة الهادف – بصورة أساسية – إلى محاصرة النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة أو على الأقل موازنته، معتمدة في ذلك على عاملين أساسيين. العامل الأول يتمثل في ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز المئة دولار خلال الأشهر الماضية. فالسعودية تعتبر أكثر ثراءً من إيران، وهو أمر من المتوقع ألا يتغير، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وبينما تتزايد ثروة المملكة العربية السعودية من النفط، ومن ثَمَّ نفوذها الإقليمي، يعاني الاقتصاد الإيراني بشدة من أزمات حادة. والعامل الثاني للدور السعودي في المنطقة يتمثل في المكانة الرمزية للمملكة والشرعية التي تمتلكها بوصفها حارسًا لأقدس بقعتين لدى المسلمين (مكة والمدينة).
ولمحاصرة واحتواء النفوذ الإيراني المتنامي بالمنطقة اضطرت المملكة للقيام بدور أكثر فاعلية في حل صراعات المنطقة والذي انعكس في تصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز التي جاء فيها "لا نريد من أحد أن يدير قضايانا ويستغلها في تعزيز مكانته في الصراعات الدولية". ويتجلي هذا الدور في عدة أمور، أبرزها التحرك الذي تقوم به الرياض ليس فقط لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ومن أجل تشكيل حكومة فلسطينية تحظى بالشرعية الدولية. فشهدت مكة، في فبراير 2007، محاولة سعودية لإنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس، وتكوين حكومة وحدة وطنية فلسطينية، والتي مثلت تحولاً في تعامل المملكة مع القضية، والذي اقتصر في السابق على مجرد تقديم الدعم المالي، محجمة عن القيام بأي دور قيادي في حل الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومثلت استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية مؤشرًا آخر على تصاعد دورها الإقليمي، فهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة مثل هذا الحدث، كما أنَّ السعوديين أعادوا تقديم مبادرتهم للسلام، التي قدمت في عام 2002، للقمة العربية ببيروت، ونجحوا في الحصول على موافقة كل الدول العربية عليها.
يحمل هذا النجاح عدة دلالات مهمة، يأتي في مقدمتها ظهور القدرة السعودية على تقديم مقترح يحظى بموافقة كافة الدول العربية بخصوص صراع معقد مثل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، خاصة وأن من ضمن بنود المبادرة السعودية السلام مع إسرائيل، والعودة إلى حدود عام 1967، وتطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل وجيرانها، بالإضافة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والتخلي عن هضبة الجولان، وهما نقطتان تتحفظ عليهما إسرائيل.
ويُعد حرص الرياض على القيام بدور أكثر فاعلية في العراق مؤشرًا آخر على تنامي النفوذ السعودي. فقد فرضت الأزمة العراقية على المملكة اختيار أحد خيارين إما أن تؤدي دورًا فاعلاً في تشكيل "العراق الجديد"، أو أن تقف مكتوفة الأيدي تاركة إيران تقوم بالدور المركزي في هذا "العراق الجديد".
معضلات الدور الإقليمي السعودي
هناك معضلة كبيرة تواجه الدور السعودي في العراق تتمثل في الاختيار بين الاكتفاء بمشاهدة تعرض سُنَّة العراق لهجوم الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران، أو دعم الميليشيات السُّنِّية التي تغذي العنف في العراق، والذي يُعد سببًا لإغضاب أقليتها الشيعية.
ولا تقتصر المعضلة التي يواجهها الدور السعودي على العراق بل يمتد إلى الملف النووي الإيراني، حيث تجد السعودية نفسها في موقف صعب، فرغم دعمها العلني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فإن مخاوفها من البرنامج النووي الإيراني لا تقل عن المخاوف الغربية. حيث تخشى السعودية من امتلاك إيران لتكنولوجيا نووية معقدة، قد تستخدم ضدها في يوم من الأيام، ولذلك دعا وزير الخارجية السعودي إيران إلى الموافقة على المبادرة المتعلقة بإخلاء منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل.
وعلى الرغم من هذا الإحساس بالتهديد، فإن المملكة ترفض أي تعامل عسكري – أميركي أو إسرائيلي – حيال البرنامج النووي الإيراني، انطلاقا من رؤيتها أنه تهديدٌ لا يقل عن سابقه، وأن نتائجه ستكون كارثية ليس عليها فحسب بل على الشرق الأوسط بأسره.
جغرافيًا ستتأثر تجارة النفط السعودي بشدة في حالة وقوع مثل هذا العدوان، ما سيلقي بظلال سلبية على الاقتصاد السعودي، أضف إلى ذلك أن السعودية قد تجد نفسها مضطرة، في حالة اندلاع الصراع، أن تكون في صف أحد الجانبين، وهو ما سيعود بالخسارة على المملكة أيًّا كان الجانب الذي ستدعمه، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن احتمال تسرب مواد نووية أو مشعة من أحد المفاعلات الإيرانية، فمفاعل "بوشهر" يعتبر الأقرب إلى عدد من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي منه إلى طهران.
وتواجه السعودية معضلة أخرى في علاقتها مع الولايات المتحدة فمن جهة يدفعها تراجع شعبية الولايات المتحدة في المنطقة بسبب غزو العراق، من بين أسباب أخرى، إلى إعادة النظر والتدقيق في العلاقة "الخاصة" التي تجمعها مع الولايات المتحدة للحيلولة دون استخدام إيران لهذه العلاقات لوضع السعودية في موقف دفاعي، كما حدث في السابق. وهو أمر عبرت عنه تصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أدان فيها الاحتلال الأميركي غير الشرعي للعراق، وعلى الرغم من أن ذلك أغضب الولايات المتحدة، لكنه أظهر للشعوب والدول العربية أن المملكة ليست مرتهنة بالولايات المتحدة، وأن بوسعها التعاطي بإيجابية مع التماسك العربي. وفي الوقت الذي تريد فيه السعودية إعادة النظر في علاقاتها مع واشنطن لخدمة دورها الإقليمي لا تريد من جهة أخرى أن تفقد صداقتها مع واشنطن، حليفها الاستراتيجي.
مقومات الدور السعودي الإقليمي
وبعد تناول مراحل تطور العلاقات السعودية – الإيرانية، والسعي السعودي للقيام بدور إقليمي في المنطقة كموازن للنفوذ الإيراني المتزايد، والحديث عن معضلات الدور السعودي هذا، تتناول الكاتبة الجهود السعودية لتدعيم مكانتها، ومحاولة الحفاظ على نوع من التوازن مع منافستها الرئيسة (إيران)، وكان هذا جليًّا في صفقات التسلح العديدة التي عقدتها السعودية، والمبالغ الطائلة التي أنفقتها على هذه الصفقات.
هوس سعودي بالتسلح
تشير جيسيكا إلى تصاعد مشتريات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بشكل غير مسبوق، ففي الفترة من 1994-2004 زادت نفقات دول الشرق الأوسط على السلاح بنسبة 40%، مقابل 23% عالميًّا، وكانت السعودية وإسرائيل على رأس الدول التي أسهمت في هذه الزيادة، وتبلغ نفقات المملكة العربية السعودية على السلاح حوالي 25.4 مليار دولار مقابل 6.2 مليار تنفقها إيران، حسب تقديرات قناة الجزيرة التي اعتمدت عليها الكاتبة.
تظهر هذه الأرقام بوضوح البون الشاسع بين الإنفاق السعودي على السلاح ونظيره الإيراني، وهو أمر يتضح بصورة أكبر عند معرفة ما تمثله هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي، فالإنفاق الإيراني يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل الإنفاق السعودي 10% (بتقديرات العام 2005)، وتكتسب هذه الأرقام أهميتها عند مقارنتها بنسب الإنفاق الأميركية والصينية على الدفاع من الناتج المحلى الإجمالي، حيث يبلغ الإنفاق الأميركي 4.06%، بينما تبلغ نسبة نظيره الصيني 4.3%.
وبلغت نفقات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر السعودية واحدة منها على التسلح حوالى 162 مليار دولار بزيادة قدرها 55 مليون دولار خلال الأربع سنوات الماضية، واحتلت السعودية مقدمة هذه الدولة بنفقات بلغت 27 مليار دولار عام 2007، لأول مرة في تاريخ المملكة. فقد قامت المملكة بعقد عدد كبير من صفقات السلاح ، ففي عام 2005 اتجهت إلى تحديث الطائرات المقاتلة التي تمتلكها من نوع "بانافايا أي دي إس" القادرة على تحديد الأسلحة الموجهة بالليزر ذاتيًّا، مما يتيح للمقاتلات السعودية قدرة أكبر على تحديد الأهداف ومن ثَمَّ دقة أعلى في نظم التوجيه. وفي عام 2006، وافقت فرنسا على صفقة طائرات هليكوبتر إلى المملكة، إلى جانب ناقلة طائرات، وصواريخ مضادة للطائرات، في اتفاق بلغت قيمته 3.125 مليار دولار.
ويعتبر معرض أيدكس للسلاح، الذي يقام في دبي سنويًّا المكان المفضل للملكة العربية السعودية لعقد صفقات السلاح، ففي هذا العام أنفقت المملكة حوالى 50 مليار دولار، لشراء طائرات مقاتلة وصواريخ كروز وطائرات هليكوبتر مهاجمة، وأكثر من 300 دبابة جديدة، ووقعت السعودية عقدًا مع Data Link Solutions لشراء شبكات توزيع المعلومات المتعددة الوظائف اللازمة لطائرات إف-15 المقاتلة، وتستخدم هذه النظم لتعظيم الملاحة والاتصال بين الطائرات. كما تعاقدت المملكة العربية السعودية مع شركة بوينج الأميركية لتحديث نظام الإنذار والمراقبة المحمولة جوًّا، في اتفاق بلغت قيمته 49.2 مليار دولار.
وتتمثل أبرز الصفقات السعودية في ما أعلنت عنه واشنطن في يوليو 2007 عن عزمها الطلب من الكونغرس المصادقة على صفقة ضخمة لبيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار. وتشمل تلك الصفقة أسلحة متطورة لم تحصل عليها السعودية من قبل، وفي مقدمتها قنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية وطائرات وبوارج حربية. وفي مقابل ذلك وافقت الولايات المتحدة على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، بنسبة 25% لضمان استمرارية تفوقها النوعي العسكري على جيرانها.
وينظر كثيرون إلى تلك الصفقة على أنها محاولة لاحتواء النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط، لكنها تعرضت لانتقادات كثيرة أبرزها ما جاء على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني الذي شبه الصفقة بأنها بمثابة صب الزيت على النار، وأنها ستزيد من عدم استقرار المنطقة ومن عرضتها للتوتر، ووصفها وزير الخارجية السوري في 31 يوليو 2007، بالخطرة. هذا في حين يعتبرها آخرون محاولة لشراء تعاون السعودية في العراق، خاصة وأنها متهمة بتمويل وتسليح الميليشيات السنية في العراق، ومحاولة أيضًا لمحاصرة النفوذ الإيراني وتهدئة القلق الذي ولده البرنامج النووي الإيراني في المنطقة.
وتقدمت في أكتوبر 2007 بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء أسلحة بما يعادل 631 مليون دولار، تضمنت 121 مدرعة خفيفة؛ ثلاث مركبات LAV recovery vehicles، 50 مركبة ذات عجلات، متعددة الأغراضHigh Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV)؛ 124 مدفع رشاش 7.62 مم من نوع M240؛ 525 منظار للرؤية الليلية من نوع AN/PVS-7D.
وفي سبتمبر 2007، شهدت المشتريات السعودية من الأسلحة طفرة، حيث قامت المملكة بشراء 72 طائرة تايفون يوروفايتر Euro fighter Typhoon من المملكة المتحدة، وتكمن أهمية هذه الصفقة في عدة نواحٍ: أولها قيمتها التي تبلغ حوالى 60 مليار دولار على مدار الخمس وعشرين سنة القادمة. وثانيها درجة التكنولوجيا التي حصلت عليها السعودية، حيث يتضمن الاتفاق إقامة "خط تجميع لطائرات التايفون إلى السعودية إلى جانب نقل تكنولوجيا لم يتم نقلها إلى دولة شرق أوسطية من قبل، فضلاً عن أن هذا الاتفاق يوفر للسعودية البنية التحتية اللازمة لتدعيم التطور الاقتصادي والارتقاء بصناعة الملاحة الجوية.
طموحات نووية
لم تكن صفقات التسلح السعودية الملمح الوحيد لرغبة السعودية في تدعيم تواجدها في المنطقة، في مقابل النفوذ الإيراني، بل أعلنت السعودية عن نيتها امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وذلك في إطار مجلس التعاون الخليجي.
ففي القمة السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2006، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن عزمها البدء في إنشاء برنامج مشترك لتطوير الطاقة النووية، ودعوتها إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي منطقة خالية من السلاح النووي، مع الاعتراف بحق أي دولة في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
ولتهدئة المخاوف الدولية اتخذ قادة دول مجلس التعاون الخليجي عدة خطوات، من بينها عقد لقاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من سلمية البرنامج النووي الذي ينون إنشاءه، وتوافقه مع القانون الدولي. وتشير الدرجة التي ذهبت إليها دول مجلس التعاون في تهدئة المخاوف الدولية إلى أنها تعلمت من الدرس الإيراني ولا تريد أن ينظر العالم إلى برنامجها النووي كما ينظر إلى برنامج إيران النووي.
وعلى الرغم من هذه التهدئة الخليجية، فإن استمرارية هذا الطابع السلمي يبقى أمرًا مشكوكًا فيه مع وصول النفقات الدفاعية السعودية إلى 27 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، والذي يؤشر إلى أن احتمالية اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى امتلاك تكنولوجيا نووية عسكرية أضحي أمرًا ممكنًا من وجهة نظر كثير من المحللين وصناع القرار، خاصة وأن العوائق المالية، التي تحول دون امتلاك كثير من الدول (مصر على سبيل المثال) للسلاح النووي، لا تعاني منها الدول الخليجية في ظل إيرادات النفط الضخمة التي تعود عليها والتي وصلت في عام 2006 إلى حوالى 500 مليار دولار.
ولزيادة طمأنة المجتمع الدولي من الرغبة النووية الخليجية أعلن السعوديون ونظراؤهم الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن خطة لإنشاء كونسورتيوم لكل مستخدمي اليورانيوم المخصب في منطقة الشرق الأوسط، يوزع طبقًا لاحتياجات كل دولة، وإعطاء كل مفاعل الكمية الضرورية له، مع التأكد من عدم استخدام اليورانيوم المخصب لصنع الأسلحة النووية، حسب كلمات الملك عبد الله.
ومع أن الاتفاق موجه لدول المنطقة كلها، فإنه قصد إيران، خاصة مع إشارة العاهل السعودي إلى أن الهدف من الخطة هو "وقف سباق التسلح النووي في منطقة الخليج".
استنتاجات وخلاصة الدراسة
وفي ختام دراستها تقدم "جيسيكا" عدة ملاحظات، وهي:
أولاً: إن استمرار السعي الإيراني للحصول على القنبلة النووية، سوف يدفع عددًا كبيرًا من دول المنطقة إلى أن تحذو حذوها، فتحرك إيران تجاه امتلاك التكنولوجيا النووية، سواء أكانت سلمية أم لا، سوف يقنع الدول الأخرى في المنطقة بأن الطاقة النووية ليست فقط جذابة، بل مهمة للحفاظ على تقدمها في منطقة غير مستقرة.
ثانيا: إن امتلاك طهران لبرنامج نووي لن ينظر إليه على أنه انتصار تكنولوجي للمسلمين، ولكن كتفوق للشيعة، الذي يدفع السنة للبحث عن تحقيق إنجاز مماثل في مقابله. فإيران لم تفلح في تصوير كون نجاحها في امتلاك السلاح النووي إفادة لكل المسلمين، وليس فقط للدولة الشيعية، ولذا يفضل مواطنو دول عربية سنية مثل مصر والسعودية تطوير طاقة أو أسلحة نووية في بلادهم كرد على التقدم الذي أحرزته إيران في هذا المجال.
وإذا سارت الأمور على هذا المنوال، فإن احتمال زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط في المنطقة، وهو أمر لا ترغب فيه كل من السعودية وإيران، نظرًا لأنه سيقلل من إيرادات السعودية من النفط، ومن ثم قدرتها على التأثير في المنطقة، حيث تعتمد الدبلوماسية السعودية بشكل كبير على إمكاناتها المالية أو ما يمكن وصفه بـ"دبلوماسية حافظة الجيب".
ثالثًا: في حال استمرار السعودية لزيادة قدراتها التسليحية بالمعدل الحالي ذاته، واستمرار إحساس الدول الخليجية الأخرى بتهديد البرنامج النووي الإيراني، فإن الدول الخليجية لن تجد بديلاً أمامها سوى امتلاك شكل ما من أشكال التكنولوجيا النووية، مع شراء مزيد من الأسلحة التقليدية، وأي مزج بينهما مما يؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط.
رابعًا: إن العديد من الدول الشرق أوسطية التي تسعى الآن لامتلاك الطاقة النووية السلمية، ليس لديها حاجة كبيرة إلى مصادر طاقة إضافية، بقدر حاجتها للشعور بالأمان، حيث ترى أن امتلاكها للطاقة النووية سوف يشكل رادعًا مناسبًا لإيران النووية، وإذا تم ضم إدراك التهديد هذا مع قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل مثل هذا الرادع، فإن الأمر قد يتعامل معه المجتمع الدولي بجدية في السنوات المقبلة
المصدر :
http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/9/367007.htm
تقرير واشنطن
الجمعة 19 سبتمبر 2008
7:00:00 GMT
وفق دراسة أعدتها جيسيكا دروم من معهد مونتيري للدراسات الدولية
حقيقة الصراع السعودي الإيراني من منظور أميركي
واشنطن: مثل تصاعد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط- لا سيما عقب الإحتلال الأميركي للعراق عام 2003- مصدر قلق كبير للعديد من الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، التي رأت في تنامي النفوذ الإيراني بالعراق من ناحية، وسعيها الدؤوب لإمتلاك تكنولوجيا نووية – وفق التصريحات الغربية لا سيما الأميركية - من ناحية أخرى تهديدًا حقيقيًّا لمصالحها القومية. ولهذا حاولت الرياض أن تحقق توازنًا مع طهران من خلال القيام بدور إقليمي فاعل يهدف إلى محاصرة النفوذ الإيراني واحتوائه، وهذا ما تركز عليه جيسيكا دروم، الباحثة المساعدة بـمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ومركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، في دراسة بعنوان " التنافس من أجل النفوذ. رد الفعل السعودي على البرنامج النووي الإيراني المتقدم ".
من التحالف إلى العداء
ترصد جيسيكا في بداية دراستها تطور العلاقات السعودية الإيرانية، فتقول : إنَّها مرت بفترات من المد والجذر خلال العقود الماضية، متأرجحة بين التعاون وربما التحالف في فترات تاريخية معينة، وبين العداء الشديد الذي وصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية.
ارتبطت البلدان بعلاقات تعاون قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث كان الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، والحكومة السعودية حليفين للولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس نيكسون، استنادًا إلى مبدأ نيكسون، الذي أكد أنَّ السلام لن يتحقق بصورة مُثلى في المنطقة إلا من خلال إقامة شراكة بين حلفاء الولايات المتحدة. ولهذا كانت واشنطن المصدر الرئيس للمساعدات والواردات العسكرية للبلدين، ففي الفترة من 1970-1975، ارتفعت مبيعات السلاح الأميركية للبلدين من مليار دولار إلى عشرة مليارات دولار أميركي.
مع قيام الثورة الإسلامية في إيران، قطعت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لإيران، بينما استمرت في تقديم تلك المساعدات للمملكة. ودخلت العلاقات بين الرياض وطهران مرحلة من التوتر؛ لدعوة الثورة الإيرانية المواطنين السعوديين إلى الإطاحة بالأسرة الحاكمة، لذلك خشيت السعودية، وفق ما تراه الكاتبة من انتفاضة للأقلية الشيعية المتمركزة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط. وقد زادت التوترات بين البلدين للدعم الذي قدمته طهران للثورات في الدول المجاورة، في ظل سياسة تصدير الثورة التي اتبعتها إيران الإسلامية في السنوات الأوائل من حكم الملالي، بالإضافة إلى التوترات والاضطرابات التي قام بها شيعة المملكة. وعلى الرغم من الجهود الإيرانية المضنية لم تتم الإطاحة بالأسرة الحاكمة، ولا حتى إعادة تنظيم الهيكل السياسي للمملكة، وتمتعت الأقلية الشيعية بقدر ضئيل من الثروة والموارد، على الرغم من محاولات السعودية لإرضائها.
ووقوف المملكة بجانب العراق في حربه مع إيران وسع الهوة بين البلدين، ووصل التوتر إلى ذروته عندما قطعت المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 1988. وتضيف الكاتبة إلى مصادر التوتر السابقة في العلاقات بين البلدين قضية الحجاج الإيرانيين التي أسهمت في تعكير صفو العلاقة بين البلدين لفترات طويلة. فدائمًا ما كان الحجاج الإيرانيون يثيرون الشغب أثناء مواسم الحج، ما حدا بالسلطة السعودية في بعض الأوقات إلى رفض استقبالهم، وحدوث عدد من المواجهات بين قوات الأمن السعودية والحجاج الإيرانيين، وقد أسفرت إحدى تلك المواجهات عن جرح عشرين حاجًّا إيرانيًّا في عام 1981. واستمر هذا التجاذب لعدة سنوات، حيث كان يسمح بعدد محدود فقط من الحجاج الإيرانيين، علاوة على مراقبة أنشطتهم عن قرب.
شهدت العلاقات بين البلدين تحسنًا ملحوظًا خلال فترة رئاسة كل من أكبر هاشمي رافسنجاني (1989-1997)، ومحمد خاتمي (1997-2005)، إلا أنَّ فوز أحمدي نجاد، ذي الخلفية المحافظة، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2005، أدى إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ومنذ ذلك الحين اتسمت العلاقات بين البلدين- كعادتها- بالشد والجذب، فعلى الرغم من التوتر الذي ساد بين البلدين نتيجة استمرار طهران في أنشطتها النووية، فقد كانت هناك عدة بوادر إيجابية من قبيل اللقاء المشترك الذي جمع العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بالرئيس الإيراني أحمدي نجاد في 4 مارس 2007. لكنها زالت لإحجام الطرفين في اللقاء عن الاتفاق على أي خطط ملموسة للتصدي لتصاعد الأزمات السياسية والطائفية في الشرق الأوسط ، بل تضمنت تحذيرًا من قِبل العاهل السعودي للرئيس الإيراني أحمدي نجاد من التدخل في الشؤون العربية، أو الاستخفاف بالتهديدات العسكرية الأميركية. وحاليًا تشهد العلاقات بين البلدين توترًا ملحوظًا، تدعمه الشكوك والاختلافات بين الطرفين حول قضايا المنطقة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان.
صحوة إقليمية سعودية
تنتقل الكاتبة إلى دراسة الدور الإقليمي السعودي في المنطقة الهادف – بصورة أساسية – إلى محاصرة النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة أو على الأقل موازنته، معتمدة في ذلك على عاملين أساسيين. العامل الأول يتمثل في ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز المئة دولار خلال الأشهر الماضية. فالسعودية تعتبر أكثر ثراءً من إيران، وهو أمر من المتوقع ألا يتغير، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وبينما تتزايد ثروة المملكة العربية السعودية من النفط، ومن ثَمَّ نفوذها الإقليمي، يعاني الاقتصاد الإيراني بشدة من أزمات حادة. والعامل الثاني للدور السعودي في المنطقة يتمثل في المكانة الرمزية للمملكة والشرعية التي تمتلكها بوصفها حارسًا لأقدس بقعتين لدى المسلمين (مكة والمدينة).
ولمحاصرة واحتواء النفوذ الإيراني المتنامي بالمنطقة اضطرت المملكة للقيام بدور أكثر فاعلية في حل صراعات المنطقة والذي انعكس في تصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز التي جاء فيها "لا نريد من أحد أن يدير قضايانا ويستغلها في تعزيز مكانته في الصراعات الدولية". ويتجلي هذا الدور في عدة أمور، أبرزها التحرك الذي تقوم به الرياض ليس فقط لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ومن أجل تشكيل حكومة فلسطينية تحظى بالشرعية الدولية. فشهدت مكة، في فبراير 2007، محاولة سعودية لإنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس، وتكوين حكومة وحدة وطنية فلسطينية، والتي مثلت تحولاً في تعامل المملكة مع القضية، والذي اقتصر في السابق على مجرد تقديم الدعم المالي، محجمة عن القيام بأي دور قيادي في حل الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومثلت استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية مؤشرًا آخر على تصاعد دورها الإقليمي، فهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة مثل هذا الحدث، كما أنَّ السعوديين أعادوا تقديم مبادرتهم للسلام، التي قدمت في عام 2002، للقمة العربية ببيروت، ونجحوا في الحصول على موافقة كل الدول العربية عليها.
يحمل هذا النجاح عدة دلالات مهمة، يأتي في مقدمتها ظهور القدرة السعودية على تقديم مقترح يحظى بموافقة كافة الدول العربية بخصوص صراع معقد مثل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، خاصة وأن من ضمن بنود المبادرة السعودية السلام مع إسرائيل، والعودة إلى حدود عام 1967، وتطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل وجيرانها، بالإضافة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والتخلي عن هضبة الجولان، وهما نقطتان تتحفظ عليهما إسرائيل.
ويُعد حرص الرياض على القيام بدور أكثر فاعلية في العراق مؤشرًا آخر على تنامي النفوذ السعودي. فقد فرضت الأزمة العراقية على المملكة اختيار أحد خيارين إما أن تؤدي دورًا فاعلاً في تشكيل "العراق الجديد"، أو أن تقف مكتوفة الأيدي تاركة إيران تقوم بالدور المركزي في هذا "العراق الجديد".
معضلات الدور الإقليمي السعودي
هناك معضلة كبيرة تواجه الدور السعودي في العراق تتمثل في الاختيار بين الاكتفاء بمشاهدة تعرض سُنَّة العراق لهجوم الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران، أو دعم الميليشيات السُّنِّية التي تغذي العنف في العراق، والذي يُعد سببًا لإغضاب أقليتها الشيعية.
ولا تقتصر المعضلة التي يواجهها الدور السعودي على العراق بل يمتد إلى الملف النووي الإيراني، حيث تجد السعودية نفسها في موقف صعب، فرغم دعمها العلني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فإن مخاوفها من البرنامج النووي الإيراني لا تقل عن المخاوف الغربية. حيث تخشى السعودية من امتلاك إيران لتكنولوجيا نووية معقدة، قد تستخدم ضدها في يوم من الأيام، ولذلك دعا وزير الخارجية السعودي إيران إلى الموافقة على المبادرة المتعلقة بإخلاء منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل.
وعلى الرغم من هذا الإحساس بالتهديد، فإن المملكة ترفض أي تعامل عسكري – أميركي أو إسرائيلي – حيال البرنامج النووي الإيراني، انطلاقا من رؤيتها أنه تهديدٌ لا يقل عن سابقه، وأن نتائجه ستكون كارثية ليس عليها فحسب بل على الشرق الأوسط بأسره.
جغرافيًا ستتأثر تجارة النفط السعودي بشدة في حالة وقوع مثل هذا العدوان، ما سيلقي بظلال سلبية على الاقتصاد السعودي، أضف إلى ذلك أن السعودية قد تجد نفسها مضطرة، في حالة اندلاع الصراع، أن تكون في صف أحد الجانبين، وهو ما سيعود بالخسارة على المملكة أيًّا كان الجانب الذي ستدعمه، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن احتمال تسرب مواد نووية أو مشعة من أحد المفاعلات الإيرانية، فمفاعل "بوشهر" يعتبر الأقرب إلى عدد من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي منه إلى طهران.
وتواجه السعودية معضلة أخرى في علاقتها مع الولايات المتحدة فمن جهة يدفعها تراجع شعبية الولايات المتحدة في المنطقة بسبب غزو العراق، من بين أسباب أخرى، إلى إعادة النظر والتدقيق في العلاقة "الخاصة" التي تجمعها مع الولايات المتحدة للحيلولة دون استخدام إيران لهذه العلاقات لوضع السعودية في موقف دفاعي، كما حدث في السابق. وهو أمر عبرت عنه تصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أدان فيها الاحتلال الأميركي غير الشرعي للعراق، وعلى الرغم من أن ذلك أغضب الولايات المتحدة، لكنه أظهر للشعوب والدول العربية أن المملكة ليست مرتهنة بالولايات المتحدة، وأن بوسعها التعاطي بإيجابية مع التماسك العربي. وفي الوقت الذي تريد فيه السعودية إعادة النظر في علاقاتها مع واشنطن لخدمة دورها الإقليمي لا تريد من جهة أخرى أن تفقد صداقتها مع واشنطن، حليفها الاستراتيجي.
مقومات الدور السعودي الإقليمي
وبعد تناول مراحل تطور العلاقات السعودية – الإيرانية، والسعي السعودي للقيام بدور إقليمي في المنطقة كموازن للنفوذ الإيراني المتزايد، والحديث عن معضلات الدور السعودي هذا، تتناول الكاتبة الجهود السعودية لتدعيم مكانتها، ومحاولة الحفاظ على نوع من التوازن مع منافستها الرئيسة (إيران)، وكان هذا جليًّا في صفقات التسلح العديدة التي عقدتها السعودية، والمبالغ الطائلة التي أنفقتها على هذه الصفقات.
هوس سعودي بالتسلح
تشير جيسيكا إلى تصاعد مشتريات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بشكل غير مسبوق، ففي الفترة من 1994-2004 زادت نفقات دول الشرق الأوسط على السلاح بنسبة 40%، مقابل 23% عالميًّا، وكانت السعودية وإسرائيل على رأس الدول التي أسهمت في هذه الزيادة، وتبلغ نفقات المملكة العربية السعودية على السلاح حوالي 25.4 مليار دولار مقابل 6.2 مليار تنفقها إيران، حسب تقديرات قناة الجزيرة التي اعتمدت عليها الكاتبة.
تظهر هذه الأرقام بوضوح البون الشاسع بين الإنفاق السعودي على السلاح ونظيره الإيراني، وهو أمر يتضح بصورة أكبر عند معرفة ما تمثله هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي، فالإنفاق الإيراني يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل الإنفاق السعودي 10% (بتقديرات العام 2005)، وتكتسب هذه الأرقام أهميتها عند مقارنتها بنسب الإنفاق الأميركية والصينية على الدفاع من الناتج المحلى الإجمالي، حيث يبلغ الإنفاق الأميركي 4.06%، بينما تبلغ نسبة نظيره الصيني 4.3%.
وبلغت نفقات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر السعودية واحدة منها على التسلح حوالى 162 مليار دولار بزيادة قدرها 55 مليون دولار خلال الأربع سنوات الماضية، واحتلت السعودية مقدمة هذه الدولة بنفقات بلغت 27 مليار دولار عام 2007، لأول مرة في تاريخ المملكة. فقد قامت المملكة بعقد عدد كبير من صفقات السلاح ، ففي عام 2005 اتجهت إلى تحديث الطائرات المقاتلة التي تمتلكها من نوع "بانافايا أي دي إس" القادرة على تحديد الأسلحة الموجهة بالليزر ذاتيًّا، مما يتيح للمقاتلات السعودية قدرة أكبر على تحديد الأهداف ومن ثَمَّ دقة أعلى في نظم التوجيه. وفي عام 2006، وافقت فرنسا على صفقة طائرات هليكوبتر إلى المملكة، إلى جانب ناقلة طائرات، وصواريخ مضادة للطائرات، في اتفاق بلغت قيمته 3.125 مليار دولار.
ويعتبر معرض أيدكس للسلاح، الذي يقام في دبي سنويًّا المكان المفضل للملكة العربية السعودية لعقد صفقات السلاح، ففي هذا العام أنفقت المملكة حوالى 50 مليار دولار، لشراء طائرات مقاتلة وصواريخ كروز وطائرات هليكوبتر مهاجمة، وأكثر من 300 دبابة جديدة، ووقعت السعودية عقدًا مع Data Link Solutions لشراء شبكات توزيع المعلومات المتعددة الوظائف اللازمة لطائرات إف-15 المقاتلة، وتستخدم هذه النظم لتعظيم الملاحة والاتصال بين الطائرات. كما تعاقدت المملكة العربية السعودية مع شركة بوينج الأميركية لتحديث نظام الإنذار والمراقبة المحمولة جوًّا، في اتفاق بلغت قيمته 49.2 مليار دولار.
وتتمثل أبرز الصفقات السعودية في ما أعلنت عنه واشنطن في يوليو 2007 عن عزمها الطلب من الكونغرس المصادقة على صفقة ضخمة لبيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار. وتشمل تلك الصفقة أسلحة متطورة لم تحصل عليها السعودية من قبل، وفي مقدمتها قنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية وطائرات وبوارج حربية. وفي مقابل ذلك وافقت الولايات المتحدة على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، بنسبة 25% لضمان استمرارية تفوقها النوعي العسكري على جيرانها.
وينظر كثيرون إلى تلك الصفقة على أنها محاولة لاحتواء النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط، لكنها تعرضت لانتقادات كثيرة أبرزها ما جاء على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني الذي شبه الصفقة بأنها بمثابة صب الزيت على النار، وأنها ستزيد من عدم استقرار المنطقة ومن عرضتها للتوتر، ووصفها وزير الخارجية السوري في 31 يوليو 2007، بالخطرة. هذا في حين يعتبرها آخرون محاولة لشراء تعاون السعودية في العراق، خاصة وأنها متهمة بتمويل وتسليح الميليشيات السنية في العراق، ومحاولة أيضًا لمحاصرة النفوذ الإيراني وتهدئة القلق الذي ولده البرنامج النووي الإيراني في المنطقة.
وتقدمت في أكتوبر 2007 بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء أسلحة بما يعادل 631 مليون دولار، تضمنت 121 مدرعة خفيفة؛ ثلاث مركبات LAV recovery vehicles، 50 مركبة ذات عجلات، متعددة الأغراضHigh Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV)؛ 124 مدفع رشاش 7.62 مم من نوع M240؛ 525 منظار للرؤية الليلية من نوع AN/PVS-7D.
وفي سبتمبر 2007، شهدت المشتريات السعودية من الأسلحة طفرة، حيث قامت المملكة بشراء 72 طائرة تايفون يوروفايتر Euro fighter Typhoon من المملكة المتحدة، وتكمن أهمية هذه الصفقة في عدة نواحٍ: أولها قيمتها التي تبلغ حوالى 60 مليار دولار على مدار الخمس وعشرين سنة القادمة. وثانيها درجة التكنولوجيا التي حصلت عليها السعودية، حيث يتضمن الاتفاق إقامة "خط تجميع لطائرات التايفون إلى السعودية إلى جانب نقل تكنولوجيا لم يتم نقلها إلى دولة شرق أوسطية من قبل، فضلاً عن أن هذا الاتفاق يوفر للسعودية البنية التحتية اللازمة لتدعيم التطور الاقتصادي والارتقاء بصناعة الملاحة الجوية.
طموحات نووية
لم تكن صفقات التسلح السعودية الملمح الوحيد لرغبة السعودية في تدعيم تواجدها في المنطقة، في مقابل النفوذ الإيراني، بل أعلنت السعودية عن نيتها امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وذلك في إطار مجلس التعاون الخليجي.
ففي القمة السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2006، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن عزمها البدء في إنشاء برنامج مشترك لتطوير الطاقة النووية، ودعوتها إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي منطقة خالية من السلاح النووي، مع الاعتراف بحق أي دولة في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
ولتهدئة المخاوف الدولية اتخذ قادة دول مجلس التعاون الخليجي عدة خطوات، من بينها عقد لقاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من سلمية البرنامج النووي الذي ينون إنشاءه، وتوافقه مع القانون الدولي. وتشير الدرجة التي ذهبت إليها دول مجلس التعاون في تهدئة المخاوف الدولية إلى أنها تعلمت من الدرس الإيراني ولا تريد أن ينظر العالم إلى برنامجها النووي كما ينظر إلى برنامج إيران النووي.
وعلى الرغم من هذه التهدئة الخليجية، فإن استمرارية هذا الطابع السلمي يبقى أمرًا مشكوكًا فيه مع وصول النفقات الدفاعية السعودية إلى 27 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، والذي يؤشر إلى أن احتمالية اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى امتلاك تكنولوجيا نووية عسكرية أضحي أمرًا ممكنًا من وجهة نظر كثير من المحللين وصناع القرار، خاصة وأن العوائق المالية، التي تحول دون امتلاك كثير من الدول (مصر على سبيل المثال) للسلاح النووي، لا تعاني منها الدول الخليجية في ظل إيرادات النفط الضخمة التي تعود عليها والتي وصلت في عام 2006 إلى حوالى 500 مليار دولار.
ولزيادة طمأنة المجتمع الدولي من الرغبة النووية الخليجية أعلن السعوديون ونظراؤهم الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن خطة لإنشاء كونسورتيوم لكل مستخدمي اليورانيوم المخصب في منطقة الشرق الأوسط، يوزع طبقًا لاحتياجات كل دولة، وإعطاء كل مفاعل الكمية الضرورية له، مع التأكد من عدم استخدام اليورانيوم المخصب لصنع الأسلحة النووية، حسب كلمات الملك عبد الله.
ومع أن الاتفاق موجه لدول المنطقة كلها، فإنه قصد إيران، خاصة مع إشارة العاهل السعودي إلى أن الهدف من الخطة هو "وقف سباق التسلح النووي في منطقة الخليج".
استنتاجات وخلاصة الدراسة
وفي ختام دراستها تقدم "جيسيكا" عدة ملاحظات، وهي:
أولاً: إن استمرار السعي الإيراني للحصول على القنبلة النووية، سوف يدفع عددًا كبيرًا من دول المنطقة إلى أن تحذو حذوها، فتحرك إيران تجاه امتلاك التكنولوجيا النووية، سواء أكانت سلمية أم لا، سوف يقنع الدول الأخرى في المنطقة بأن الطاقة النووية ليست فقط جذابة، بل مهمة للحفاظ على تقدمها في منطقة غير مستقرة.
ثانيا: إن امتلاك طهران لبرنامج نووي لن ينظر إليه على أنه انتصار تكنولوجي للمسلمين، ولكن كتفوق للشيعة، الذي يدفع السنة للبحث عن تحقيق إنجاز مماثل في مقابله. فإيران لم تفلح في تصوير كون نجاحها في امتلاك السلاح النووي إفادة لكل المسلمين، وليس فقط للدولة الشيعية، ولذا يفضل مواطنو دول عربية سنية مثل مصر والسعودية تطوير طاقة أو أسلحة نووية في بلادهم كرد على التقدم الذي أحرزته إيران في هذا المجال.
وإذا سارت الأمور على هذا المنوال، فإن احتمال زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط في المنطقة، وهو أمر لا ترغب فيه كل من السعودية وإيران، نظرًا لأنه سيقلل من إيرادات السعودية من النفط، ومن ثم قدرتها على التأثير في المنطقة، حيث تعتمد الدبلوماسية السعودية بشكل كبير على إمكاناتها المالية أو ما يمكن وصفه بـ"دبلوماسية حافظة الجيب".
ثالثًا: في حال استمرار السعودية لزيادة قدراتها التسليحية بالمعدل الحالي ذاته، واستمرار إحساس الدول الخليجية الأخرى بتهديد البرنامج النووي الإيراني، فإن الدول الخليجية لن تجد بديلاً أمامها سوى امتلاك شكل ما من أشكال التكنولوجيا النووية، مع شراء مزيد من الأسلحة التقليدية، وأي مزج بينهما مما يؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط.
رابعًا: إن العديد من الدول الشرق أوسطية التي تسعى الآن لامتلاك الطاقة النووية السلمية، ليس لديها حاجة كبيرة إلى مصادر طاقة إضافية، بقدر حاجتها للشعور بالأمان، حيث ترى أن امتلاكها للطاقة النووية سوف يشكل رادعًا مناسبًا لإيران النووية، وإذا تم ضم إدراك التهديد هذا مع قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل مثل هذا الرادع، فإن الأمر قد يتعامل معه المجتمع الدولي بجدية في السنوات المقبلة
المصدر :
http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/9/367007.htm