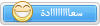ميزان الله في معاملة الخلق
دروس من قصة الخضر وموسى ومن وصايا الرحمة النبوية
ليس كل من عَظُم قدره عند الله معروفًا عند الناس، وليس كل من احتقره الخلق ساقطًا في ميزان السماء.
وهذه حقيقة كبرى تتجلى بوضوح في قصص القرآن، وفي هدي النبي ﷺ، حيث يُعاد تشكيل مفهوم “الفضل” و“الاستحقاق” بعيدًا عن الأسماء والمناصب، وقريبًا من القلوب والأعمال.
ومن أعجب ما يلفت النظر في هذا الباب قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؛ قصة ليست في العلم وحده، بل في الأدب، والرحمة، والصبر، ومعاملة الناس على ظاهرهم لا على ما نجهله عنهم.
أولًا: أسرار تُمنح دون معرفة المقام
التقى موسى عليه السلام – وهو نبي كريم من أولي العزم – رجلًا في الطريق، لا يعرفه، ولم يخبره بحقيقته، ولم يقل له: أنا رسول الله الذي كلّمه الله تكليمًا.
ومع ذلك، فإن الله جلّ وعلا أطلع هذا الرجل – الخضر – على أسرار من أعجب ما ورد في الوحي:
خرق سفينة قوم مساكين، وقتل غلام لم يبلغ الحلم، وبناء جدار في قرية لئيمة.
والمثير للتأمل أن الخضر كان ينفذ أوامر عظيمة، وهو لا يعلم أن من أمامه نبي عظيم بل هو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل
فلم تُبنَ المعاملة على المقام، بل على الابتلاء بالطاعة والأدب والصبر.
وهنا تتجلّى قاعدة إيمانية راسخة:
الله لا يمنح فضله لعباده بناءً على معرفتهم بالناس، بل على صدقهم معه.
ثانيًا: الأدب قبل العلم
لم يكن الخلاف بين موسى والخضر خلاف علم، بل خلاف صبر على الحكمة الغائبة.
ومع ذلك، لم يُسقِط الخضر حق موسى، ولم يُهنه، ولم يقل له: أنت لا تفهم.
بل كان يعذره، ويذكّره بلطف:
﴿إنك لن تستطيع معي صبرًا﴾
حتى حين وقع الفراق، لم يكن قطيعة ازدراء، بل بيان حكمة ورحمة.
وهذا يعلّمنا أن الاختلاف لا يبرر سوء الخلق، وأن رفعة المقام لا تُسقط واجب الرفق.
ومع أن موسى غريب لايعرفه الخضر أو لم يعرفه في بداية الصحبة إلا أنه لم يفارقه حتى عذره مرتين ثم فارقه الثالثة
ثالثًا: سبعون مرة… مع من لا منزلة له
ثم ننتقل إلى هدي النبي ﷺ في شأن الخادم، فيأمر بالعفو، لا مرة ولا مرتين، بل:
«اغفر له في اليوم سبعين مرة»
سبعون مرة!
لخادم، لا نسب، ولا قرابة، ولا وجاهة.
بل ويقول ﷺ:
«إخوانكم خَوَلُكم جعلهم الله تحت أيديكم»
فجعل معيار التعامل ليس “مَن هو”، بل كيف جعله الله في ابتلائك.
وهنا ينهدم وهم خطير:
أن بعض الناس يُعفى من سوء الخلق معهم بحجة أنهم “أقل”.
رابعًا: فكيف بمن أوصى الله بهم؟
إذا كان هذا هو ميزان الرحمة مع خادم أو رجل لا تعرفه،
فكيف بمن أوصى الله بهم نصًّا؟
الوالدان:
ليس المطلوب برّهما حين الإحسان فقط، بل حتى مع التقصير والكبر.
الأرحام:
تُوصَل وإن قُطعت، ويُحسَن إليها وإن أساءت.
الجيران:
ولو كانوا مختلفين معك في الطبع أو الدين.
الزوجة والصاحب:
حيث العِشرة الطويلة وكثرة الزلل.
وهنا يظهر الفرق بين الأخلاق الموسمية، والأخلاق التعبدية.
فحسن الخلق مع القريب عبادة، لا مجاملة.
خامسًا: امتحان الخلق الحقيقي
ليس الامتحان في أن تكون لطيفًا مع من يُعجبك،
ولا في احترام من يُهاب،
بل في:
الصبر على من يتكرر خطؤه،
والعفو عمن يسيء وأنت قادر،
وحسن الظن بمن لا تعرف مقامه عند الله.
فقد يكون الذي تحتقره اليوم، هو عند الله أسبق منك.
وقد يكون صبرك عليه هو أثقل ما في ميزانك يوم القيامة.
خاتمة
قصة الخضر وموسى، ووصايا النبي ﷺ في العفو والرحمة، ليست حكايات تُتلى، بل موازين تُختبر.
موازين تُعلّمنا أن الله ينظر إلى القلوب، لا إلى الألقاب،
وإلى الصبر، لا إلى الادعاء،
وإلى حسن المعاملة، لا إلى معرفة المقامات.
فطوبى لمن عامل الناس كما لو كان كل واحد منهم عبدًا اصطفاه الله سرًّا،
لأنه بذلك… عامل الله قبل أن يعاملهم.
دروس من قصة الخضر وموسى ومن وصايا الرحمة النبوية
ليس كل من عَظُم قدره عند الله معروفًا عند الناس، وليس كل من احتقره الخلق ساقطًا في ميزان السماء.
وهذه حقيقة كبرى تتجلى بوضوح في قصص القرآن، وفي هدي النبي ﷺ، حيث يُعاد تشكيل مفهوم “الفضل” و“الاستحقاق” بعيدًا عن الأسماء والمناصب، وقريبًا من القلوب والأعمال.
ومن أعجب ما يلفت النظر في هذا الباب قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؛ قصة ليست في العلم وحده، بل في الأدب، والرحمة، والصبر، ومعاملة الناس على ظاهرهم لا على ما نجهله عنهم.
أولًا: أسرار تُمنح دون معرفة المقام
التقى موسى عليه السلام – وهو نبي كريم من أولي العزم – رجلًا في الطريق، لا يعرفه، ولم يخبره بحقيقته، ولم يقل له: أنا رسول الله الذي كلّمه الله تكليمًا.
ومع ذلك، فإن الله جلّ وعلا أطلع هذا الرجل – الخضر – على أسرار من أعجب ما ورد في الوحي:
خرق سفينة قوم مساكين، وقتل غلام لم يبلغ الحلم، وبناء جدار في قرية لئيمة.
والمثير للتأمل أن الخضر كان ينفذ أوامر عظيمة، وهو لا يعلم أن من أمامه نبي عظيم بل هو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل
فلم تُبنَ المعاملة على المقام، بل على الابتلاء بالطاعة والأدب والصبر.
وهنا تتجلّى قاعدة إيمانية راسخة:
الله لا يمنح فضله لعباده بناءً على معرفتهم بالناس، بل على صدقهم معه.
ثانيًا: الأدب قبل العلم
لم يكن الخلاف بين موسى والخضر خلاف علم، بل خلاف صبر على الحكمة الغائبة.
ومع ذلك، لم يُسقِط الخضر حق موسى، ولم يُهنه، ولم يقل له: أنت لا تفهم.
بل كان يعذره، ويذكّره بلطف:
﴿إنك لن تستطيع معي صبرًا﴾
حتى حين وقع الفراق، لم يكن قطيعة ازدراء، بل بيان حكمة ورحمة.
وهذا يعلّمنا أن الاختلاف لا يبرر سوء الخلق، وأن رفعة المقام لا تُسقط واجب الرفق.
ومع أن موسى غريب لايعرفه الخضر أو لم يعرفه في بداية الصحبة إلا أنه لم يفارقه حتى عذره مرتين ثم فارقه الثالثة
ثالثًا: سبعون مرة… مع من لا منزلة له
ثم ننتقل إلى هدي النبي ﷺ في شأن الخادم، فيأمر بالعفو، لا مرة ولا مرتين، بل:
«اغفر له في اليوم سبعين مرة»
سبعون مرة!
لخادم، لا نسب، ولا قرابة، ولا وجاهة.
بل ويقول ﷺ:
«إخوانكم خَوَلُكم جعلهم الله تحت أيديكم»
فجعل معيار التعامل ليس “مَن هو”، بل كيف جعله الله في ابتلائك.
وهنا ينهدم وهم خطير:
أن بعض الناس يُعفى من سوء الخلق معهم بحجة أنهم “أقل”.
رابعًا: فكيف بمن أوصى الله بهم؟
إذا كان هذا هو ميزان الرحمة مع خادم أو رجل لا تعرفه،
فكيف بمن أوصى الله بهم نصًّا؟
الوالدان:
ليس المطلوب برّهما حين الإحسان فقط، بل حتى مع التقصير والكبر.
الأرحام:
تُوصَل وإن قُطعت، ويُحسَن إليها وإن أساءت.
الجيران:
ولو كانوا مختلفين معك في الطبع أو الدين.
الزوجة والصاحب:
حيث العِشرة الطويلة وكثرة الزلل.
وهنا يظهر الفرق بين الأخلاق الموسمية، والأخلاق التعبدية.
فحسن الخلق مع القريب عبادة، لا مجاملة.
خامسًا: امتحان الخلق الحقيقي
ليس الامتحان في أن تكون لطيفًا مع من يُعجبك،
ولا في احترام من يُهاب،
بل في:
الصبر على من يتكرر خطؤه،
والعفو عمن يسيء وأنت قادر،
وحسن الظن بمن لا تعرف مقامه عند الله.
فقد يكون الذي تحتقره اليوم، هو عند الله أسبق منك.
وقد يكون صبرك عليه هو أثقل ما في ميزانك يوم القيامة.
خاتمة
قصة الخضر وموسى، ووصايا النبي ﷺ في العفو والرحمة، ليست حكايات تُتلى، بل موازين تُختبر.
موازين تُعلّمنا أن الله ينظر إلى القلوب، لا إلى الألقاب،
وإلى الصبر، لا إلى الادعاء،
وإلى حسن المعاملة، لا إلى معرفة المقامات.
فطوبى لمن عامل الناس كما لو كان كل واحد منهم عبدًا اصطفاه الله سرًّا،
لأنه بذلك… عامل الله قبل أن يعاملهم.