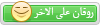كلامك مظبوط فعلا
لكن هناك شواهد تاريخية قوية على أن عددًا من العلماء والفلاسفة اليونانيين القدماء تلقّوا العلم من مصر الفرعونية، أو على الأقل تأثروا بعلومها ومعارفها، خصوصًا في مجالات الفلك، الرياضيات، الطب، والدين.
المصادر القديمة نفسها — سواء اليونانية أو اللاحقة — تحكي عن رحلات هؤلاء العلماء إلى مصر، طلبًا للحكمة من الكهنة المصريين الذين كانوا يعتبرون خزائن العلوم.
أبرز الأمثلة:
فيثاغورس (Pythagoras)
المؤرخون القدامى مثل هيرودوت وديودور الصقلي ذكروا أن فيثاغورس سافر إلى مصر وأقام فيها سنوات، وتلقى من الكهنة علوم الهندسة والموسيقى والعدد، وتأثر بمفهوم النقاء الروحي والتقمص.
أفلاطون (Plato)
في كتابه تيمايوس والقوانين، أشار أفلاطون إلى أن المصريين كانوا أسبق من اليونان في العلوم والفنون، وذكر أنهم علّموه مبادئ في الفلك والهندسة. وهناك روايات أنه زار مصر والتقى الكهنة في منف وسايس.
طاليس الملطي (Thales of Miletus)
أحد أوائل فلاسفة اليونان، ويقال إنه تعلم الحساب والهندسة من المصريين، ومنها استنتج قاعدة حساب ارتفاع الأهرام عبر الظل.
هيرودوت (Herodotus)
مؤرخ القرن الخامس ق.م. لم يكن عالم رياضيات أو فلك، لكنه كتب بوضوح أن مصر "أم الحضارات" وأن اليونانيين أخذوا منها كثيرًا من الطقوس والمفاهيم.
إقليدس (Euclid)
وُلد في الإسكندرية خلال العصر البطلمي، وكتابه العناصر هو نتاج بيئة مصرية-يونانية اختلطت فيها علوم الفراعنة مع المدرسة اليونانية.
كيف انتقل العلم؟
كان الكهنة المصريون يحتفظون بالعلوم في المعابد، ويُدرّسونها لمن يثبت جديته في التعلم. اليونانيون الذين زاروا مصر غالبًا كانوا يدخلون في نوع من "التلمذة" على يد هؤلاء الكهنة، يتعلمون خلالها الحساب والهندسة والفلك والطب، وأحيانًا أسرار دينية وفلسفية.
📜 اقتباس من بلوتارخ عن فيثاغورس:
> "ذهب إلى مصر حيث تلقى من الكهنة علوم العدد والهندسة، وأفكارًا عن نقاء النفس."
📜 اقتباس من هيرودوت:
> "يكاد يكون كل شيء عند اليونانيين قد جاء من مصر."
تمام، سأعطيك قائمة مرتبة بأهم العلماء والفلاسفة اليونانيين الذين تلقوا العلم من مصر أو تأثروا به، مع ذكر فترات حياتهم، مجالاتهم، وروايات المصادر القديمة التي وثّقت زيارتهم أو تعلمهم هناك.
قائمة العلماء والفلاسفة اليونان الذين أخذوا العلم من مصر
1. طاليس الملطي (Thales of Miletus)
- الفترة: 624–546 ق.م
- المجال: الفلسفة، الرياضيات، الفلك
- صلة بمصر: ذكر بروكلوس وديودور أن طاليس تعلم الهندسة من الكهنة المصريين، ومنها وضع مبادئ حساب الظلال لقياس ارتفاع الأهرامات.
- اقتباس: بروكلوس: "طاليس ذهب إلى مصر وتعلم هناك الهندسة."
2. فيثاغورس (Pythagoras)
- الفترة: 570–495 ق.م
- المجال: الرياضيات، الفلسفة، الموسيقى
- صلة بمصر: هيرودوت وبلوتارخ يذكران أنه عاش في مصر حوالي 22 عامًا، وتلقى علوم العدد والموسيقى والفلك، وتأثر بفكرة التناسخ والنقاء الروحي.
- اقتباس: بلوتارخ: "ذهب فيثاغورس إلى مصر حيث تلقى من الكهنة علوم العدد والهندسة وأفكارًا عن نقاء النفس."
3. سولون (Solon)
- الفترة: 630–560 ق.م
- المجال: السياسة، التشريع، الفلسفة
- صلة بمصر: زار مدينة سايس وقابل كهنة مصريين تحدثوا معه عن تاريخ قديم يسبق تاريخ اليونان بآلاف السنين، ونقل هذه القصص إلى أفلاطون.
- اقتباس: أفلاطون في تيمايوس: "قال الكاهن لسولون: أنتم أيها الإغريق أطفال، لا أحد منكم قديم في المعرفة."
4. أفلاطون (Plato)
- الفترة: 427–347 ق.م
- المجال: الفلسفة
- صلة بمصر: تشير بعض المصادر إلى أنه زار مصر حوالي عام 387 ق.م بعد وفاة سقراط، وتلقى مبادئ في الهندسة والفلك والفلسفة من الكهنة.
- اقتباس: في القوانين: "إن المصريين يحافظون على الفنون منذ آلاف السنين، مما يجعلها في حالة كمال لم يدركه الإغريق."
5. إقليدس (Euclid)
- الفترة: حوالي 300 ق.م
- المجال: الرياضيات والهندسة
- صلة بمصر: عاش وعمل في الإسكندرية خلال العصر البطلمي، ودمج ما ورثه من علوم المصريين في كتابه الشهير العناصر.
- اقتباس: بالرغم من قلة التفاصيل عن حياته، إلا أن سياق عمله في مكتبة الإسكندرية يثبت اختلاطه بالعلوم المصرية القديمة.
6. هيرودوت (Herodotus)
- الفترة: 484–425 ق.م
- المجال: التاريخ والجغرافيا
- صلة بمصر: زار مصر وسجّل ملاحظاته عن علومها وفنونها، واعتبرها مصدر حضارات أخرى.
- اقتباس: "يكاد يكون كل شيء عند اليونانيين قد جاء من مصر."
7. ديموقريطوس (Democritus)
- الفترة: 460–370 ق.م
- المجال: الفلسفة، الذرّية
- صلة بمصر: تقول الروايات إنه سافر إلى مصر وتعلم من الكهنة الرياضيات والفلك، مما ساعده في صياغة نظريته الذرية.
📜
خلاصة:
العلماء والفلاسفة اليونانيون لم يبدؤوا من فراغ، بل استفادوا بشكل كبير من المعارف المصرية القديمة، خاصة عبر رحلاتهم إلى المعابد والمراكز العلمية على ضفاف النيل.
دول كانوا قبل الإسكندر بكتير