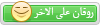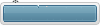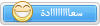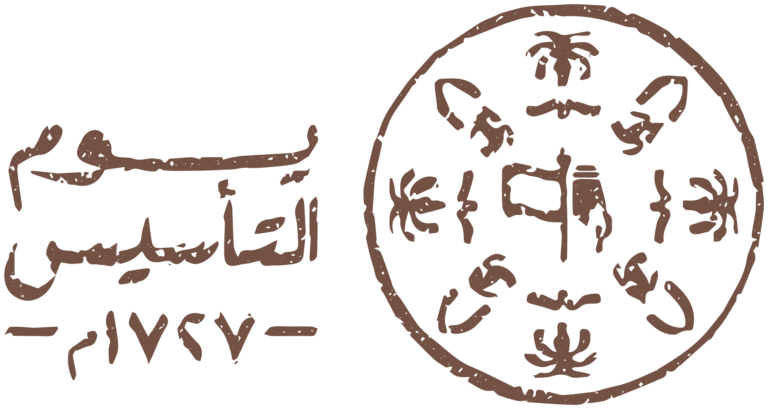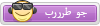قبل أن نركز بحثنا على وجود المملكيتن المغربية والسعودية على الساجة السياسية العربية والإسلامية منذ ثلاثة قرون يلذ لنا أن نشير في عرض موجز إلى نوع من التبادل الحضاري تم منذ ثلاثة آلاف سنة خلت بين شقي العروبة عندما تأسست أول مدينة كنعانية عربية بالمغرب عام 1101 ق.م. في بلاد الهبط التي أفردها ابن رشد برسالة خاصة وهي ليكس lexe التي سميت ليكسوس liscus في العهد الروماني وقد تحقق هذا التواصل في فترتين اثنتين أولاهما أيام امتداد النفوذ الكنعاني الفينيقي إلى الخليج وثانيتهما عندما انطلق هذا التأثير عبر التخوم الجنوبية اليمنية للجزيرة المحاذية للربع الخالي، حيث تواكبت مظاهر حضارية شتى، ولا تزال في المنطقتين وذلك بالإضافة إلى باقي منطقة الخصيب إلى (بايل)، حيث تداولت أمم كلدانية وآشورية وحمورابية وبابلونية انحدت جميعها حسب أغلبية المؤرخين حتى الغربيين منهم من أقصى جنوب الجزيرة العرلابية مما يضفي على المناطق الثلاث طابعا خاصا أسيسته وحدة حضارية متكاملة وقد قدمت بحثا مطولا في الموضوع ضمن محاضرة ألقيتها بدعوة من (الديوان الأميري) في أبي ظبي في الثمانينات حول الوشائج الأثيلة بين شقي العروبة من الخليج إلى المحيط منذ أعرق العصور، وقد تعززت هذه النظرة العلمية بعد ارتفاع الحواجز الاستعمارية المصطنعة منذ أوائل السبعينات يوم استمعنا إلى أغنيات يمنية بلهجة محلية تفهمها سكان الأطلس رغم ما اعتورها من دخيل في الجانبين خلال الأجيال المتعاقبة وهذه الحقيقة تفند ما زعمه (ابن خلدون) نقلا عن (ابن حزم) من عدم دخول العنصر الحميري إلى المغرب الكبير بدعوى عدم إشارة مؤرخي مصر إلى مرور (افريقش الحميري) بدلتا النيل، وهو وهم نستغرب وقوع ابن خلدون فيه بل إنه يحمل في طياته دلالة على عراقة الأصالة بين المغرب وصحرائه لأن افريقش هذا قد اجتاز (بحر القلزم) (البحر الأحمر) ليصل من اليمن إلى أقصى تخوم الصحراء المغربية.
كانت بلاد الحجاز تابعة للماليك قبل انصياعها للعثمانيين في عهد (الشريف بركسات) في حين لم يمتد الحكو العثماني على غرار المغرب إلى أرض نجد التي قيض الله آل سعود لكفالة حريتها وحرية سواحل الخليج العربي بكامله ففي نفس الوقت الذي كانت (الأستانة) تحاول بسط نفوذها على (الأحساء) مستغلة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية انبرى آل سعود معززين بحركة الإمام محمد بن عبد الوهاب لإصلاح هذا المجتمع ونشر بذور الوحدة والقضاء على عصبيات الجاهلية الجهلاء التي شجعها العمال العثمانيون فكان في طموحاتها الانفصالية حتفهم لأنها استحالت إلى عشائر تسلب وتنهب، جاعلة من قرى ومدن الجزيرة وطرقها وشعب قوافلها طعمة لغاراتها كما فعل الاستعمار الغربي في المغرب الأقصى عندما كان يبث سمومه منذ نفس الفترات لبث الشقاق والفتنة وإثارة القبائل ضد الأسرة العلوية الحاكمة التي استطاعت مثل المملكة السعودية أن تعزز تحريرر المغرب من قيود العثمانيين ومن سيطرة (الإيبيريين) على جيوب ساحلية وذلك بفضل اعتصامهما بروح إسلامية أسيستها عروة السلفية الوثقى والشعور الفياض بضرورة ضمان وحدة الكيان وبذلك تأصلت منذ ثلاثة قرون في شقي العروبة من الخليج إلى المحيط مملكتان عربيتان إسلاميتان قدر لهما أن تنطلقا في ظروف متواكبة.
كانت بلاد الحجاز تابعة للماليك قبل انصياعها للعثمانيين في عهد (الشريف بركسات) في حين لم يمتد الحكو العثماني على غرار المغرب إلى أرض نجد التي قيض الله آل سعود لكفالة حريتها وحرية سواحل الخليج العربي بكامله ففي نفس الوقت الذي كانت (الأستانة) تحاول بسط نفوذها على (الأحساء) مستغلة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية انبرى آل سعود معززين بحركة الإمام محمد بن عبد الوهاب لإصلاح هذا المجتمع ونشر بذور الوحدة والقضاء على عصبيات الجاهلية الجهلاء التي شجعها العمال العثمانيون فكان في طموحاتها الانفصالية حتفهم لأنها استحالت إلى عشائر تسلب وتنهب، جاعلة من قرى ومدن الجزيرة وطرقها وشعب قوافلها طعمة لغاراتها كما فعل الاستعمار الغربي في المغرب الأقصى عندما كان يبث سمومه منذ نفس الفترات لبث الشقاق والفتنة وإثارة القبائل ضد الأسرة العلوية الحاكمة التي استطاعت مثل المملكة السعودية أن تعزز تحريرر المغرب من قيود العثمانيين ومن سيطرة (الإيبيريين) على جيوب ساحلية وذلك بفضل اعتصامهما بروح إسلامية أسيستها عروة السلفية الوثقى والشعور الفياض بضرورة ضمان وحدة الكيان وبذلك تأصلت منذ ثلاثة قرون في شقي العروبة من الخليج إلى المحيط مملكتان عربيتان إسلاميتان قدر لهما أن تنطلقا في ظروف متواكبة.