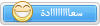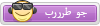مقال jeuneafrique حول قطع العلاقات بين المغرب و الجزائر الشقيقة بعنوان مثير ، أتمنى ألا تكون الصحيفة مخزنية كذلك.
Algérie-Maroc : Ramtane Lamamra, pompier ou pyromane ?
La première phrase de la déclaration officielle N° 12/105, par laquelle le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a annoncé, le 24 août, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, mérite d’être citée in extenso : tout y est dit, en filigrane, d’un voisinage impossible entre deux régimes apparemment incompatibles, lequel ne s’est jamais traduit qu’en termes d’hégémonie et de rivalité. À preuve, cette phrase accusatoire pourrait être reprise mot pour mot, une fois les rôles inversés, par la partie marocaine. Qu’énonce-t-elle ? « Il est historiquement objectivement établi que le royaume du Maroc n’a jamais cessé de mener des actions hostiles, inamicales et malveillantes à l’encontre de notre pays et ce, depuis l’indépendance de l’Algérie. » Suit un exercice de rétrospective chronologique en plusieurs étapes destiné à démontrer comment le Maroc « a sapé, systématiquement et durablement » toute tentative de rapprochement entre les deux pays, au point de les vouer « sans rémission » à suivre « un chemin étroit côtoyant l’abîme ».
Réécriture de l’Histoire
Premier flashback de l’Histoire telle que l’a réécrit Ramtane Lamamra : la Guerre des sables de 1963, « guerre d’agression ouverte, guerre fratricide déclenchée par les forces armées royales », selon lui, et dont on ignorait – mais on l’apprend de la bouche du ministre – qu’elle avait coûté la vie à « 850 valeureux martyrs » (les estimations étaient jusqu’ici de 300 morts algériens et 40 marocains). Tant qu’à faire de cette guerre de quatre semaines, dont on sait qu’elle fut gagnée par le Maroc sur le plan militaire et par l’Algérie sur le plan diplomatique, la pierre angulaire de l’hostilité chérifienne à l’encontre de ses voisins de l’Est, mieux valait en retracer le contexte – ce que se garde de faire M. Lamamra. Rappeler par exemple le soutien apporté par Mohammed V aux combattants algériens pendant la guerre d’indépendance, ainsi que son refus, qui fut déterminant pour la suite, d’accéder au troc que lui proposaient les Français : la rétrocession de la wilaya de Tindouf (laquelle était rattachée à la province d’Agadir jusqu’en 1952) en échange de la liquidation des sanctuaires de l’ALN dans l’Oriental. Rappeler aussi qu’à l’époque « El Moudjahid » traitait Hassan II de « pantin féodal » et qu’aujourd’hui encore le camp d’où est parti le premier coup de feu de la Guerre des sables, le 2 octobre 1963 du côté d’Ich, de Hassi Beïda et de Tinjoub, entre regs et hamadas, demeure un mystère.
ON VOIT MAL EN QUOI LE FAIT D’ABRITER, D’ARMER ET D’ENTRETENIR UN FRONT DE GUÉRILLA HOSTILE AU MAROC ENTRE DANS LE CADRE DE LA NON-INGÉRENCE BRANDIE PAR M. LAMAMRA
Autre assertion contenue dans ce communiqué en forme de réquisitoire, celle selon laquelle et depuis toujours, « l’Algérie s’interdit par principe de s’ingérer dans les affaires intérieures du royaume du Maroc ». Contrairement à ce dernier, ajoute Ramtane Lamamra, qui cite à l’appui de sa thèse la désormais fameuse note de l’ambassadeur du Maroc aux Nations unies Omar Hilale soutenant le « droit à l’autodétermination » du « vaillant peuple kabyle ». Maladroite et assurément provocatrice, cette note, distribuée le 14 juillet en marge d’une réunion du mouvement des non-alignés à New York, ne s’explique, là aussi, que dans un contexte précis auquel le ministre algérien des Affaires étrangères ne fait nulle allusion : la brusque réactivation de la crise saharienne. La position algérienne en faveur d’un référendum d’autodétermination est certes connue, mais on voit mal en quoi le fait d’abriter, d’armer et d’entretenir depuis 45 ans sur son territoire un front de guérilla se proclamant en état de guerre ouverte contre le Maroc entre dans le cadre de la « non-ingérence » brandie par M. Lamamra.
Part d’ombre
Depuis novembre 2020, le Polisario revendique au moins une attaque par jour contre le mur de défense marocain. Même si la plupart d’entre eux sont fictifs, ces communiqués de guerre systématiquement relayés par les médias officiels d’Alger sont émis depuis Tindouf. Pour le reste, ne soyons pas naïfs : la confrontation algéro-marocaine s’est toujours accompagnée d’une part d’ombre qui n’a cure du principe de la souveraineté intérieure des deux États. Dans les années 1960 et 1970, quand les services marocains soutenaient discrètement la rébellion kabyle de Hocine Aït Ahmed et parachutaient nuitamment des armes sur le cap Sigli, c’est depuis Alger que Mehdi Ben Barka appelait au renversement de la monarchie et que ses partisans s’infiltraient au Maroc pour y établir des maquis. Aujourd’hui encore, c’est à l’abri du royaume qu’un certain nombre d’ex-responsables algériens, comme Amar Saadani, ancien patron de l’Assemblée et du FLN, détenteur de lourds secrets et objet d’une demande d’extradition, ont trouvé refuge.
Diversion
Face à un Maroc enhardi par la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur l’ex-Sahara occidental et le rétablissement de ses relations avec Israël – un « deal » perçu comme hostile à Alger –, Ramtane Lamamra convoque l’Histoire pour en conclure que la mésentente entre les deux voisins est en quelque sorte consubstantielle et cela, jusqu’au point de non-retour. En réalité, très critiqué en interne pour sa gestion déficiente des incendies de forêts qui ont ravagé une partie du pays et l’ont contraint à solliciter l’aide de l’ancien colonisateur – au fait : combien de canadairs aurait-on pu acheter pour le coût de l’Airbus médicalisé de l’ex-président Bouteflika, immobilisé depuis dix ans dans un hangar de Boufarik avec 50 heures de vol officiel au compteur ? Huit –, le pouvoir algérien n’échappe pas à la tentation, classique en pareille circonstance, de la diversion.
Sans aucune preuve, Ramtane Lamamra va dans son communiqué jusqu’à accuser Rabat d’être impliqué dans les incendies et le lynchage d’un citoyen innocent suspecté de pyromanie, via sa « collaboration active et documentée » avec les « organisations terroristes MAK et Rachad ».
Fuite en avant
L’opinion algérienne suivra-t-elle son gouvernement (ou, plus exactement, son armée, tant il est évident qu’une telle décision n’a pu se prendre sans l’autorisation du chef d’état-major de l’ANP Saïd Chengriha) dans ce qui apparaît comme une fuite en avant ? Rien n’est moins sûr, le désir des deux peuples de se rapprocher ayant depuis toujours été en contradiction avec l’hostilité des dirigeants et le dossier du Sahara n’ayant jamais été en Algérie une cause nationale. La précédente rupture des relations diplomatiques, à l’initiative cette fois du Maroc et sur fond d’affrontements directs entre les armées des deux pays, avait duré douze ans, de 1976 à 1988. Jusqu’où, cette fois, ira-t-on ?