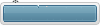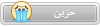في الحرب العالمية الأولى، هُزمت ثلاثُ قوًى استعمارية: العثمانيون، والألمان، والطليان. قوتان من هذه القوى لم تتحمَّلا مرارةَ الهزيمة، وأرادتا استعادة ما اعتبرتاه «حقاً» لهما، وأشعلتا حرباً توسعية قبل أنْ تجف ذكريات الحرب الأولى، بما فيها من مآسٍ.
أما القوة الاستعمارية الثالثة، العثمانية، فأخفت المرارة تحت العجز. كان رجل أوروبا المريض من الضعف قبل الحرب الأولى بحيث انهزم بالضربة القاضية. ولم يكن ممكناً أن يقوم من أرض الحلبة، ويطالب باستعادة المستعمرات.
حظ تركيا كان أفضل، إذ صعد إلى القيادة مصطفى كمال أتاتورك، قرأ الأحداث، وقاسَ الواقع، فعلم أنَّ عهد الإمبراطوريات الاستعمارية إلى أفول، وأنَّ المستقبل للدولة الوطنية، فأنشأ تركيا الحديثة. هتلر وموسوليني جرا مزيداً من الخراب على دولتيهما، وخرجا بهزيمة أنكى من سابقتها.
أنصار الإمبراطورية الاستعمارية من العثمانيين لم يختفوا. أُبعدوا عن الواجهة لكن لم يختفوا. القيادة التركية انضمت إلى تحالف «الناتو» مع هازميها. أما هم فوظفوا فلول الإمبراطورية المهزومة في مستعمراتها السابقة، انتظاراً للحظتهم الهتلرية.
إن أردنا تقوية اقتصادنا بالسياحة، هاجم فلول العثمانيين عندنا السياح. إن أردنا تقوية وجودنا الاستراتيجي بالتحالفات العسكرية، رفعوا شعارات الولاء والبراء. إن أردنا تحديث الاقتصاد وتنويعه، حولوا المجتمع إلى طارد للأجانب كاره لهم. كل هذا في بلادنا. أما في تركيا، فعلى قلوبهم أحلى من العسل.
كانت وظيفة فلول العثمانيين في بلادنا تجريدنا من وسائل القوة، والسماح بها فقط لتركيا، استعداداً لتلك اللحظة الهتلرية، الموسولينية، حين يحين موعدها. حين يخرج من بين صفوف العثمانيين هتلر التركي يشكو من «سايكس بيكو» كما شكا هتلر من «فرساي». ويطالب باستعادة المستعمرات وكأنها حق له. اللحظة التي لا يهتم فيها بالعالم؛ بل يراهن على تخاذله، وينطلق في الجوار متوسعاً. هذا نقل بالمسطرة من كتاب هتلر.
ليس هذا عجيباً بالنسبة لنا، نحن الذين تخلَّصنا من الاستعمار العثماني سابقاً؛ لكننا لم نتخلص أبداً من دعايته على أرضنا. سمعناها في خطابات فلول العثمانيين كثيراً، تحت شعار «إعادة الخلافة». روَّجوا بلا خجل أنَّ مجتمعاتنا القديمة التي نشأت منها الحضارة قبل آلاف السنين «صنيعة سايكس بيكو». وكأن التاريخ بدأ في بني عثمان قبل خمسة قرون. حتى النازيون لم يكونوا بهذه «البجاحة». وشاهدنا أجيالاً من عناصر محلية داعمة تنمو حولنا. وشاهدناهم وقد صاروا نجوماً على شاشات التحالف العثماني الداخلة إلى بيوتنا. شاهدناهم وهم يجعلون «الخيانة الوطنية» وجهة نظر. أعوانهم من جماعات حقوق بني عثمان حرمتنا حتى من الحق الطبيعي في مواجهة عدونا، الحق الذي تمتع به الغرب حين كان يحارب هتلر، فيطارد المتعاونين معه بتهمة الخيانة. فعلمنا أن العثمانيين قادمون لحربنا لا محالة.
أما المثير للعجب فتكرار أوروبا رد فعلها المتأخر مع هتلر، ومراضاته، وقد أقسموا من قبل أنهم وعوا الدرس. سوَّلت لهم أنفسهم أن إردوغان ليس هتلر. وهو أخطر.
الحزب النازي نشأ وذكريات الحرب العالمية الأولى لا تزال حاضرة، والطموح الاستعماري لم يكن شيئاً مستهجناً. كان خصومه أيضاً لهم مستعمرات. أما إردوغان فيريد إحياء الإرث الاستعماري وقد زال من العالم، مدعماً أطماعه بدعاية دينية جهادية، ومعتمداً في توسعاته على جهاديين يتنقل بهم من سوريا إلى ليبيا. جهاديين كفرانكنشتين: تجميعهم كارثة، وتفريقهم كارثة.
حروب هتلر قضت على ملايين من الشباب الأوروبي من الجنود؛ لكنها كانت حرباً نظامية، انتهت وتمت السيطرة على العمليات الحربية. أما حروب إردوغان فتخرج جهاديين لن يضبطهم أحد.
كانت أوروبا تخشى موجات الهجرة لأيادٍ باحثة عن الرزق وهاربة من الحرب. الآن، تعد لها تركيا على سواحل المتوسط القريبة موجات جديدة من أيادٍ رزقها القتال، وتبحث عن الحرب.
لكن لننسَ أوروبا. انتبهت أم لا، ما حكَّ جلدَك مثلُ ظفرك. علينا أن نتجهز مادياً ومعنوياً وإعلامياً لاحتمال ليس ضئيلاً: أن حربنا الكبرى المؤجلة، لحظتنا مع هتلر، ربما تكون أقرب مما نظن. علينا ألا نخطئ خطأ شرق أوروبا فننتظر عون غيرنا. وعلينا - حتى لو لم تقع المواجهة العسكرية - أن نعمل للمستقبل بتجريده من أدوات حربه الأخرى. الآن وإلى الأبد.
لدى إردوغان ميزتان كبريان ومتصلتان؛ الأولى هي الصورة الذهنية التي تكونت عن تركيا، والثانية هي امتلاكه للعناصر المحلية الداعمة.
الصورة الذهنية عن تركيا في أي بلد أوروبي شبيهة بأوروبا، السياح لا يضايقهم أحد، والبلد مفتوحة لا توحي أبداً بوجود تطرف أو تشدد. أما عندنا، فالعناصر المحلية الداعمة وظيفتها الأولى كانت خلق صورة ذهنية معاكسة عنا نحن. لم تكن تلك مهمة ثانوية في الاستعداد للحرب. كل هذا يترجم سياسياً إلى قبول العالم لطرف ونفور من آخر.
حين حانت لحظة المواجهة، كانت العناصر المحلية الداعمة هي هي، تقف صراحة إلى جانب تركيا. لا زهدنا ولا حياتنا الصعبة المتقشفة، لا الحجاب، ولا الأذان في الميكروفونات، ولا «محاربة مظاهر الفجور» شفعت لنا عندهم وهم يختارون الدولة التي يخدمونها! بل استخدموها لإغراء مزيد من الشباب بـ«جمال تركيا» و«انفتاح تركيا».
هزيمة العناصر المحلية الداعمة - ينبغي أن نكون تعلمنا - الخطوة الأولى في حربنا.
علينا أن نعي خطورة أفكار التشدد الديني، حتى لو لم يصاحبها سلاح. هذه الأفكار غرضها هدم الدولة في أذهان مواطنيها، ثم في أذهان العالم، تمهيداً لابتلاعها. هدفها تحويل أوطاننا إلى بلاد نفورة، لا يحبها أبناؤها، يزهدون فيها، فيسهل على الطامعين ابتلاعها.
أما اجتماعياً، فعلينا أن نشين أفكار «الطابور الخامس» ورموزه، في كل مناسبة، ولو كان تعليقاً على «السوشيال ميديا»، وأن نخبرهم أننا نفهم ما يفعلون. ونعرف من يلمعهم وينفخ في صورهم.
لا يمكن للحياة أن تعطينا دروساً أوضح مما أعطتنا. وإلا: لا نلومن إلا أنفسنا.
المصدر
أما القوة الاستعمارية الثالثة، العثمانية، فأخفت المرارة تحت العجز. كان رجل أوروبا المريض من الضعف قبل الحرب الأولى بحيث انهزم بالضربة القاضية. ولم يكن ممكناً أن يقوم من أرض الحلبة، ويطالب باستعادة المستعمرات.
حظ تركيا كان أفضل، إذ صعد إلى القيادة مصطفى كمال أتاتورك، قرأ الأحداث، وقاسَ الواقع، فعلم أنَّ عهد الإمبراطوريات الاستعمارية إلى أفول، وأنَّ المستقبل للدولة الوطنية، فأنشأ تركيا الحديثة. هتلر وموسوليني جرا مزيداً من الخراب على دولتيهما، وخرجا بهزيمة أنكى من سابقتها.
أنصار الإمبراطورية الاستعمارية من العثمانيين لم يختفوا. أُبعدوا عن الواجهة لكن لم يختفوا. القيادة التركية انضمت إلى تحالف «الناتو» مع هازميها. أما هم فوظفوا فلول الإمبراطورية المهزومة في مستعمراتها السابقة، انتظاراً للحظتهم الهتلرية.
إن أردنا تقوية اقتصادنا بالسياحة، هاجم فلول العثمانيين عندنا السياح. إن أردنا تقوية وجودنا الاستراتيجي بالتحالفات العسكرية، رفعوا شعارات الولاء والبراء. إن أردنا تحديث الاقتصاد وتنويعه، حولوا المجتمع إلى طارد للأجانب كاره لهم. كل هذا في بلادنا. أما في تركيا، فعلى قلوبهم أحلى من العسل.
كانت وظيفة فلول العثمانيين في بلادنا تجريدنا من وسائل القوة، والسماح بها فقط لتركيا، استعداداً لتلك اللحظة الهتلرية، الموسولينية، حين يحين موعدها. حين يخرج من بين صفوف العثمانيين هتلر التركي يشكو من «سايكس بيكو» كما شكا هتلر من «فرساي». ويطالب باستعادة المستعمرات وكأنها حق له. اللحظة التي لا يهتم فيها بالعالم؛ بل يراهن على تخاذله، وينطلق في الجوار متوسعاً. هذا نقل بالمسطرة من كتاب هتلر.
ليس هذا عجيباً بالنسبة لنا، نحن الذين تخلَّصنا من الاستعمار العثماني سابقاً؛ لكننا لم نتخلص أبداً من دعايته على أرضنا. سمعناها في خطابات فلول العثمانيين كثيراً، تحت شعار «إعادة الخلافة». روَّجوا بلا خجل أنَّ مجتمعاتنا القديمة التي نشأت منها الحضارة قبل آلاف السنين «صنيعة سايكس بيكو». وكأن التاريخ بدأ في بني عثمان قبل خمسة قرون. حتى النازيون لم يكونوا بهذه «البجاحة». وشاهدنا أجيالاً من عناصر محلية داعمة تنمو حولنا. وشاهدناهم وقد صاروا نجوماً على شاشات التحالف العثماني الداخلة إلى بيوتنا. شاهدناهم وهم يجعلون «الخيانة الوطنية» وجهة نظر. أعوانهم من جماعات حقوق بني عثمان حرمتنا حتى من الحق الطبيعي في مواجهة عدونا، الحق الذي تمتع به الغرب حين كان يحارب هتلر، فيطارد المتعاونين معه بتهمة الخيانة. فعلمنا أن العثمانيين قادمون لحربنا لا محالة.
أما المثير للعجب فتكرار أوروبا رد فعلها المتأخر مع هتلر، ومراضاته، وقد أقسموا من قبل أنهم وعوا الدرس. سوَّلت لهم أنفسهم أن إردوغان ليس هتلر. وهو أخطر.
الحزب النازي نشأ وذكريات الحرب العالمية الأولى لا تزال حاضرة، والطموح الاستعماري لم يكن شيئاً مستهجناً. كان خصومه أيضاً لهم مستعمرات. أما إردوغان فيريد إحياء الإرث الاستعماري وقد زال من العالم، مدعماً أطماعه بدعاية دينية جهادية، ومعتمداً في توسعاته على جهاديين يتنقل بهم من سوريا إلى ليبيا. جهاديين كفرانكنشتين: تجميعهم كارثة، وتفريقهم كارثة.
حروب هتلر قضت على ملايين من الشباب الأوروبي من الجنود؛ لكنها كانت حرباً نظامية، انتهت وتمت السيطرة على العمليات الحربية. أما حروب إردوغان فتخرج جهاديين لن يضبطهم أحد.
كانت أوروبا تخشى موجات الهجرة لأيادٍ باحثة عن الرزق وهاربة من الحرب. الآن، تعد لها تركيا على سواحل المتوسط القريبة موجات جديدة من أيادٍ رزقها القتال، وتبحث عن الحرب.
لكن لننسَ أوروبا. انتبهت أم لا، ما حكَّ جلدَك مثلُ ظفرك. علينا أن نتجهز مادياً ومعنوياً وإعلامياً لاحتمال ليس ضئيلاً: أن حربنا الكبرى المؤجلة، لحظتنا مع هتلر، ربما تكون أقرب مما نظن. علينا ألا نخطئ خطأ شرق أوروبا فننتظر عون غيرنا. وعلينا - حتى لو لم تقع المواجهة العسكرية - أن نعمل للمستقبل بتجريده من أدوات حربه الأخرى. الآن وإلى الأبد.
لدى إردوغان ميزتان كبريان ومتصلتان؛ الأولى هي الصورة الذهنية التي تكونت عن تركيا، والثانية هي امتلاكه للعناصر المحلية الداعمة.
الصورة الذهنية عن تركيا في أي بلد أوروبي شبيهة بأوروبا، السياح لا يضايقهم أحد، والبلد مفتوحة لا توحي أبداً بوجود تطرف أو تشدد. أما عندنا، فالعناصر المحلية الداعمة وظيفتها الأولى كانت خلق صورة ذهنية معاكسة عنا نحن. لم تكن تلك مهمة ثانوية في الاستعداد للحرب. كل هذا يترجم سياسياً إلى قبول العالم لطرف ونفور من آخر.
حين حانت لحظة المواجهة، كانت العناصر المحلية الداعمة هي هي، تقف صراحة إلى جانب تركيا. لا زهدنا ولا حياتنا الصعبة المتقشفة، لا الحجاب، ولا الأذان في الميكروفونات، ولا «محاربة مظاهر الفجور» شفعت لنا عندهم وهم يختارون الدولة التي يخدمونها! بل استخدموها لإغراء مزيد من الشباب بـ«جمال تركيا» و«انفتاح تركيا».
هزيمة العناصر المحلية الداعمة - ينبغي أن نكون تعلمنا - الخطوة الأولى في حربنا.
علينا أن نعي خطورة أفكار التشدد الديني، حتى لو لم يصاحبها سلاح. هذه الأفكار غرضها هدم الدولة في أذهان مواطنيها، ثم في أذهان العالم، تمهيداً لابتلاعها. هدفها تحويل أوطاننا إلى بلاد نفورة، لا يحبها أبناؤها، يزهدون فيها، فيسهل على الطامعين ابتلاعها.
أما اجتماعياً، فعلينا أن نشين أفكار «الطابور الخامس» ورموزه، في كل مناسبة، ولو كان تعليقاً على «السوشيال ميديا»، وأن نخبرهم أننا نفهم ما يفعلون. ونعرف من يلمعهم وينفخ في صورهم.
لا يمكن للحياة أن تعطينا دروساً أوضح مما أعطتنا. وإلا: لا نلومن إلا أنفسنا.
المصدر