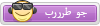القيادة والسيطرة والاتصالات
قائد الدفاع الجوي السابق ( الأمير خالد بن سلطان )
كنت في ميدان الرماية، الذي يبعد نحو 70 كيلو متراً عن مدينة جدّة، أشهد تدريباً على إطلاق صواريخ هوك عندما فُجِعت بنبأ وفاة الملك فيصل. كان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس 1975. انتقلت فوراً إلى المطار وتوجهت إلى الرياض. وعلمت، وأنا في الطائرة، أن الملك فيصل لم يمت ميتة طبيعية، بل قُتل بيد آثمة أطلقت عليه الرصاص. وراعَني أن الذي أطلق عليه الرصاص هو ابن عمي، الأمير فيصل بن مساعد، الذي أذكره منذ أيام الدراسة شاباً هادئاً خلوقاً، فكيف أقدم على مثل هذه الفعلة النكراء؟
بدأت الشائعات تتردد هنا وهناك، وبلغت حد القول أن الأمير فيصلاً عندما كان يدرس في بيروت ثم في جامعة كولورادو الأمريكية، أجرت له الاستخبارات الأمريكية عملية "غسل مخ" ليُقدم على قتل الملك فيصل. وتعزو الشائعات سبب ذلك إلى سياسة الملك فيصل الوطنية التي كانت مصدر قلق وضيق للسلطات الأمريكية، فقد ساند مصر وسوريا إبَّان حرب أكتوبر ، كما ساند الفلسطينيين في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي، وجعل الولايات المتحدة تستشيط غضباً جرَّاء حظر البترول الذي فرضه على الغرب.
غير أنه من الصعب الاقتناع بمثل هذا التوجه في تفسير الأحداث. ومن التفسيرات التي راجت أيضاً في بعض الأوساط، أن القاتل أقدم على فعلته حينما دخل إلى مكتب الملك فيصل، أثناء استقباله وزير البترول الكويتي، بدافع الثأر لأخيه خالد. وكان أخوه، خالد، متعصباً لرأيه دينياً، وكان قد قُتل قبل ذلك ببضع سنوات في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة، حين حاول، مع مجموعة من رفاقه المتعصبين، الهجوم على مركز البث التليفزيوني في الرياض، إذ كانوا يعدون هذا المركز مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ثم تحصّنوا في أحد البيوت القريبة من مبنى التليفزيون، وبادروا إلى إطلاق النار على الشرطة عندما حضرت لاستجلاء الأمر. كانت الأوامر الصادرة إلى قوة الشرطة تقضي بعدم الرد على النار بالمثل، لذلك فمن المرجح أن تكون الرصاصة التي قتلت خالداً قد أطلقها أحد رفاقه. وفي كل حال، فقد حوكم فيصل بن مساعد لاحقا، ونُفذ فيه حد القصاص.
لا شك أن مقتل الملك فيصل على يد أحد أفراد العائلة المالكة كان فاجعة أليمة، تأثرت بها العائلة بأسرها. وما زلت أذكر هذه الحادثة بشيء من الحرج، إذ حينما توجَّهنا لدفن الملك فيصل بعد وفاته بأربع وعشرين ساعة، في حضور الكثير من رؤساء الدول، الذين كان بينهم الرئيس أنور السادات، فغلبني الحزن ولم أستطع كبت مشاعري، فما كان من والدي إلاّ أن زجرني وطلب مني أن أتمالك نفسي. كان الملك فيصل يمثل لنا، نحن الأمراء الشبان في ذلك الوقت، شخصية مهيبة قوية، إذ كان قائداً ملهماً استطاع أن يفرض احترام العائلة والدولة على المجتمع الدولي. وترك فقده حزناً عميقاً في نفوسنا.
في ذلك الوقت الحرج والمحنة القاسية أسدى عمي، الأمير محمد، إلى العائلة معروفاً طوق به الأعناق. كان أكبر الأحياء سناً من أبناء الملك عبدالعزيز، ومن حقه تولي الحكم لو أراد. لكنه كان رجلاً متواضعاً، لم يطمح إلى حكم أو مُلك، فقد سبق أن تنازل عن ولاية العهد طواعية لشقيقه الذي يصغره سناً الأمير خالد. وقد أَرسَى بذلك سابقة مهمة مؤداها أن اختيار الملك يُبنى على السن والكفاءة معاً.
وكما تقضي التقاليد، اجتمعت العائلة بعد ساعة أو ساعتين من وفاة الملك فيصل لمبايعة الملك خالد الذي تعهد أن يحكم بهدي القرآن والسنة. كنت أقف في صف طويل أنتظر دوري لمبايعة الملك، حين رأيت الأمير محمداً يتقدم ويمسك يد الرجل الواقف أول الصف ويقول له: "أريدك أن تبايع أيضاً الأمير فهداً ولياً للعهد".
كان الأمير فهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وسيصبح تلقائياً ولياً للعهد. وكان إزاء المأساة التي حلت بالعائلة بعد وفاة الملك فيصل، يرغب في تأجيل تعيينه رسمياً. وقال معترضاً: "إن الوقت ليس مناسباً لذلك". لكن الأمير محمداً أصرّ على موقفه قائلاً: "كلاَّ.. هذا هو الوقت المناسب". وبتعيين الأمير فهد ولياً للعهد، يكون الأمير محمد قد تخطى اثنين من أخوته هما: الأمير ناصر والأمير سعد. وكانا أكبر سناً من الأمير فهد وأصغر من الملك خالد. فرض الأمير محمد اختياره على العائلة بصفته كبيرها، وتفادى بذلك أية خلافات قد تظهر في المستقبل. كما أرسَى تقليداً جديداً بطلبه البَيعة لولي العهد. فأصبح تقليداً رسمياً أن يُبَايَع الملك وولي العهد في الوقت نفسه. والذي لا شك فيه أن الموقف الذي اتخذه الأمير محمد، لكي يحقق انتقال السلطة في صورة سلسة، هو موقف عظيم يجب أن يذكر في حقه بالشكر والعرفان.
كان عقد السبعينات في المملكة هو عقد الإثارة والقلق، إثارة مردُّها إلى تلك القفزات المتتالية في أسعار النفط عامي 1973 و 1979. قفزات نقلتنا إلى مصافِّ أغنى الدول. ولا يحتاج المرء إلى العودة بذاكرته إلى الوراء كثيراً، ففي الخمسينات، عندما كنت طفلاً كنّا فقراء، وفجأة أصبح في مقدورنا أن نقتني أي شيء في العالم. أصبحت أحلامنا في التقدم والازدهار أمراً ممكناً. أقمنا في فترة قصيرة شبكات من الطرق الحديثة وأنظمة الهاتف المتقدمة. أنشأنا المطارات في كل ركن من أركان بلادنا المترامية الأطراف. امتلكنا أفخم السيارات وأقمنا أحدث المستشفيات والفنادق والجامعات. صممنا المباني العامة التي تبهر النظر على يد أشهر المعماريين في العالم.
ارتفع دخان المصانع بكل أنواعها حول ميناءي الجبيل على الخليج، وينبع على البحر الأحمر، اللذين صُمِّما وفق أحدث الطرز العالمية. فضلاً عن الكثير من المرافق التي انتشرت في كل مكان. تحول مستوى المعيشة في بلدنا، الذي كان متقشفاً في الأربعينات ومتواضعاً في الخمسينات، ومريحاً في الستينيات، إلى مستوى من الثراء والرفاهية يتحدث عن نفسه ولا تكاد تخطئه العين.
كان علينا، في الوقت نفسه، أن ننفق الأموال الطائلة من أجل تقوية دفاعاتنا، نظراً إلى التغيرات الجذرية التي تأثرت بها كل جوانب حياتنا. حدثت تلك التغيرات في حقبة تسودها الاضطرابات والقلق والتوجس. ففي بلدنا، كان فقدان الملك فيصل صدمة قاسية، إذ فقدنا بين عشية وضحاها قائداً سديد الرأي كنّا نُعوِّل عليه كثيراً. وفي المنطقة العربية كان اتجاه مصر نحو سلام منفرد مع إسرائيل سبباً في نشأة الصراعات داخل الصف العربي، مما جعل التوتر يخيم في سماء الأمة العربية. ولم يقتنع بمبادرة السادات، في ذلك الوقت إلا العدد القليل من أبناء المنطقة. لكن الأيام أثبتت، بعد مرور 15 عاماً، أن السادات كان مُحِقاً. فقد تجددت جهود السلام وأخذت تؤتي ثمارها، وإن كان الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة قد سبق السادات بعقد من الزمان في دعوته إلى السلام مع إسرائيل. كان الرئيس التونسي يحضُّ العرب على قبول ما تقدمه إسرائيل، ثم ممارسة الضغوط بعد ذلك للحصول على المزيد من التنازلات عندما تسنح الفرصة لذلك، كما فعل الصهاينة من قبل. لكن نداءه لم يجد لدى العرب آذاناً صاغية. واستمر الصراع العربي - الإسرائيلي المرير يزداد عنفاً وشراسة، تتخلله. الحروب الطاحنة بين الحين والآخر.
بلغ التوتر في المنطقة مداه، في السبعينات، عندما جاء تكتل ليكود اليميني، بزعامة مناحيم بيجن إلى سدّة الحكم في إسرائيل والليكود تكتل متشدد لا يتورَّع عن العدوان، ويسعى إلى إقامة إسرائيل الكبرى. لم يكن في وسعنا أن نغض الطرف عن نُذُر الحرب قرب حدودنا الشمالية الغربية. وكان سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، صدمة عنيفة أخرى جعلت الاضطراب يسود منطقة الخليج كلها. وزادت مخاوفنا على أمن المملكة. ولا يفوتني أن أذكر هنا أنه لم تكن ثمة مخاوف من إيران كدولة إسلامية، لكن التوجهات السياسية المتطرفة ومحاولات النظام الإيراني تصدير الثورة، كانت هي مبعث القلق.
وإن كنت، بحكم عملي العسكري، لم أدخل معترك السياسة، إلاّ أن وجودي في قيادة الدفاع الجوي، مع مسؤولياتي المتزايدة عن تأمين الأسلحة الجديدة، جعلاني أفكر دوماً في العدد المطرد من المدن الرئيسية والمصانع والمرافق التي تنبغي حمايتها من أي عدوان جوي محتمل. فلم يكن مستبعداً بأن تخترق طائرات معادية مجالنا الجوي بين لحظة وأخرى في هذا الجو المتوتر الذي يسود المنطقة.
كان شغلي الشاغل بناء نظام متكامل للدفاع الجوي يغطي مساحة المملكة بكاملها، وكان ذلك عملاً لا يكاد ينتهي. فالحاجة كانت ماسة إلى وحدات جديدة، للدفاع عما يستجد من أهداف حيوية كثيرة. وانحصر الأمر في وضع نظام من الأولويات، إلاّ أن تلك الأولويات لم تكن ثابتة، فالأهداف التي يحتمل تعرُّضها لهجوم جوي كثيرة تشمل العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى والمنشآت البترولية والمصافي ومحطات التحلية ومقر قيادة القوات المسلحة والقواعد الجوية والموانئ البحرية والصناعات الجديدة على الساحلين الشرقي والغربي. كان عليَّ أن أحدد الأهداف الحيوية ثـم أصنفها في ضوء احتمال تعرُّضها للهجوم. وكان هذا العمل يتطلب تخطيطاً وتنسيقًا وإدارة للموارد المتاحة. ويتطلب، فوق ذلك كله، تدريباً مكثفاً شاملاً على مختلف المستويات. ولَمّا كان هناك نقص شديد في الأيدي المدربة، فقد اعتبرت التدريب أهم من العتاد الذي نحصل عليه. ومن هنا، كان ضرورة التوسع المستمر في مدرسة الدفاع الجوي، التي أنشأتها شركة ريثيون في جدة عام 1962، إضافة إلى إرسال مئات من الشباب للتدرب في الخارج من أفراد وفنيين ومشغلين وإداريين ومهندسين وباحثين. فالتقدم في هذا المجال لا حدود له، وكنا على دراية تامة بأن الحرب الإلكترونية تتقدم يوماً بعد يوم. ويبدو ذلك الأمر جلياً بالنظر إلى التقدم في الأجهزة الإلكترونية، التي لا يكاد يخلو منها بيت في هذه الأيام.
فَرَضتْ المساحة الشاسعة للمملكة، الحاجة إلى أنظمة متداخلة متكاملة للدفاع الجوي، أنظمة بعيدة المدى وأخرى متوسطة المدى وثالثة قصيرة المدى، إضافة إلى الدفاع المحلي. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الدفاع الجوي لا يضمن الحماية الكاملة، إذ لا يمكن تأمين عدد كافٍ من الأنظمة يحقق الأمان التام. ألم ينجح مهربو المخدرات بطائراتهم الصغيرة في عبور الحدود المكسيكية - الأمريكية دون أن تكتشف أمرهم أجهزة الدفاع الجوي؟ ألم ينجح شاب ألماني، قبل بضع سنوات، في الوصول بطائرة صغيرة حتى قلب موسكو حيث هبط في الميدان الأحمر، جاعلاً من الدفاعات الجوية السوفيتية مهزلة مضحكة أدّت إلى إقالة قائدها؟
قبل التحاقي بالدفاع الجوي، كانت لدينا مدافع مضادة للطائرات من عيار 40 مم تُشغَّل يدوياً، وهي من أولى أنظمة المدفعية التي حصلت عليها قواتنا، ولا تزال تعمل حتى الآن. أضفنا بعد ذلك مدافع من أحدث الأنواع، بموجب عقدٍ تفاوضَ صالح المُحيَّا في شأنه منذ البداية، وهي مدافع أورليكون oerlikon القصيرة المدى من عيار 35 مم، التي تشتبك مع أهداف تحلق على ارتفاعات منخفضة. وتابعت العقد لاحقاً في محاولة لإخضاع كل عقود الدفاع الجوي لمعايير موحدة.
إن أهمية المدفعية المضادة للطائرات في معركة الدفاع الجوي، لا تقل عن أهمية الصواريخ. فعلى الرغم من أن قذيفة المدفع أسرع من الصاروخ، إلا أنها تختلف عنه من حيث المدى، فأقصى مدى لقذيفة المدفع هو 10 - 11 كم، أما مدى الصاروخ فيزيد على ذلك بخمسة أمثال. لكن دور المدفعية المضادة للطائرات يبرز عندما يخترق العدو الحدود ويبدأ التحليق الفعلي فوق الأهداف الحيوية. وربما لا يكون أمامك من خيار سوى استخدام المدفعية لدَرْء الخطر إذا شوَّش العدو على أنظمة الصواريخ باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، كما حدث للصواريخ العراقية في حرب الخليج. ولا يلزمك، في هذه الحالة، استخدام الرادار لإطلاق قذائف المدفعية، إذ يمكن استخدام العين المجردة، كما فعل العراقيون حين كانت مدافعهم التي نَصَبوها فوق المباني العالية تصيب طائرات التحالف. وكان معظم خسائر قوات التحالف في الطائرات بفعل المدفعية العراقية.
انتقلنا في مرحلة السبعينات، كما ذكرت، من صواريخ هوك الأساسي، وهو سلاح متوسط المدى، إلى صواريخ هوك المطوَّر، ثم انتقلنا في الثمانيات إلى نظام صواريخ هوك الثلاثي، نظراً إلى كثرة الأهداف المطلوب حمايتها. فحصلنا على ست سرايا منها، تتكون كل سرية من ثلاثة فصائل ضرب (fire units) ومجموعة من الرادارات ومركز قيادة سرية ومركز تنسيق المعلومات. وللمحافظة على الكفاءة القتالية لهذه السرايا، بعد نشْرها، كان لا بد من تنفيذ الصيانة الدورية والسنوية في أوقاتها المحددة والتدريب الشاق المتواصل لمنسوبيها، شأنها في ذلك شأن جميع وحدات الدفاع الجوي. وكنت أصرُّ على أن تتحرك السرايا بكامل معداتها من مواقعها إلى ميدان الرماية للتدريب على إطلاق الصواريخ. كنت أول من قرر الرماية الليلية للوحدات مع تبديل المواقع، الأمر الذي مكنني من إذكاء روح التنافس بين الوحدات وتحسين مستويات أدائها.
تخضع كل الأسلحة، التي نحصل عليها، للاختبار في شهر أغسطس للتثبت من صلاحيتها للعمل في جو المملكة، إذ تصل درجات الحرارة في هذا الشهر أعلى معدل لها. وقد أرسيتُ تقليداً يقضي بإخضاع كل مشروع جديد للتعاقد على شراء السلاح لمراجعة نصف سنوية تشمل التصنيع والصلاحية الفنية والتمويل والتدريب. وكانت تلك المراجعات التي تتم في المملكة وفي مقر الشركة المورِّدة بالتناوب، تسهم في حل ما يقرب من 90% من المشاكل التي كانت تواجهنا. كما تعطي كبار المسؤولين من الجانبين - المملكة والشركة - فرصة العمل على معالجة مشاكل التأخير في التنفيذ وقطع الغيار والتدريب.
علمتني خبرة الانتقال من نظام هوك الأساسي إلى نظام هوك المطوَّر، بكل ما انطوت عليه من مشاق، أن بعض المشاريع قد تستغرق سنوات قبل أن تؤتي ثمارها. كنت أتولى، بصفتي مديراً لقسم تخطيط ومشاريع الدفاع الجوي، اختيار الأنظمة الملائمة، وأعمل جاهداً على إقناع اللجان المختلفة والمستشارين الفنيين والقيادات العليا في القوات المسلحة بأهمية تلك الأنظمة. كان هدفي إنشاء شبكة للدفاع الجوي على درجة عالية من الكفاءة، مع تكاملها مع أنظمة القوات الجوية. كان ذلك هدفاً نذرت له جهدي لسنوات طويلة.
كنت أعكف على الدراسة والتحليل والمشاورة قبل أن أُقْدِم على التفاوض مع شركة أجنبية. كنت أبذل قصارى جهدي لاختيار أفضل الكفاءات للعمل معي، وأضع الرجل المناسب في الموقع المناسب. كنت أريد للدفاع الجوي أن يحظى بأفضل العناصر من بين الضباط العاملين الذين يُختارون على أساس الكفاءة والخبرة، ولا شيء غير ذلك. كنت أعرف أنني رئيس صارم يتوقع من مرؤوسيه الكثير، ومن ثَم فعليه أن يكون مثالاً يُحتذى. كنت أعود إلى بيتي محملاً بحقائب مكدسة بالأوراق التي لم يتسع وقت العمل لإنهائها. كنت آخذ نفسي بالشدة، فأُصِبْتُ بآلام في الظهر أجبرتني على العمل واقفاً أشهراً عدة. واسترعى انتباهي أن بعض الزملاء ممن كانوا يعملون معي قد عانوا مشاكل صحية بعينها. فعبدالله جستنيه أُصيب بقرحة في المعدة استدعت علاجه في أحد مستشفيات جدة، وزميل آخر، هو الرائد محمد عيد القرافي، وكان ساعدي الأيمن في مفاوضاتي مع الفرنسيين، تعرض لأزمة قلبية. كان مرد ذلك، بلا ريب، إلى ضغوط العمل.
تبلغ مساحة المملكة ما يزيد على 2.25 مليون كيلومتر مربع، مساحةٌ شاسعة على شكل مستطيل طوله 1700 كيلومتر وعرضه 1400 كيلومتر تقريباً، كأنها قارة كاملة. ونظراً إلى النقص في الطاقة البشرية، فإن الاعتماد على القوات البرية لحماية هذه المساحة الشاسعة، أمر غير معقول. ومن جانب آخر فهناك قيود على حجم قواتنا الجوية. وأعتقد أنَّ ثمة سقفاً أعلى فرضته الولايات المتحدة وأصدقاء إسرائيل داخل أمريكا، على عدد الطائرات المقاتلة التي يُسمح لنا بامتلاكها. ومعنى ذلك أن تظل قدراتنا الدفاعية محدودة دائماً وأضعف من أن تصل إلى مستوى القوة الجوية للدول المجاورة. وسبق أن ذكرت في الفصل السابع، كيف أن قدرة المصريين على استخدام صواريخ سام sam المتحركة ضد القوات الجوية الإسرائيلية وأثر ذلك في تغيير قواعد الحرب، أمرٌ أعجبني إلى حدٍّ بعيد. وخلصت إلى أن الحل يَكْمن في دفاع جوي قوي يمكن أن يؤمن قدراً معقولاً من الحماية إذا نُشر على أساس إستراتيجي متكامل وزُود بنظام إنذار مبكر.
في عام 1974، بدأت أنادي بفصل الدفاع الجوي، وكان لا يزال جزءاً من القوات البرية، واعتباره قوة مستقلة رابعة، أي أن يصبح قوة مستقلة عن القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وأن يُعطى الأولوية القصوى، لكنني واجهت معارضة قوية. ولا يفوتني أن أذكر أن مسألة القيادة والسيطرة على قوات الدفاع الجوي هو أمر يشغل فروع القوات المسلحة في كثير من بلدان العالم المختلفة.
ويُعزى الخلاف، في شأن تبعية الدفاع الجوي ضمن التسلسل القيادي للقوات، إلى مدرستين في الرأي. فالمدرسة الغربية، ترى أن اعتراض الطائرات المعادية هو مهمة القوات الجوية، وأنه يجب أن تكون قوات الدفاع الجوي تحت السيطرة العملياتية للقوات الجوية. أمّا المدرسة الشرقية - المعارضة - والتي ظهرت في الاتحاد السوفيتي السابق، فترى أن استخدام المصادر والمرافق والوسائل المختلفة كمحطات الإنذار المبكر ومحطات الرادارات الأرضية والطائرات الاعتراضية القصيرة المدى تقع كلها ضمن مهمة قوات الدفاع الجوي، وبالتالي فتجب السيطرة عليها بواسطة قيادة دفاع جوي مستقلة، بدلاً من تركها تحت قيادة القوات الجوية أو القوات البرية. ويعتمد الاختيار بين هاتين المدرستين على الإمكانات المتاحة كأعداد الطائرات والعقائد العسكرية السائدة في القوات المختلفة. وقد اختارت مصر بفعل تأثرها بالفكر العسكري السوفيتي، المدرسة الشرقية في ما يتعلق بهذا الموضوع. ولَمّا كنت معجباً باستخدام المصريين لصواريخ أرض - جو وبالأداء الرائع لقوات الدفاع الجوي المصرية أثناء عبور قناة السويس في حرب أكتوبر 1973 ، فقد بذلت محاولات لفصل دفاعنا الجوي عن القوات البرية وتعزيزه قوةً مستقلة.
كانت وجهة نظر المعارضين للفصل تستند إلى صغر حجم قوة الدفاع الجوي في ذلك الوقت. وكانوا يرون أن قوة قوامها 200 ضابط و1000 فرد لا يمكن أن تشكل قوة مستقلة. وكان للتوسع في منشآت الدفاع الجوي أثره في إضعاف تلك الحجة. كنت مقتنعاً تماماً بفكرتي، وتصديت للدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة. ولم أتوقف عن إثارتها في كل اجتماع ومنتدى سنحت لي الفرصة فيه. ولا شك أنني أثقلت على زملائي لكثرة ما جادلتهم في شأن تلكَ الفكرة.
بحلول عام 1976، أدركت أنني لم أحرز تقدماً يذكر في هذا الصدد، بل أدى إلحاحي إلى عكس ما اشتهيت، فبدلاً من تعزيز فكرتي وكسب مؤيدين لها، تكتلت الآراء المعارضة ضدها. لذلك، غيرتُ من خطتي وقررت اتباع أسلوب غير مباشر. وبدأت أسعى إلى تحقيق أهدافي على مراحل متدرجة وخطوة بعد خطوة. وقد آتي هذا الجهد ثماره حين صادقت القيادة العليا عام 1983 على فصل الدفاع الجوي عن القوات البرية، وأصبح مرتبطاً برئيس هيئة الأركان العامة، وتم تخصيص موازنة منفصلة له.
لكن ما أسرع ما أدركت أن الدفاع الجوي لن يثبت وجوده قوةً مستقلة، إلاّ إذا تحقق له التكامل الداخلي، وقبل كل شيء اتصالات على درجة عالية من الكفاءة بين أجزائه المختلفة. كان قد تحقق عند هذه المرحلة، من طريق برامج التسلح المختلفة، تأمين قدر كبير من منظومات الأسلحة ونشرها في شكل مجموعات للدفاع الجوي في أنحاء البلاد المختلفة، وفي المناطق الحساسة كالمنطقة الشرقية. لكن أنظمة التسليح تلك لم تكن قادرة على الاتصال بعضها ببعض. ولم يكن في وسع القائد في الرياض أن يحصل على صورة متكاملة للمجال الجوي للبلاد في كل وقت من الأوقات. كنا نحتاج إلى نظام للقيادة والسيطرة والاتصالات، يُرْمَزُ إليه بـ c3، يربط رادارات الإنذار المبكر والمدفعية والصواريخ بمركز سيطرة رئيسي.
اقتنعت السلطات بالسماح لي ببدء المفاوضات مع شركة ليتون litton، وهي شركة أمريكية كبيرة تخصصت في إنتاج مثل هذا النظام ( c3 ) وتم توقيع عقد معها قيمته 1.6 مليار من الدولارات في 8 إبريل عام 1979، بعد أكثر من عامين من الجهود المضنية. ونظراً إلى ضخامة المشروع وتعقده التقني تحدد يوم 7 فبراير عام 1985 موعداً لإتمامه وتسليمه صالحاً من وجهة النظر العملياتية، أي بعد فترة زمنية قدرها 70 شهراً أو ست سنوات إلا شهرين من توقيع العقد. شعرت بسعادة غامرة يوم توقيع العقد، كان إنجازاً باهراً. لكني لم أكن أدري وأنا أعيش تلك الفرحة الغامرة، أن إتمام هذا المشروع سيستغرق 14 عاماً وأنه سيكلفني عناءً كثيراً!
قائد الدفاع الجوي السابق ( الأمير خالد بن سلطان )
كنت في ميدان الرماية، الذي يبعد نحو 70 كيلو متراً عن مدينة جدّة، أشهد تدريباً على إطلاق صواريخ هوك عندما فُجِعت بنبأ وفاة الملك فيصل. كان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس 1975. انتقلت فوراً إلى المطار وتوجهت إلى الرياض. وعلمت، وأنا في الطائرة، أن الملك فيصل لم يمت ميتة طبيعية، بل قُتل بيد آثمة أطلقت عليه الرصاص. وراعَني أن الذي أطلق عليه الرصاص هو ابن عمي، الأمير فيصل بن مساعد، الذي أذكره منذ أيام الدراسة شاباً هادئاً خلوقاً، فكيف أقدم على مثل هذه الفعلة النكراء؟
بدأت الشائعات تتردد هنا وهناك، وبلغت حد القول أن الأمير فيصلاً عندما كان يدرس في بيروت ثم في جامعة كولورادو الأمريكية، أجرت له الاستخبارات الأمريكية عملية "غسل مخ" ليُقدم على قتل الملك فيصل. وتعزو الشائعات سبب ذلك إلى سياسة الملك فيصل الوطنية التي كانت مصدر قلق وضيق للسلطات الأمريكية، فقد ساند مصر وسوريا إبَّان حرب أكتوبر ، كما ساند الفلسطينيين في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي، وجعل الولايات المتحدة تستشيط غضباً جرَّاء حظر البترول الذي فرضه على الغرب.
غير أنه من الصعب الاقتناع بمثل هذا التوجه في تفسير الأحداث. ومن التفسيرات التي راجت أيضاً في بعض الأوساط، أن القاتل أقدم على فعلته حينما دخل إلى مكتب الملك فيصل، أثناء استقباله وزير البترول الكويتي، بدافع الثأر لأخيه خالد. وكان أخوه، خالد، متعصباً لرأيه دينياً، وكان قد قُتل قبل ذلك ببضع سنوات في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة، حين حاول، مع مجموعة من رفاقه المتعصبين، الهجوم على مركز البث التليفزيوني في الرياض، إذ كانوا يعدون هذا المركز مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ثم تحصّنوا في أحد البيوت القريبة من مبنى التليفزيون، وبادروا إلى إطلاق النار على الشرطة عندما حضرت لاستجلاء الأمر. كانت الأوامر الصادرة إلى قوة الشرطة تقضي بعدم الرد على النار بالمثل، لذلك فمن المرجح أن تكون الرصاصة التي قتلت خالداً قد أطلقها أحد رفاقه. وفي كل حال، فقد حوكم فيصل بن مساعد لاحقا، ونُفذ فيه حد القصاص.
لا شك أن مقتل الملك فيصل على يد أحد أفراد العائلة المالكة كان فاجعة أليمة، تأثرت بها العائلة بأسرها. وما زلت أذكر هذه الحادثة بشيء من الحرج، إذ حينما توجَّهنا لدفن الملك فيصل بعد وفاته بأربع وعشرين ساعة، في حضور الكثير من رؤساء الدول، الذين كان بينهم الرئيس أنور السادات، فغلبني الحزن ولم أستطع كبت مشاعري، فما كان من والدي إلاّ أن زجرني وطلب مني أن أتمالك نفسي. كان الملك فيصل يمثل لنا، نحن الأمراء الشبان في ذلك الوقت، شخصية مهيبة قوية، إذ كان قائداً ملهماً استطاع أن يفرض احترام العائلة والدولة على المجتمع الدولي. وترك فقده حزناً عميقاً في نفوسنا.
في ذلك الوقت الحرج والمحنة القاسية أسدى عمي، الأمير محمد، إلى العائلة معروفاً طوق به الأعناق. كان أكبر الأحياء سناً من أبناء الملك عبدالعزيز، ومن حقه تولي الحكم لو أراد. لكنه كان رجلاً متواضعاً، لم يطمح إلى حكم أو مُلك، فقد سبق أن تنازل عن ولاية العهد طواعية لشقيقه الذي يصغره سناً الأمير خالد. وقد أَرسَى بذلك سابقة مهمة مؤداها أن اختيار الملك يُبنى على السن والكفاءة معاً.
وكما تقضي التقاليد، اجتمعت العائلة بعد ساعة أو ساعتين من وفاة الملك فيصل لمبايعة الملك خالد الذي تعهد أن يحكم بهدي القرآن والسنة. كنت أقف في صف طويل أنتظر دوري لمبايعة الملك، حين رأيت الأمير محمداً يتقدم ويمسك يد الرجل الواقف أول الصف ويقول له: "أريدك أن تبايع أيضاً الأمير فهداً ولياً للعهد".
كان الأمير فهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وسيصبح تلقائياً ولياً للعهد. وكان إزاء المأساة التي حلت بالعائلة بعد وفاة الملك فيصل، يرغب في تأجيل تعيينه رسمياً. وقال معترضاً: "إن الوقت ليس مناسباً لذلك". لكن الأمير محمداً أصرّ على موقفه قائلاً: "كلاَّ.. هذا هو الوقت المناسب". وبتعيين الأمير فهد ولياً للعهد، يكون الأمير محمد قد تخطى اثنين من أخوته هما: الأمير ناصر والأمير سعد. وكانا أكبر سناً من الأمير فهد وأصغر من الملك خالد. فرض الأمير محمد اختياره على العائلة بصفته كبيرها، وتفادى بذلك أية خلافات قد تظهر في المستقبل. كما أرسَى تقليداً جديداً بطلبه البَيعة لولي العهد. فأصبح تقليداً رسمياً أن يُبَايَع الملك وولي العهد في الوقت نفسه. والذي لا شك فيه أن الموقف الذي اتخذه الأمير محمد، لكي يحقق انتقال السلطة في صورة سلسة، هو موقف عظيم يجب أن يذكر في حقه بالشكر والعرفان.
كان عقد السبعينات في المملكة هو عقد الإثارة والقلق، إثارة مردُّها إلى تلك القفزات المتتالية في أسعار النفط عامي 1973 و 1979. قفزات نقلتنا إلى مصافِّ أغنى الدول. ولا يحتاج المرء إلى العودة بذاكرته إلى الوراء كثيراً، ففي الخمسينات، عندما كنت طفلاً كنّا فقراء، وفجأة أصبح في مقدورنا أن نقتني أي شيء في العالم. أصبحت أحلامنا في التقدم والازدهار أمراً ممكناً. أقمنا في فترة قصيرة شبكات من الطرق الحديثة وأنظمة الهاتف المتقدمة. أنشأنا المطارات في كل ركن من أركان بلادنا المترامية الأطراف. امتلكنا أفخم السيارات وأقمنا أحدث المستشفيات والفنادق والجامعات. صممنا المباني العامة التي تبهر النظر على يد أشهر المعماريين في العالم.
ارتفع دخان المصانع بكل أنواعها حول ميناءي الجبيل على الخليج، وينبع على البحر الأحمر، اللذين صُمِّما وفق أحدث الطرز العالمية. فضلاً عن الكثير من المرافق التي انتشرت في كل مكان. تحول مستوى المعيشة في بلدنا، الذي كان متقشفاً في الأربعينات ومتواضعاً في الخمسينات، ومريحاً في الستينيات، إلى مستوى من الثراء والرفاهية يتحدث عن نفسه ولا تكاد تخطئه العين.
كان علينا، في الوقت نفسه، أن ننفق الأموال الطائلة من أجل تقوية دفاعاتنا، نظراً إلى التغيرات الجذرية التي تأثرت بها كل جوانب حياتنا. حدثت تلك التغيرات في حقبة تسودها الاضطرابات والقلق والتوجس. ففي بلدنا، كان فقدان الملك فيصل صدمة قاسية، إذ فقدنا بين عشية وضحاها قائداً سديد الرأي كنّا نُعوِّل عليه كثيراً. وفي المنطقة العربية كان اتجاه مصر نحو سلام منفرد مع إسرائيل سبباً في نشأة الصراعات داخل الصف العربي، مما جعل التوتر يخيم في سماء الأمة العربية. ولم يقتنع بمبادرة السادات، في ذلك الوقت إلا العدد القليل من أبناء المنطقة. لكن الأيام أثبتت، بعد مرور 15 عاماً، أن السادات كان مُحِقاً. فقد تجددت جهود السلام وأخذت تؤتي ثمارها، وإن كان الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة قد سبق السادات بعقد من الزمان في دعوته إلى السلام مع إسرائيل. كان الرئيس التونسي يحضُّ العرب على قبول ما تقدمه إسرائيل، ثم ممارسة الضغوط بعد ذلك للحصول على المزيد من التنازلات عندما تسنح الفرصة لذلك، كما فعل الصهاينة من قبل. لكن نداءه لم يجد لدى العرب آذاناً صاغية. واستمر الصراع العربي - الإسرائيلي المرير يزداد عنفاً وشراسة، تتخلله. الحروب الطاحنة بين الحين والآخر.
بلغ التوتر في المنطقة مداه، في السبعينات، عندما جاء تكتل ليكود اليميني، بزعامة مناحيم بيجن إلى سدّة الحكم في إسرائيل والليكود تكتل متشدد لا يتورَّع عن العدوان، ويسعى إلى إقامة إسرائيل الكبرى. لم يكن في وسعنا أن نغض الطرف عن نُذُر الحرب قرب حدودنا الشمالية الغربية. وكان سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، صدمة عنيفة أخرى جعلت الاضطراب يسود منطقة الخليج كلها. وزادت مخاوفنا على أمن المملكة. ولا يفوتني أن أذكر هنا أنه لم تكن ثمة مخاوف من إيران كدولة إسلامية، لكن التوجهات السياسية المتطرفة ومحاولات النظام الإيراني تصدير الثورة، كانت هي مبعث القلق.
وإن كنت، بحكم عملي العسكري، لم أدخل معترك السياسة، إلاّ أن وجودي في قيادة الدفاع الجوي، مع مسؤولياتي المتزايدة عن تأمين الأسلحة الجديدة، جعلاني أفكر دوماً في العدد المطرد من المدن الرئيسية والمصانع والمرافق التي تنبغي حمايتها من أي عدوان جوي محتمل. فلم يكن مستبعداً بأن تخترق طائرات معادية مجالنا الجوي بين لحظة وأخرى في هذا الجو المتوتر الذي يسود المنطقة.
كان شغلي الشاغل بناء نظام متكامل للدفاع الجوي يغطي مساحة المملكة بكاملها، وكان ذلك عملاً لا يكاد ينتهي. فالحاجة كانت ماسة إلى وحدات جديدة، للدفاع عما يستجد من أهداف حيوية كثيرة. وانحصر الأمر في وضع نظام من الأولويات، إلاّ أن تلك الأولويات لم تكن ثابتة، فالأهداف التي يحتمل تعرُّضها لهجوم جوي كثيرة تشمل العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى والمنشآت البترولية والمصافي ومحطات التحلية ومقر قيادة القوات المسلحة والقواعد الجوية والموانئ البحرية والصناعات الجديدة على الساحلين الشرقي والغربي. كان عليَّ أن أحدد الأهداف الحيوية ثـم أصنفها في ضوء احتمال تعرُّضها للهجوم. وكان هذا العمل يتطلب تخطيطاً وتنسيقًا وإدارة للموارد المتاحة. ويتطلب، فوق ذلك كله، تدريباً مكثفاً شاملاً على مختلف المستويات. ولَمّا كان هناك نقص شديد في الأيدي المدربة، فقد اعتبرت التدريب أهم من العتاد الذي نحصل عليه. ومن هنا، كان ضرورة التوسع المستمر في مدرسة الدفاع الجوي، التي أنشأتها شركة ريثيون في جدة عام 1962، إضافة إلى إرسال مئات من الشباب للتدرب في الخارج من أفراد وفنيين ومشغلين وإداريين ومهندسين وباحثين. فالتقدم في هذا المجال لا حدود له، وكنا على دراية تامة بأن الحرب الإلكترونية تتقدم يوماً بعد يوم. ويبدو ذلك الأمر جلياً بالنظر إلى التقدم في الأجهزة الإلكترونية، التي لا يكاد يخلو منها بيت في هذه الأيام.
فَرَضتْ المساحة الشاسعة للمملكة، الحاجة إلى أنظمة متداخلة متكاملة للدفاع الجوي، أنظمة بعيدة المدى وأخرى متوسطة المدى وثالثة قصيرة المدى، إضافة إلى الدفاع المحلي. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الدفاع الجوي لا يضمن الحماية الكاملة، إذ لا يمكن تأمين عدد كافٍ من الأنظمة يحقق الأمان التام. ألم ينجح مهربو المخدرات بطائراتهم الصغيرة في عبور الحدود المكسيكية - الأمريكية دون أن تكتشف أمرهم أجهزة الدفاع الجوي؟ ألم ينجح شاب ألماني، قبل بضع سنوات، في الوصول بطائرة صغيرة حتى قلب موسكو حيث هبط في الميدان الأحمر، جاعلاً من الدفاعات الجوية السوفيتية مهزلة مضحكة أدّت إلى إقالة قائدها؟
قبل التحاقي بالدفاع الجوي، كانت لدينا مدافع مضادة للطائرات من عيار 40 مم تُشغَّل يدوياً، وهي من أولى أنظمة المدفعية التي حصلت عليها قواتنا، ولا تزال تعمل حتى الآن. أضفنا بعد ذلك مدافع من أحدث الأنواع، بموجب عقدٍ تفاوضَ صالح المُحيَّا في شأنه منذ البداية، وهي مدافع أورليكون oerlikon القصيرة المدى من عيار 35 مم، التي تشتبك مع أهداف تحلق على ارتفاعات منخفضة. وتابعت العقد لاحقاً في محاولة لإخضاع كل عقود الدفاع الجوي لمعايير موحدة.
إن أهمية المدفعية المضادة للطائرات في معركة الدفاع الجوي، لا تقل عن أهمية الصواريخ. فعلى الرغم من أن قذيفة المدفع أسرع من الصاروخ، إلا أنها تختلف عنه من حيث المدى، فأقصى مدى لقذيفة المدفع هو 10 - 11 كم، أما مدى الصاروخ فيزيد على ذلك بخمسة أمثال. لكن دور المدفعية المضادة للطائرات يبرز عندما يخترق العدو الحدود ويبدأ التحليق الفعلي فوق الأهداف الحيوية. وربما لا يكون أمامك من خيار سوى استخدام المدفعية لدَرْء الخطر إذا شوَّش العدو على أنظمة الصواريخ باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، كما حدث للصواريخ العراقية في حرب الخليج. ولا يلزمك، في هذه الحالة، استخدام الرادار لإطلاق قذائف المدفعية، إذ يمكن استخدام العين المجردة، كما فعل العراقيون حين كانت مدافعهم التي نَصَبوها فوق المباني العالية تصيب طائرات التحالف. وكان معظم خسائر قوات التحالف في الطائرات بفعل المدفعية العراقية.
انتقلنا في مرحلة السبعينات، كما ذكرت، من صواريخ هوك الأساسي، وهو سلاح متوسط المدى، إلى صواريخ هوك المطوَّر، ثم انتقلنا في الثمانيات إلى نظام صواريخ هوك الثلاثي، نظراً إلى كثرة الأهداف المطلوب حمايتها. فحصلنا على ست سرايا منها، تتكون كل سرية من ثلاثة فصائل ضرب (fire units) ومجموعة من الرادارات ومركز قيادة سرية ومركز تنسيق المعلومات. وللمحافظة على الكفاءة القتالية لهذه السرايا، بعد نشْرها، كان لا بد من تنفيذ الصيانة الدورية والسنوية في أوقاتها المحددة والتدريب الشاق المتواصل لمنسوبيها، شأنها في ذلك شأن جميع وحدات الدفاع الجوي. وكنت أصرُّ على أن تتحرك السرايا بكامل معداتها من مواقعها إلى ميدان الرماية للتدريب على إطلاق الصواريخ. كنت أول من قرر الرماية الليلية للوحدات مع تبديل المواقع، الأمر الذي مكنني من إذكاء روح التنافس بين الوحدات وتحسين مستويات أدائها.
تخضع كل الأسلحة، التي نحصل عليها، للاختبار في شهر أغسطس للتثبت من صلاحيتها للعمل في جو المملكة، إذ تصل درجات الحرارة في هذا الشهر أعلى معدل لها. وقد أرسيتُ تقليداً يقضي بإخضاع كل مشروع جديد للتعاقد على شراء السلاح لمراجعة نصف سنوية تشمل التصنيع والصلاحية الفنية والتمويل والتدريب. وكانت تلك المراجعات التي تتم في المملكة وفي مقر الشركة المورِّدة بالتناوب، تسهم في حل ما يقرب من 90% من المشاكل التي كانت تواجهنا. كما تعطي كبار المسؤولين من الجانبين - المملكة والشركة - فرصة العمل على معالجة مشاكل التأخير في التنفيذ وقطع الغيار والتدريب.
علمتني خبرة الانتقال من نظام هوك الأساسي إلى نظام هوك المطوَّر، بكل ما انطوت عليه من مشاق، أن بعض المشاريع قد تستغرق سنوات قبل أن تؤتي ثمارها. كنت أتولى، بصفتي مديراً لقسم تخطيط ومشاريع الدفاع الجوي، اختيار الأنظمة الملائمة، وأعمل جاهداً على إقناع اللجان المختلفة والمستشارين الفنيين والقيادات العليا في القوات المسلحة بأهمية تلك الأنظمة. كان هدفي إنشاء شبكة للدفاع الجوي على درجة عالية من الكفاءة، مع تكاملها مع أنظمة القوات الجوية. كان ذلك هدفاً نذرت له جهدي لسنوات طويلة.
كنت أعكف على الدراسة والتحليل والمشاورة قبل أن أُقْدِم على التفاوض مع شركة أجنبية. كنت أبذل قصارى جهدي لاختيار أفضل الكفاءات للعمل معي، وأضع الرجل المناسب في الموقع المناسب. كنت أريد للدفاع الجوي أن يحظى بأفضل العناصر من بين الضباط العاملين الذين يُختارون على أساس الكفاءة والخبرة، ولا شيء غير ذلك. كنت أعرف أنني رئيس صارم يتوقع من مرؤوسيه الكثير، ومن ثَم فعليه أن يكون مثالاً يُحتذى. كنت أعود إلى بيتي محملاً بحقائب مكدسة بالأوراق التي لم يتسع وقت العمل لإنهائها. كنت آخذ نفسي بالشدة، فأُصِبْتُ بآلام في الظهر أجبرتني على العمل واقفاً أشهراً عدة. واسترعى انتباهي أن بعض الزملاء ممن كانوا يعملون معي قد عانوا مشاكل صحية بعينها. فعبدالله جستنيه أُصيب بقرحة في المعدة استدعت علاجه في أحد مستشفيات جدة، وزميل آخر، هو الرائد محمد عيد القرافي، وكان ساعدي الأيمن في مفاوضاتي مع الفرنسيين، تعرض لأزمة قلبية. كان مرد ذلك، بلا ريب، إلى ضغوط العمل.
تبلغ مساحة المملكة ما يزيد على 2.25 مليون كيلومتر مربع، مساحةٌ شاسعة على شكل مستطيل طوله 1700 كيلومتر وعرضه 1400 كيلومتر تقريباً، كأنها قارة كاملة. ونظراً إلى النقص في الطاقة البشرية، فإن الاعتماد على القوات البرية لحماية هذه المساحة الشاسعة، أمر غير معقول. ومن جانب آخر فهناك قيود على حجم قواتنا الجوية. وأعتقد أنَّ ثمة سقفاً أعلى فرضته الولايات المتحدة وأصدقاء إسرائيل داخل أمريكا، على عدد الطائرات المقاتلة التي يُسمح لنا بامتلاكها. ومعنى ذلك أن تظل قدراتنا الدفاعية محدودة دائماً وأضعف من أن تصل إلى مستوى القوة الجوية للدول المجاورة. وسبق أن ذكرت في الفصل السابع، كيف أن قدرة المصريين على استخدام صواريخ سام sam المتحركة ضد القوات الجوية الإسرائيلية وأثر ذلك في تغيير قواعد الحرب، أمرٌ أعجبني إلى حدٍّ بعيد. وخلصت إلى أن الحل يَكْمن في دفاع جوي قوي يمكن أن يؤمن قدراً معقولاً من الحماية إذا نُشر على أساس إستراتيجي متكامل وزُود بنظام إنذار مبكر.
في عام 1974، بدأت أنادي بفصل الدفاع الجوي، وكان لا يزال جزءاً من القوات البرية، واعتباره قوة مستقلة رابعة، أي أن يصبح قوة مستقلة عن القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وأن يُعطى الأولوية القصوى، لكنني واجهت معارضة قوية. ولا يفوتني أن أذكر أن مسألة القيادة والسيطرة على قوات الدفاع الجوي هو أمر يشغل فروع القوات المسلحة في كثير من بلدان العالم المختلفة.
ويُعزى الخلاف، في شأن تبعية الدفاع الجوي ضمن التسلسل القيادي للقوات، إلى مدرستين في الرأي. فالمدرسة الغربية، ترى أن اعتراض الطائرات المعادية هو مهمة القوات الجوية، وأنه يجب أن تكون قوات الدفاع الجوي تحت السيطرة العملياتية للقوات الجوية. أمّا المدرسة الشرقية - المعارضة - والتي ظهرت في الاتحاد السوفيتي السابق، فترى أن استخدام المصادر والمرافق والوسائل المختلفة كمحطات الإنذار المبكر ومحطات الرادارات الأرضية والطائرات الاعتراضية القصيرة المدى تقع كلها ضمن مهمة قوات الدفاع الجوي، وبالتالي فتجب السيطرة عليها بواسطة قيادة دفاع جوي مستقلة، بدلاً من تركها تحت قيادة القوات الجوية أو القوات البرية. ويعتمد الاختيار بين هاتين المدرستين على الإمكانات المتاحة كأعداد الطائرات والعقائد العسكرية السائدة في القوات المختلفة. وقد اختارت مصر بفعل تأثرها بالفكر العسكري السوفيتي، المدرسة الشرقية في ما يتعلق بهذا الموضوع. ولَمّا كنت معجباً باستخدام المصريين لصواريخ أرض - جو وبالأداء الرائع لقوات الدفاع الجوي المصرية أثناء عبور قناة السويس في حرب أكتوبر 1973 ، فقد بذلت محاولات لفصل دفاعنا الجوي عن القوات البرية وتعزيزه قوةً مستقلة.
كانت وجهة نظر المعارضين للفصل تستند إلى صغر حجم قوة الدفاع الجوي في ذلك الوقت. وكانوا يرون أن قوة قوامها 200 ضابط و1000 فرد لا يمكن أن تشكل قوة مستقلة. وكان للتوسع في منشآت الدفاع الجوي أثره في إضعاف تلك الحجة. كنت مقتنعاً تماماً بفكرتي، وتصديت للدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة. ولم أتوقف عن إثارتها في كل اجتماع ومنتدى سنحت لي الفرصة فيه. ولا شك أنني أثقلت على زملائي لكثرة ما جادلتهم في شأن تلكَ الفكرة.
بحلول عام 1976، أدركت أنني لم أحرز تقدماً يذكر في هذا الصدد، بل أدى إلحاحي إلى عكس ما اشتهيت، فبدلاً من تعزيز فكرتي وكسب مؤيدين لها، تكتلت الآراء المعارضة ضدها. لذلك، غيرتُ من خطتي وقررت اتباع أسلوب غير مباشر. وبدأت أسعى إلى تحقيق أهدافي على مراحل متدرجة وخطوة بعد خطوة. وقد آتي هذا الجهد ثماره حين صادقت القيادة العليا عام 1983 على فصل الدفاع الجوي عن القوات البرية، وأصبح مرتبطاً برئيس هيئة الأركان العامة، وتم تخصيص موازنة منفصلة له.
لكن ما أسرع ما أدركت أن الدفاع الجوي لن يثبت وجوده قوةً مستقلة، إلاّ إذا تحقق له التكامل الداخلي، وقبل كل شيء اتصالات على درجة عالية من الكفاءة بين أجزائه المختلفة. كان قد تحقق عند هذه المرحلة، من طريق برامج التسلح المختلفة، تأمين قدر كبير من منظومات الأسلحة ونشرها في شكل مجموعات للدفاع الجوي في أنحاء البلاد المختلفة، وفي المناطق الحساسة كالمنطقة الشرقية. لكن أنظمة التسليح تلك لم تكن قادرة على الاتصال بعضها ببعض. ولم يكن في وسع القائد في الرياض أن يحصل على صورة متكاملة للمجال الجوي للبلاد في كل وقت من الأوقات. كنا نحتاج إلى نظام للقيادة والسيطرة والاتصالات، يُرْمَزُ إليه بـ c3، يربط رادارات الإنذار المبكر والمدفعية والصواريخ بمركز سيطرة رئيسي.
اقتنعت السلطات بالسماح لي ببدء المفاوضات مع شركة ليتون litton، وهي شركة أمريكية كبيرة تخصصت في إنتاج مثل هذا النظام ( c3 ) وتم توقيع عقد معها قيمته 1.6 مليار من الدولارات في 8 إبريل عام 1979، بعد أكثر من عامين من الجهود المضنية. ونظراً إلى ضخامة المشروع وتعقده التقني تحدد يوم 7 فبراير عام 1985 موعداً لإتمامه وتسليمه صالحاً من وجهة النظر العملياتية، أي بعد فترة زمنية قدرها 70 شهراً أو ست سنوات إلا شهرين من توقيع العقد. شعرت بسعادة غامرة يوم توقيع العقد، كان إنجازاً باهراً. لكني لم أكن أدري وأنا أعيش تلك الفرحة الغامرة، أن إتمام هذا المشروع سيستغرق 14 عاماً وأنه سيكلفني عناءً كثيراً!