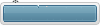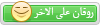"تقرير خاص" بمثابة بحث أكاديمي رائع ومدعم بالعشرات من المصادر الموثوقة والمحترمة، نشر في يونيو 2021م، وصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يحمل عنوان: "سياسة إيران الثورية تجاه إفريقيا".
مؤلفة التقرير أو البحث هي الباحثة الإيرانية المعروفة الدكتورة Banafsheh Keynoush "بنافشه كينوش" وهي مؤلفة كتاب "السعودية وإيران: أصدقاء أم أعداء" ذلك الكتاب الذي نشر في عام 2016.
التقرير الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يسلط الضوء على سياسة إيران الثورية تجاه قارة إفريقيا، ويشمل جميع الدول الإفريقية الـ 54 دولة،
تقول المؤلفة في بداية التقرير، لقد بنت إيران نفوذاً جزئياً في إفريقيا من خلال الدبلوماسية والسياسة والأمن والتبادلات البحرية والتجارية والثقافية. وكانت سياستها تاريخياً تجاه القارة مدفوعة بالنفعية والتطلعات لتصدير رؤيتها الثورية للعالم؛ ومع ذلك، اعتمادها من سياسة المحور الإفريقي كان أيضاً استجابة للحاجة إلى محاربة العقوبات والعزلة وبناء شراكات مع الجهات الحكومية ودون الحكومية وغير الحكومية في القارة. سياسة إيران تجاه إفريقيا أدت إلى مجموعة من السياسات البناءة والمسببة للانقسام.
الغرض من هذا التقرير هو للتحقيق في كيفية رؤية القارة لعلاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحديد التحديات التي تعيق العلاقات الإيرانية الأفريقية القوية.
إنها أول دراسة شاملة للعلاقات الثنائية بين إيران والدول الإفريقية الأربع والخمسين، والمبادرات السياسية الإيرانية الرئيسية في إفريقيا - في المجالات الدبلوماسية والسياسية والأمنية والبحرية والاقتصادية والثقافية. إنها تتويجاً لبحوث تستند إلى مصادر أولية في إيران، ويؤيدها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كجزء من سلسلة مشاريع أكبر حول إفريقيا.
يفحص التقرير مراحل متعددة من سياسة إيران تجاه إفريقيا منذ الثورة الإسلامية عام 1979 إلى الوقت الحاضر ويقدم تفاصيل عن إيران الثقافية والدينية والعلمية والتكنولوجية الأنشطة في إفريقيا - والتي تشمل المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك مؤسسة مستضعفين Bonyad-e Mostazafan، ومؤسسة جهاد سازندگی Jihade-Sazandegi (بالعربية مؤسسة جهاد البناء)، ومؤسسة دانش بنيان Danesh Bonyan، وجمعية الهلال الأحمر الإيراني، ومؤسسة الإمام الخميني للإغاثة، ولجنة جمعية أهل البيت العالمية وفروع جامعة المصطفى.
والتقرير يفحص العمليات الاقتصادية والتجارية لإيران في إفريقيا، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والأعمال المصرفية، والتأمين، والنقل، وأنشطة الموانئ. مصالح إيران الاستراتيجية والمناورات الجيوسياسية في أفريقيا، بما في ذلك ما يخص قضية الإرهاب، سيتم استكشافها في التقرير بإسهاب.
العمليات الأمنية الرئيسية للجمهورية الإيرانية تقودها إستراتيجية دفاعية واقعية لإظهار القوة، وتشمل قوة بحرية بلا حدود، ومهام المياه الزرقاء، وإستراتيجية طويلة الذراع بعيدة للدفاع. تقدم مجموعة من الجهات الفاعلة هذه العمليات، بما في ذلك فيلق الحرس الثوري الإسلامي، والبحرية الإيرانية، والهندسة البحرية للدفاع الاستباقي للجيش الإيراني، والأسطول البحري للحرس الثوري الإسلامي، وفيلق القدس.
في المشاركة القادمة سأضع لكم الجزء الخاص عن جمهورية مصر العربية.
جمهورية مصر العربية:
أدت إدانة إيران لاتفاقيات كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1978م واستضافة مصر لشاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي بعد الثورة الإيرانية إلى زيادة التوترات بين القاهرة وطهران، ثم لاحقاً أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية عام 1980م. على أمل استبدال النفوذ المصري في العالم العربي، إيران وجهت اللوم للقاهرة علناً بسبب سياستها الخارجية، ودعمت الجماعات الفلسطينية المعارضة لاتفاقية كامب ديفيد، وكرمت الجماعات الإسلامية المسؤولة عن مقتل الرئيس المصري محمد أنور السادات في عام 1981م، وسميت أحد شوارع طهران باسم خالد الإسلامبولي الذي نفذ عملية الاغتيال.
في السنوات التالية، رأت طهران في التوترات في علاقاتها مع القاهرة امتداداً لمشاكل أكبر في الممر المائي للخليج بين إيران وجيرانها العرب، ورغبة مصر في التأثير على المنطقة. انتقدت مصر محاولات إيران لتثمين وتصدير ثورتها. على وجه التحديد، واعتقدت مصر أن إيران روجت للشيعة ودعمت الخلايا الشيعية في مصر، وكانت مسؤولة عن إنشاء أول جماعة شيعية رئيسية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ونتيجة لذلك، وسعت مصر علاقاتها مع دول الخليج العربية لتقويض نفوذ إيران الإقليمي ودعمت بغداد خلال الحرب الإيرانية العراقية، حيث ورد أنها أرسلت 18000 مصري لقتال الإيرانيين. علاوة على ذلك، شجعت مصر سياسات الضغط على إيران لقبول وقف إطلاق النار في عام 1986م، حيث اعترضت إسرائيل شحنات أسلحة من مصر إلى غزة، يُعتقد أنها قادمة من إيران.
في أعقاب الحرب، أعادت إيران أسرى الحرب المصريين إلى القاهرة، في محاولة لتخفيف التوترات. في السنوات اللاحقة، وسعت القاهرة وطهران روابطهما الثقافية نحو تقارب محتمل. استثمرت إيران في قطاعي النسيج والصناعة المصريين، وعرضت القاهرة على إيران المنتجات الغذائية ومواد البناء والمنتجات الكيماوية والمعادن والخدمات الهندسية. بحلول عام 2001م، بلغ حجم التجارة بين مصر وإيران حوالي 200 مليون دولار أمريكي. وسعت الدولتان تدريجياً الاتصالات من خلال منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المبادرات بين الجنوب والجنوب، وتبنتا مواقف مشتركة بشأن نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأعربا عن قلقهما بشأن توطيد العلاقات التركية الإسرائيلية، وتوصلتا إلى تفاهم حول الحاجة إلى الحفاظ على علاقات بناءة مع الفلسطينيين حيث قبلت إيران تدريجياً دور مصر المتفوق في العملية.
بعد الحادي عشر من سبتمبر، ألقت إيران القبض على متمردين مصريين عبروا حدودها من أفغانستان وانضموا إلى القاعدة هناك ووعدت بمقاضاتهم على الرغم من مطالبة القاهرة إيران بتسليم المواطنين المصريين. واصلت القاهرة وطهران مستوى من التعاون بشأن القضايا الإقليمية لنزع فتيل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط بعد الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003م. وفي عام 2008م، مع توسيع إيران لعمليات مكافحة القرصنة، كانت تأمل في قيادة مهام مشتركة لمكافحة الإرهاب. مع القاهرة في البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، سعت طهران إلى طرق بديلة لتصدير نفطها عبر قناة السويس بموافقة السلطات المصرية.
سعت إيران لاحقاً إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر وتصدير الغاز إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. في عام 2011م، أصر الخبراء السياسيون في طهران على أن الدول الأفريقية التي تواجه انتفاضات في أعقاب الربيع العربي (بما في ذلك مصر) يجب أن تبني السلام الداخلي من خلال تبني العلاقات مع إيران، ورفض العلاقات مع إسرائيل، وتجنب العلاقات الوثيقة مع القوى الغربية الكبرى، ودعم الحركات الإسلامية. لكن على الرغم من الافتتاح القصير مع القاهرة بعد رئاسة محمد مرسي في عامي 2012-2013 وزيارة الرئيس أحمدي نجاد للقاهرة والتي تعرض خلالها لهجوم بقذفه بالحذاء، فشلت طهران في كسر الجمود في علاقاتها مع مصر. كان الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المصريين حريصين على استكشاف العلاقات مع طهران لوضع مصر بشكل أفضل في العالم الإسلامي مع الحفاظ على مسافة صحية من طهران، بالنظر إلى خيبة الأمل المصرية من النموذج الثوري الإيراني. وإدراكاً منهم أن دعوات إيران لتوثيق العلاقات في أعقاب الثورات العربية لم تلق آذاناً صاغية، جادل النقاد الإيرانيون بأن الانتفاضات المصرية كانت نوعاً من ثورة ما قبل النضج والتي قد تستغرق وقتاً لتنضج لتصبح ثورة كاملة في وقت لاحق.
على الرغم من التحديات في علاقاتهم، واصلت إيران النظر إلى مصر كقوة موازنة في إفريقيا، بالنظر إلى أن القاهرة كانت قادرة على بناء علاقات مع كل من الحلفاء الإيرانيين في سوريا والعراق ومع دول الخليج العربية التي كانت حريصة على احتواء القوة الإيرانية. ونتيجة لذلك، استكشفت طهران فرصاً للانخراط في جهد للحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر مع النظر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية على أنها نقطة ساخنة رئيسية للإرهاب تتطلب مراقبة إيران لمكافحة الإرهاب في السنوات القادمة. لكن مصر ظلت بعيدة جدًا عن إيران، نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، وانضمت إلى مبادرة القرن الأفريقي مع المملكة العربية السعودية لبناء تحالف أمني في البحر الأحمر والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC) بقيادة السعودية.
بحلول عام 2018م، كانت مصر أكبر شريك تجاري لإيران في شمال إفريقيا. وظل حجم التجارة عند حوالي 220 مليون دولار أمريكي، مقارنة بإجمالي تجارة إيران مع شمال إفريقيا، والتي بلغت 312 مليون دولار أمريكي. احتفظت إيران بنفوذها الثقافي في مصر، حيث ظلت اللغة الفارسية شائعة كمجال أكاديمي للدراسة في أكثر من اثنتي عشرة جامعة على الأقل. ومع ذلك، شكلت التجارة مع مصر 0.36 في المائة فقط من الصادرات الإيرانية، ولم تكن هناك ضمانات أخرى بأن التجارة يمكن أن تتوسع في ظل نظام عقوبات مشدد ضد إيران.
عدد الشيعة في مصر، المقدر بما يزيد قليلاً عن 650 ألف مواطن مصري شيعي، مكّن السكان من أداء الاحتفالات الدينية الشيعية وتدريب العلماء المسلمين الذين أثروا في العالم العربي. وفقًا لبعض المصادر، لعبت شبكات الأقمار الصناعية دوراً مهماً في زيادة التحول إلى الإسلام الشيعي في مصر. استمرت الثورة الإيرانية وموقف حزب الله من إسرائيل ودعم غزة في جذب المتعاطفين عبر مصر. أدار الشيعة المصريون جمعيات وحاولوا تأسيس حزب الوحدة والحرية بعد الثورات العربية عام 2011م للتواصل مع القوى السياسية الصاعدة الأخرى داخل مصر وخوض الانتخابات في المستقبل. يعتقد علماء الدين الإيرانيون أن الشيعة المصريين كانوا في الأساس من الطائفة الإثنا عشرية مثل المذهب الشيعي المهيمن داخل إيران. على مر السنين، حاول الأزهر سد الفجوة بين الشيعة والسنة من خلال الاعتراف بالممارسة الشيعية كمدرسة للإسلام. ومع ذلك، لم يتحد رجال الدين المصريون بشأن هذا الموضوع. واصلت مصر بناء آليات لتشمل سكانها الشيعة، لكن الإيرانيين اعتقدوا أن بعض الشيعة المصريين مارسوا التقية لإخفاء هوياتهم.
في السنوات الأخيرة، أجرت مصر وإيران محادثات للترويج للأنشطة الثقافية والسياحية بين البلدين وأبرمتا مذكرة تفاهم حول هذا الموضوع. وفي وقت لاحق، أرسلت إيران ملحقاً ثقافياً إلى القاهرة. على الرغم من أن الخلافات السياسية بين القاهرة وطهران قد أعاقت توسع الأنشطة الثقافية، إلا أن إيران ظلت تأمل في أن يؤدي تغيير الإدارة في المنظمات الثقافية المصرية في النهاية إلى الانفتاح مع طهران. وشاركت مصر وإيران في مسابقات تلاوة القرآن بين البلدين، وعقد البلدان محادثات لتوسيع العمل المشترك في الجوانب الفنية والمتخصصة للدراسات القرآنية واستضافتا إقامة مدارس قرآنية مشتركة. اعتقدت إيران أن خبراء الدراسات القرآنية في مصر يمكن أن يساعدوا في الترويج لرسالة الثورة الإيرانية في شمال إفريقيا والعالم العربي.
المصدر:
التعديل الأخير: