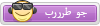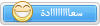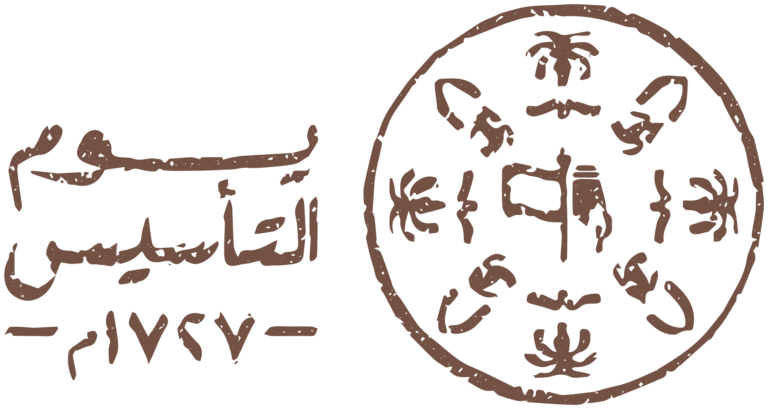🚩خليل آغا بولوكباشي … أول آغوات الإيالة العسكرية الجزائرية🚩
في صيف عام 1659، ثار أهالي مدينة الجزائر، بدعم من الرياس و ديوان الانكشارية، ضد نظام الباشاوات العثماني القائم في الإيالة الذي عوض نظام البكلرباي الذي كانت له سلطات واسعة جدا. حيث تم نزع السلطة التنفيذية من الباشا إبراهيم الذي أودع السجن، وأُسندت إلى الآغا بصفته رئيس الإنكشارية، فأصبح لقب “الباشا” شرفيًا فقط، بينما صار الآغا الحاكم الفعلي. وحدِّدت مدة رئاسته بسنتين كحد أقصى، مع تقييد صلاحياته وإخضاعه لرقابة الديوان، بما يشبه نظام حكم جماعي قريب من المجالس الجمهورية، دون توريث أو احتكار للسلطة. لاحقًا، سعت الحكومة الجزائرية إلى نيل تصديق الباب العالي على النظام الجديد، فوافقت إسطنبول بشرط تحمّل الجزائر نفقات المرتبات والقضاء والوظائف، وهو ما أدى عمليًا إلى استقلال واسع على قول المؤرخ عبد الرحمن الجيلالي، مع بقاء الارتباط الاسمي بالسلطنة.
يقول ابن المفتي:
«وسأروي الأسباب التي أدت إلى نزع حق دفع العلوفات من الباشالار: وهي أنهم ماداموا يتولونها فإنهم ينتفعون باختلاس الأموال المجلوبة من القصر من جهات مختلفة، وفي ذلك العهد تعاقب هؤلاء على الحكم في ولايات متقاربة، وكان أهل الجزائر ضحية لشرههم حتى أنهم أحيانا كانوا يُغرمون العلماء وعدول المحكمة بدفع مبلغ معين.
وتبين جنودنا - المنصورون بعون الله - هذا، واعتزموا أن ينزعوا من الباشوات حق دفع العلوفات وكذلك جباية الضرائب وتنظيم النفقات وهذا بشكل كامل. وكلّف الجنود بذلك واحدا هو أوّل من عُقد له هذا الأمر وهو خليل..»
كان محرّك الانقلاب على نظام الباشاوات، خليل بولوكباشي (و هو لقب رتبة ضابط فرقة انكشارية)، أحد أبرز أعضاء الديوان ومن أكبرهم نفوذًا؛ وتعود أصوله إلى إحدى القبائل التركمانية (يوروكان) التي تعيش على الترحال في “برّ الترك” (الأناضول). وقد أُسندت إليه المهام المذكورة آنفًا بشكل رسمي في شهر ذي القعدة سنة 1070 هـ / جويلية 1660م، وحمل خليل للدلالة على منصبه الرفيع فقط لقب الآغا. كما عيّن الديوان لتصريف شؤون الحكم هيئة ذات سلطات استشارية وتنفيذية يرأسها الحاكم الجديد، مكوّنة من أربعة وعشرين معزول آغا، ويُرجّح أنها حلّت محل “الديوان الخاص” الذي لم يعد قائمًا في شكله المعهود بعد تغيير النظام. ولتفادي أخطاء الإدارة السابقة، وُضعت هذه الحكومة الجديدة تحت رقابة أعضاء الديوان العام.
استهل خليل آغا حكمه باتخاذ تدابير من شأنها تنظيم مالية الدولة، إلى جانب توفير موارد إضافية للخزينة، حيث قام بناءً على التماسات ممثلي التجار المحليين والأجانب بإلغاء جميع الغرامات المجحفة التي كان يفرضها الباشوات عليهم. وأكثر من ذلك، قام بتخفيض نسب التعريفات الجمركية في سعيه لتفعيل حركة التجارة. كما أولى عناية خاصة لمسألة الجباية، وتجلّى ذلك في المتابعة الصارمة التي فُرضت على الملتزمين، وفي قيامه باستبدال عدد من القواد المشكوك في نزاهتهم بآخرين من صف الأغوات المعزولين.
واستطاع خليل بفضل حسن تدبيره من دفع جرايات الجند الإنكشاري كاملة وفي وقتها المحدد، بل وحصل فائضًا أودع في الخزينة؛ وهذا ما جعل الإنكشارية تحترمه وتنظر إليه بعين الرضى، حتى أنها درجت على تلقيبه “بابا خليل”.
وكان فاتحة اعماله كذلك تأسيس الجامع الجديد القائم بساحة الشهداء بالعاصمة الباذخ بقبته العظيمة ومناره الشامخ، بناه المهندس الحاج الحبيب، وبه كان مقر ديوان الافتاء الحنفي طوال مدة العهد العثماني واستمر كذلك ايام الاستعمار مع الحد من نفوذ المفتي - الى يوم استقلال الجزائر، فحذف منصب الافتاء من كلا المذهبين الملكي والحنفي بكامل القطر الجزائري وعوض عنه بأحداث المجلس الاسلامي الاعلى الذي جعل تحت اشراف وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
لكن من جانب الباب العالي، ساءت العلاقات للغاية؛ إذ حالما وصل علي باشا إلى إزمير، كتب تقريرًا بما تعرض له من الانكشارية الذين رفضوا ولايته، وطلب الإذن من قاضيها بشأن إعلام إسطنبول بذلك. أثار ذلك غضب الصدر الأعظم كوبريلي محمد باشا، مما عدّه انقلابًا في الجزائر، وخروجًا عن طاعة السلطان؛ وبسبب غضبه الشديد استدعى علي، وأمر بإعدامه.
وفي أثناء ذلك، كان الديوان قد أرسل وفدًا محمّلًا بالهدايا إلى الباب العالي، من أجل طلب والٍ جديد، لكن الصدر الأعظم رفض استقباله، وقام بإرسال فرمان إلى الجزائريين ينذرهم فيه:
“أخبركم أن لن نرسل إليكم واليًا، بايعوا من تريدون، والسلطان ليس بحاجة إلى عبوديتكم. لدينا آلاف الممالك مثل الجزائر، فالجزائر إن كانت وإن لم تكن شيء واحد، ومن بعد ذلك إن اقتربتم من الممالك العثمانية فلن تكونوا راضين”.
وبالموازاة، أرسل فرمانًا آخر إلى الموانئ في جميع السواحل العثمانية، وإلى والي مصر وشريف مكة، يأمر فيه بمنع الجزائريين من الذهاب إلى الحج، وحظر بيع السلاح لهم، وعدم السماح لهم بالاقتراب من السواحل العثمانية؛ مما عنى تعطّل حركة الحج والتجارة إلى المشرق، مع ما قد يسببه كل ذلك من استياء رجال الدين والأهالي، فضلًا عن توقف عمليات تجنيد الإنكشارية الحيوية لاستمرار الأوجاق.
وقع الجزائريون في حيرة من أمرهم، فقد أظهرت تلك القرارات غير المتوقعة حاكمهم الجديد خليل آغا بمظهر المتمرّد على السلطان؛ وذلك في حين ظل وفدهم قرابة عام كامل في إزمير، دون أن يُسمح له بمقابلة الصدر الأعظم، وكمخرج مؤقت للمأزق، عمد الآغا والديوان إلى إخراج إبراهيم باشا من السجن، وأعادوه إلى منصبه بشرط أن لا يتدخل في أمور السياسة مطلقًا.
وعلى الصعيد الأوروبي، سمّمت مشكلة الأسرى الجزائريين الذين اختطفهم وكيل الباستيون (المركز التجاري الفرنسي بالقالة) في أكتوبر 1658م العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ناهيك عن النية السيئة التي أبداها الملك لويس الرابع عشر، وتجسدت في تزايد التحركات العدائية ضد الجزائر ورعاياها. أما بخصوص إنكلترا، فإن تمويه أعلام السفن لصالح دول أجنبية، الذي مارسته إدارة حاكمها أوليفر كرومويل (Oliver Cromwell) على نطاق واسع، أثار سخط الجزائريين وهدد بحدوث قطيعة بين البلدين، مثلما كان الحال بالنسبة لجمهورية هولندا، التي كانت في حالة حرب مع الجزائر منذ حملة الأميرال دي رويتر (de Ruyter) في 1655م.
ولم تكن الأحوال على الصعيد الداخلي بأحسن منها على الصعيد الخارجي؛ فقد تميزت خاصة بتجدد الاضطرابات بشرق البلاد، حيث تواصل عصيان أمير كوكو أحمد بوختوش، كما تمردت العديد من القبائل ببايلك قسنطينة، وامتنعت عن دفع الضرائب.
بالرغم من كل تلك المتاعب، تمكن خليل آغا بفضل إدارته المالية الحسنة من جعل الديوان يجدد عهده عامًا آخر، غير أنه تعرض لاغتيال في الأيام الأخيرة من محرم 1071هـ الموافق لبداية أكتوبر 1660م. ويذكر صاحب “مرآة الصدقة المسيحية” بهذا الصدد أن الحاكم “قُتل مع نهاية الصيف في زقاق بمدينة الجزائر على يد قاتلين وُضعا ليرصداه من طرف بعض الكبراء في الدولة، الذي استصدر أمرًا مجحفًا في حقهم باسم الديوان”
🔹أمين محرز، أوجاق الإنكشارية بايالة الجزائر في عهد الدايات، ص100-103
🔹عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ص157-158
🔹ابن المفتي، تاريخ باشاوات الجزائر، ص64
#صفحة_إيالة_الجزاير
في صيف عام 1659، ثار أهالي مدينة الجزائر، بدعم من الرياس و ديوان الانكشارية، ضد نظام الباشاوات العثماني القائم في الإيالة الذي عوض نظام البكلرباي الذي كانت له سلطات واسعة جدا. حيث تم نزع السلطة التنفيذية من الباشا إبراهيم الذي أودع السجن، وأُسندت إلى الآغا بصفته رئيس الإنكشارية، فأصبح لقب “الباشا” شرفيًا فقط، بينما صار الآغا الحاكم الفعلي. وحدِّدت مدة رئاسته بسنتين كحد أقصى، مع تقييد صلاحياته وإخضاعه لرقابة الديوان، بما يشبه نظام حكم جماعي قريب من المجالس الجمهورية، دون توريث أو احتكار للسلطة. لاحقًا، سعت الحكومة الجزائرية إلى نيل تصديق الباب العالي على النظام الجديد، فوافقت إسطنبول بشرط تحمّل الجزائر نفقات المرتبات والقضاء والوظائف، وهو ما أدى عمليًا إلى استقلال واسع على قول المؤرخ عبد الرحمن الجيلالي، مع بقاء الارتباط الاسمي بالسلطنة.
يقول ابن المفتي:
«وسأروي الأسباب التي أدت إلى نزع حق دفع العلوفات من الباشالار: وهي أنهم ماداموا يتولونها فإنهم ينتفعون باختلاس الأموال المجلوبة من القصر من جهات مختلفة، وفي ذلك العهد تعاقب هؤلاء على الحكم في ولايات متقاربة، وكان أهل الجزائر ضحية لشرههم حتى أنهم أحيانا كانوا يُغرمون العلماء وعدول المحكمة بدفع مبلغ معين.
وتبين جنودنا - المنصورون بعون الله - هذا، واعتزموا أن ينزعوا من الباشوات حق دفع العلوفات وكذلك جباية الضرائب وتنظيم النفقات وهذا بشكل كامل. وكلّف الجنود بذلك واحدا هو أوّل من عُقد له هذا الأمر وهو خليل..»
كان محرّك الانقلاب على نظام الباشاوات، خليل بولوكباشي (و هو لقب رتبة ضابط فرقة انكشارية)، أحد أبرز أعضاء الديوان ومن أكبرهم نفوذًا؛ وتعود أصوله إلى إحدى القبائل التركمانية (يوروكان) التي تعيش على الترحال في “برّ الترك” (الأناضول). وقد أُسندت إليه المهام المذكورة آنفًا بشكل رسمي في شهر ذي القعدة سنة 1070 هـ / جويلية 1660م، وحمل خليل للدلالة على منصبه الرفيع فقط لقب الآغا. كما عيّن الديوان لتصريف شؤون الحكم هيئة ذات سلطات استشارية وتنفيذية يرأسها الحاكم الجديد، مكوّنة من أربعة وعشرين معزول آغا، ويُرجّح أنها حلّت محل “الديوان الخاص” الذي لم يعد قائمًا في شكله المعهود بعد تغيير النظام. ولتفادي أخطاء الإدارة السابقة، وُضعت هذه الحكومة الجديدة تحت رقابة أعضاء الديوان العام.
استهل خليل آغا حكمه باتخاذ تدابير من شأنها تنظيم مالية الدولة، إلى جانب توفير موارد إضافية للخزينة، حيث قام بناءً على التماسات ممثلي التجار المحليين والأجانب بإلغاء جميع الغرامات المجحفة التي كان يفرضها الباشوات عليهم. وأكثر من ذلك، قام بتخفيض نسب التعريفات الجمركية في سعيه لتفعيل حركة التجارة. كما أولى عناية خاصة لمسألة الجباية، وتجلّى ذلك في المتابعة الصارمة التي فُرضت على الملتزمين، وفي قيامه باستبدال عدد من القواد المشكوك في نزاهتهم بآخرين من صف الأغوات المعزولين.
واستطاع خليل بفضل حسن تدبيره من دفع جرايات الجند الإنكشاري كاملة وفي وقتها المحدد، بل وحصل فائضًا أودع في الخزينة؛ وهذا ما جعل الإنكشارية تحترمه وتنظر إليه بعين الرضى، حتى أنها درجت على تلقيبه “بابا خليل”.
وكان فاتحة اعماله كذلك تأسيس الجامع الجديد القائم بساحة الشهداء بالعاصمة الباذخ بقبته العظيمة ومناره الشامخ، بناه المهندس الحاج الحبيب، وبه كان مقر ديوان الافتاء الحنفي طوال مدة العهد العثماني واستمر كذلك ايام الاستعمار مع الحد من نفوذ المفتي - الى يوم استقلال الجزائر، فحذف منصب الافتاء من كلا المذهبين الملكي والحنفي بكامل القطر الجزائري وعوض عنه بأحداث المجلس الاسلامي الاعلى الذي جعل تحت اشراف وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
لكن من جانب الباب العالي، ساءت العلاقات للغاية؛ إذ حالما وصل علي باشا إلى إزمير، كتب تقريرًا بما تعرض له من الانكشارية الذين رفضوا ولايته، وطلب الإذن من قاضيها بشأن إعلام إسطنبول بذلك. أثار ذلك غضب الصدر الأعظم كوبريلي محمد باشا، مما عدّه انقلابًا في الجزائر، وخروجًا عن طاعة السلطان؛ وبسبب غضبه الشديد استدعى علي، وأمر بإعدامه.
وفي أثناء ذلك، كان الديوان قد أرسل وفدًا محمّلًا بالهدايا إلى الباب العالي، من أجل طلب والٍ جديد، لكن الصدر الأعظم رفض استقباله، وقام بإرسال فرمان إلى الجزائريين ينذرهم فيه:
“أخبركم أن لن نرسل إليكم واليًا، بايعوا من تريدون، والسلطان ليس بحاجة إلى عبوديتكم. لدينا آلاف الممالك مثل الجزائر، فالجزائر إن كانت وإن لم تكن شيء واحد، ومن بعد ذلك إن اقتربتم من الممالك العثمانية فلن تكونوا راضين”.
وبالموازاة، أرسل فرمانًا آخر إلى الموانئ في جميع السواحل العثمانية، وإلى والي مصر وشريف مكة، يأمر فيه بمنع الجزائريين من الذهاب إلى الحج، وحظر بيع السلاح لهم، وعدم السماح لهم بالاقتراب من السواحل العثمانية؛ مما عنى تعطّل حركة الحج والتجارة إلى المشرق، مع ما قد يسببه كل ذلك من استياء رجال الدين والأهالي، فضلًا عن توقف عمليات تجنيد الإنكشارية الحيوية لاستمرار الأوجاق.
وقع الجزائريون في حيرة من أمرهم، فقد أظهرت تلك القرارات غير المتوقعة حاكمهم الجديد خليل آغا بمظهر المتمرّد على السلطان؛ وذلك في حين ظل وفدهم قرابة عام كامل في إزمير، دون أن يُسمح له بمقابلة الصدر الأعظم، وكمخرج مؤقت للمأزق، عمد الآغا والديوان إلى إخراج إبراهيم باشا من السجن، وأعادوه إلى منصبه بشرط أن لا يتدخل في أمور السياسة مطلقًا.
وعلى الصعيد الأوروبي، سمّمت مشكلة الأسرى الجزائريين الذين اختطفهم وكيل الباستيون (المركز التجاري الفرنسي بالقالة) في أكتوبر 1658م العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ناهيك عن النية السيئة التي أبداها الملك لويس الرابع عشر، وتجسدت في تزايد التحركات العدائية ضد الجزائر ورعاياها. أما بخصوص إنكلترا، فإن تمويه أعلام السفن لصالح دول أجنبية، الذي مارسته إدارة حاكمها أوليفر كرومويل (Oliver Cromwell) على نطاق واسع، أثار سخط الجزائريين وهدد بحدوث قطيعة بين البلدين، مثلما كان الحال بالنسبة لجمهورية هولندا، التي كانت في حالة حرب مع الجزائر منذ حملة الأميرال دي رويتر (de Ruyter) في 1655م.
ولم تكن الأحوال على الصعيد الداخلي بأحسن منها على الصعيد الخارجي؛ فقد تميزت خاصة بتجدد الاضطرابات بشرق البلاد، حيث تواصل عصيان أمير كوكو أحمد بوختوش، كما تمردت العديد من القبائل ببايلك قسنطينة، وامتنعت عن دفع الضرائب.
بالرغم من كل تلك المتاعب، تمكن خليل آغا بفضل إدارته المالية الحسنة من جعل الديوان يجدد عهده عامًا آخر، غير أنه تعرض لاغتيال في الأيام الأخيرة من محرم 1071هـ الموافق لبداية أكتوبر 1660م. ويذكر صاحب “مرآة الصدقة المسيحية” بهذا الصدد أن الحاكم “قُتل مع نهاية الصيف في زقاق بمدينة الجزائر على يد قاتلين وُضعا ليرصداه من طرف بعض الكبراء في الدولة، الذي استصدر أمرًا مجحفًا في حقهم باسم الديوان”
🔹أمين محرز، أوجاق الإنكشارية بايالة الجزائر في عهد الدايات، ص100-103
🔹عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ص157-158
🔹ابن المفتي، تاريخ باشاوات الجزائر، ص64
#صفحة_إيالة_الجزاير