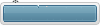كانت الحرب في السودان حين اندلعت في ربيع 2023 أشبه ببابٍ فُتح على جحيم، لا على معركة. لم يكن أحد يتوقع أن الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيتحوّل في أيام قليلة إلى دوامة هائلة من العنف والانهيار. وطوال ذلك الوقت، كانت مصر تراقب المشهد بقلقٍ لا تخطئه العين، لأن السودان بالنسبة إليها ليس مجرد جار، بل امتداد جغرافي وروحي وتاريخي وأمني. وحين يتصدع السودان، تشعر القاهرة بالزلزال قبل أن تهتز الأرض فعلًا.
منذ اللحظة الأولى، أدركت مصر أن النار التي اشتعلت في الخرطوم ليست شأنًا داخليًا بسيطًا، وأن الصراع ليس بين جنرالين فقط، بل بين رؤيتين لمستقبل السودان، وبين قوى خارجية تحاول كل واحدة منها أن تجد موطئ قدم في بلدٍ يملك موقعًا ومقدّرات تجذب الأنظار. وفي الوقت نفسه كانت الإمارات، الصديق الاقتصادي الأقرب للقاهرة، تُتهم بأنها تمد الدعم السريع بالسلاح والمال، بينما تُتهم هذه القوات بارتكاب فظائع ضد مدنيين في دارفور ومناطق أخرى. كان المشهد معقدًا إلى درجة أن القاهرة وجدت نفسها في لحظة تحتاج فيها إلى السير على حافة السكين: لا تريد استعداء الإمارات، ولا يمكنها أن تتخلى عن السودان، ولا تستطيع أن تسمح لقوة مسلحة غير نظامية بأن تفرض واقعًا يهدد وحدته.
في الشارع المصري، وفي دهاليز السياسة، كان السؤال يتردد همسًا: كيف يمكن للقاهرة أن تدعم الجيش السوداني وهي ترى أن صديقها الاقتصادي الأكبر يتحرك في الاتجاه المعاكس؟ لكنه سؤال لا يُسأل بصوتٍ مرتفع، لأن العلاقات بين مصر والإمارات أكبر وأعمق من أن تختزل في لحظة خلاف حول ساحة صراع، ولأن الدول تتعامل مع مصالحها بميزان الذهب. ومع ذلك، كان السودان بالنسبة لمصر ملفًا مختلفًا، لا يُدار فقط بمنطق العلاقات الخارجية، بل بمنطق الأمن القومي المباشر. النيل يمر هناك. الحدود الطويلة تمتد هناك. وانهيار السودان يعني فتح بوابة لا يمكن إغلاقها بسهولة: موجات لجوء جديدة، تهريب سلاح، جماعات مسلحة تبحث عن ملاذ، توترات قبلية قد تعبر الحدود، ومعادلات جديدة تفرض نفسها في جنوب مصر.
ولذلك، حاولت القاهرة أن تبقى حكيمة في خطواتها. أعلنت دعمها لوحدة السودان، وليس لطرفٍ ضد آخر، لكنها عمليًا كانت أقرب إلى الجيش باعتباره المؤسسة الرسمية. فهي تعرف أن أي بديل عن الدولة المركزية سيكون كارثيًا. وفي الوقت نفسه، لم تواجه الإمارات مواجهة مباشرة، ولم تدخل في خطاب عدائي، بل أبقت الخلاف في أدنى درجاته الممكنة، على أمل أن تنجح الدبلوماسية في تهدئة الصراع أو على الأقل منعه من التحول إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
ومع تطور الحرب، بدأ الدعم السريع يتخذ خطوات عدائية تجاه مصر، منها قيود على تجارة المناطق التي يسيطر عليها باتجاه الشمال، إلى جانب لهجة سياسية متشددة في بعض بياناته تجاه القاهرة. بدا واضحًا أن الصراع في السودان لم يعد صراعًا سودانيًا خالصًا، بل ساحة تقاطع نفوذ. ومع ذلك، تمسكت مصر بخيط واحد لا تحيد عنه: أن السودان يجب أن يظل بلدًا موحدًا، وأن مؤسساته يجب ألا تتفكك، وأن الخرطوم لا يمكن أن تُترك فراغًا تتصارع عليه القوى، لأن من يدفع ثمن هذا الفراغ أولًا وأخيرًا سيكون أهل السودان، ثم مصر بعدها مباشرة.
وفي قلب هذا المشهد، وجدت القاهرة نفسها مضطرة لممارسة نوع من السياسة الهادئة التي تمشي بين النقاط. فهي لا تستطيع المجاهرة بكل أوراقها، ولا يمكنها أن تنسحب من الساحة، ولا يمكنها أن تساير الجميع في وقت واحد. ولذا، اتخذت موقفًا يجمع بين المرونة والصلابة: مرونة في الحوار والتحرك الإقليمي، وصلابة في خطوطها الحمراء المتعلقة بوحدة السودان وأمنه وحدوده.
ومع مرور الوقت، صار واضحًا أن مصر تحاول قدر الإمكان أن تحافظ على قرار مستقل في الملف السوداني، قرار لا تمليه استثمارات الخارج ولا الحسابات الضيقة، بل تمليه الجغرافيا والتاريخ والمصالح المباشرة. فالسودان ليس مساحة يمكن التخلي عنها، ولا بلدًا يمكن تركه للتجارب. إنه جزء من توازن المنطقة، ومن استقرار مصر نفسها. وربما لهذا السبب تحديدًا كان الموقف المصري موزونًا، لا ينجرف خلف حماس الميدان، ولا يتجاهل مصالح الحلفاء، لكنه في النهاية يظل ملتصقًا بما تراه القاهرة “مصلحة وجودية”.
وهكذا بدت مصر في تلك الحرب كأنها تقف عند نقطة بين الماضي والمستقبل، بين علاقات اقتصادية ينبغي حمايتها، وجارٍ ينبغي إنقاذه، وبين حربٍ لم تخترها لكنها مضطرة للتعامل مع تداعياتها. وكل خطوة كانت محسوبة، وكل كلمة كانت تُقال بميزان، لأن الخرطوم ليست بعيدة، وما يجري فيها ينعكس في القاهرة قبل أن تهدأ نيران البنادق.
هذه هي الحكاية كما بدت: حكاية جارٍ يحترق، ودولة تحاول أن تمد يدًا دون أن تخسر الأخرى، وتبحث عن قرار مستقل في بحرٍ تموج فيه المصالح والأطماع، لكنها تعرف أن استقلال القرار ليس بطولة، بل ضرورة من ضرورات البقاء
منذ اللحظة الأولى، أدركت مصر أن النار التي اشتعلت في الخرطوم ليست شأنًا داخليًا بسيطًا، وأن الصراع ليس بين جنرالين فقط، بل بين رؤيتين لمستقبل السودان، وبين قوى خارجية تحاول كل واحدة منها أن تجد موطئ قدم في بلدٍ يملك موقعًا ومقدّرات تجذب الأنظار. وفي الوقت نفسه كانت الإمارات، الصديق الاقتصادي الأقرب للقاهرة، تُتهم بأنها تمد الدعم السريع بالسلاح والمال، بينما تُتهم هذه القوات بارتكاب فظائع ضد مدنيين في دارفور ومناطق أخرى. كان المشهد معقدًا إلى درجة أن القاهرة وجدت نفسها في لحظة تحتاج فيها إلى السير على حافة السكين: لا تريد استعداء الإمارات، ولا يمكنها أن تتخلى عن السودان، ولا تستطيع أن تسمح لقوة مسلحة غير نظامية بأن تفرض واقعًا يهدد وحدته.
في الشارع المصري، وفي دهاليز السياسة، كان السؤال يتردد همسًا: كيف يمكن للقاهرة أن تدعم الجيش السوداني وهي ترى أن صديقها الاقتصادي الأكبر يتحرك في الاتجاه المعاكس؟ لكنه سؤال لا يُسأل بصوتٍ مرتفع، لأن العلاقات بين مصر والإمارات أكبر وأعمق من أن تختزل في لحظة خلاف حول ساحة صراع، ولأن الدول تتعامل مع مصالحها بميزان الذهب. ومع ذلك، كان السودان بالنسبة لمصر ملفًا مختلفًا، لا يُدار فقط بمنطق العلاقات الخارجية، بل بمنطق الأمن القومي المباشر. النيل يمر هناك. الحدود الطويلة تمتد هناك. وانهيار السودان يعني فتح بوابة لا يمكن إغلاقها بسهولة: موجات لجوء جديدة، تهريب سلاح، جماعات مسلحة تبحث عن ملاذ، توترات قبلية قد تعبر الحدود، ومعادلات جديدة تفرض نفسها في جنوب مصر.
ولذلك، حاولت القاهرة أن تبقى حكيمة في خطواتها. أعلنت دعمها لوحدة السودان، وليس لطرفٍ ضد آخر، لكنها عمليًا كانت أقرب إلى الجيش باعتباره المؤسسة الرسمية. فهي تعرف أن أي بديل عن الدولة المركزية سيكون كارثيًا. وفي الوقت نفسه، لم تواجه الإمارات مواجهة مباشرة، ولم تدخل في خطاب عدائي، بل أبقت الخلاف في أدنى درجاته الممكنة، على أمل أن تنجح الدبلوماسية في تهدئة الصراع أو على الأقل منعه من التحول إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
ومع تطور الحرب، بدأ الدعم السريع يتخذ خطوات عدائية تجاه مصر، منها قيود على تجارة المناطق التي يسيطر عليها باتجاه الشمال، إلى جانب لهجة سياسية متشددة في بعض بياناته تجاه القاهرة. بدا واضحًا أن الصراع في السودان لم يعد صراعًا سودانيًا خالصًا، بل ساحة تقاطع نفوذ. ومع ذلك، تمسكت مصر بخيط واحد لا تحيد عنه: أن السودان يجب أن يظل بلدًا موحدًا، وأن مؤسساته يجب ألا تتفكك، وأن الخرطوم لا يمكن أن تُترك فراغًا تتصارع عليه القوى، لأن من يدفع ثمن هذا الفراغ أولًا وأخيرًا سيكون أهل السودان، ثم مصر بعدها مباشرة.
وفي قلب هذا المشهد، وجدت القاهرة نفسها مضطرة لممارسة نوع من السياسة الهادئة التي تمشي بين النقاط. فهي لا تستطيع المجاهرة بكل أوراقها، ولا يمكنها أن تنسحب من الساحة، ولا يمكنها أن تساير الجميع في وقت واحد. ولذا، اتخذت موقفًا يجمع بين المرونة والصلابة: مرونة في الحوار والتحرك الإقليمي، وصلابة في خطوطها الحمراء المتعلقة بوحدة السودان وأمنه وحدوده.
ومع مرور الوقت، صار واضحًا أن مصر تحاول قدر الإمكان أن تحافظ على قرار مستقل في الملف السوداني، قرار لا تمليه استثمارات الخارج ولا الحسابات الضيقة، بل تمليه الجغرافيا والتاريخ والمصالح المباشرة. فالسودان ليس مساحة يمكن التخلي عنها، ولا بلدًا يمكن تركه للتجارب. إنه جزء من توازن المنطقة، ومن استقرار مصر نفسها. وربما لهذا السبب تحديدًا كان الموقف المصري موزونًا، لا ينجرف خلف حماس الميدان، ولا يتجاهل مصالح الحلفاء، لكنه في النهاية يظل ملتصقًا بما تراه القاهرة “مصلحة وجودية”.
وهكذا بدت مصر في تلك الحرب كأنها تقف عند نقطة بين الماضي والمستقبل، بين علاقات اقتصادية ينبغي حمايتها، وجارٍ ينبغي إنقاذه، وبين حربٍ لم تخترها لكنها مضطرة للتعامل مع تداعياتها. وكل خطوة كانت محسوبة، وكل كلمة كانت تُقال بميزان، لأن الخرطوم ليست بعيدة، وما يجري فيها ينعكس في القاهرة قبل أن تهدأ نيران البنادق.
هذه هي الحكاية كما بدت: حكاية جارٍ يحترق، ودولة تحاول أن تمد يدًا دون أن تخسر الأخرى، وتبحث عن قرار مستقل في بحرٍ تموج فيه المصالح والأطماع، لكنها تعرف أن استقلال القرار ليس بطولة، بل ضرورة من ضرورات البقاء