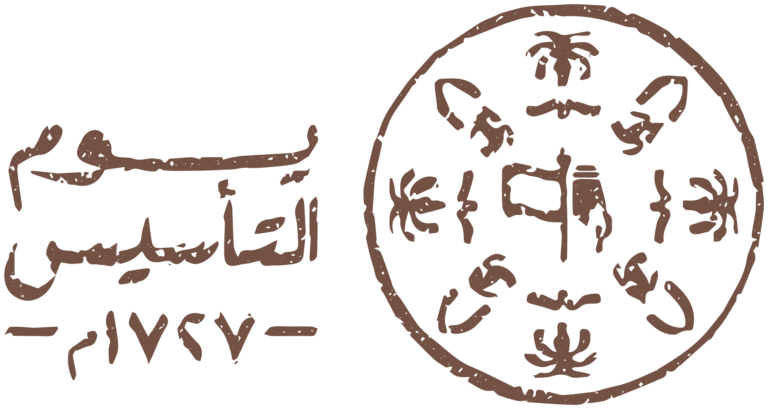اولا :فلسطين
ويقولون .. لماذا انهارت الدولة العثماية؟ .. فرضوا ضرائب حتى على الحمير و “عيديات” للوالي
بواسطة albaboor آخر تحديث يوليو 12, 20211٬677
شارك
أسرف السلاطين والولاة العثمانيون في فرض الضرائب والرسوم قبل عصر التنظيمات. وكان السبب في فرضها مسؤولية الوالي عن النظام في الولاية وعن الانفاق على الجنود والموظفين العاملين برفقتها. لذلك كان يجبي ضرائب مبتدعة وغير رسمية لتأمين نفقاته الخاصة، ونفقات الولاية العامة. كانت هناك علاوة على الضرائب الرسمية كالأعشار والجزية ورسوم المواشي والجمارك، ضرائب أخرى لا تدخل خزينة الدولة، وإنما تذهب إلى خزائن الولاة وكبار الموظفين. ففرضوا ضرائب خاصة على شجرة الزيتون في القدس* وصفد* ونابلس* تقسم مناصفة بين صاحب الإقطاع والفلاح.
كما فرضت رسوم على الحاصلات التي تنقل من الحقول إلى المدن، ورسوم أخرى على المحلات التجارية والأماكن العامة في المدن. ومن هذه الرسوم، رسوم “فتوح بندر” التي يدفعها من يرغب في فتح دكان أو محل تجاري، وتحدد بعد المساومة، ورسم “مباشرة حمام” ويدفع عند فتح أو استئجار حمام، وضريبة العزوبة وتستوفى من غير المتزوجين، وضريبة الزواج وتستوفى حين الزواج، و”قدوم غلمانية” وتؤخذ عند الولاة، و”عيدية” وتؤخذ كل عيد، و”رسم قدوم” ويجري تحصيله عند قدوم الوالي و”رسم خلعت” وهو هدية للوالي.
هذا بالإضافة إلى بعض البدع الأخرى، مثل بدعة القهوة. وبدعة أزمير وهي ضريبة على الشمع والقطن الخام، وضريبة المرور على البضائع التي تنقل من مكان إلى آخر، وغير ذلك من الرسوم مثل “قدوم حصادة” وتؤخذ وقت الحصاد في لواء صفد. ولكن صدرت تنظيمات عام 1839م رفعت جميع هذه الرسوم، وأصبح لا يحق للولاة فرض الضرائب على السكان.
واهتمت الدولة العثمانية في عهد التنظيمات (1839 – 1914) بتنظيم ماليتها وأولت ذلك عنايتها واهتمامها. وكانت “دفتردارية الدولة” قد تحولت في عام 1828 إلى “نظارة المالية” وأصدرت الدولة مجموعة من الأنظمة والقوانين لتنظيم الضرائب وجبايتها. وكيفية إدارة الأمور المالية في قرى الدولة وأقضيتها وألويتها وولاياتها. واعتبر النظام كل من يحصل، أو بأمر بالتحصيل، أو بصرف، أو بأمر بالصرف، مسؤولاً عن ذلك المال. وحتم النظام على محصل المال أو صارفه إعطاء، أو أخذ سند بذلك.
وعينت الدولة في كل لواء محاسباً، وفي كل قضاء مديراً للمال. وإلى جانب كل منهما أميناً للصندوق لقبض الأموال الأميرية. واعتبر النظام المسؤول الإداري (القائمقام أو المتصرف أو الوالي)، والمسؤول المالي (المحاسب أو مدير المال)، والمجلس الإداري (في الولاية أو اللواء أو القضاء) مسؤولين عن المخالفات المالية.
وفي مراكز الألوية في فلسطين هنص النظام على مسؤولية المتصرف والمحاسب في المحافظة على الاموال الأميرية، كما عهد إليهما الإشراف على تحصيل أموال الدولة وصرفها وحفظها وإرسالها إلى القدس أو بيروت، حسب تبعية الألوية الإدارية، لتقوم بدورها بإرسالها إلى العاصمة. واشترك المحاسب مع المتصرف في إبداء الرأي عند إجراء التشكيلات الإدارية، لأنهما لا ينفردان في صرف أموال الدولة، فلا بد من اتفاقهما في المعاملات المالية.
ونظمت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الضرائب المالية، فأصبحت ضرائب الاعتبار و”الوبركو” والبدل العسكري ورسم الأغنام من الإيرادات الرئيسة في متصرفية القدس وفي القسم الجنوبي من ولاية بيروت كما هي الحال في سائر الولايات الأخرى، بالإضافة إلى إيرادات ثانوية، مثل رسوم المسقفات (الطابو) والمحاكم وبعض الرسوم المتنوعة والحاصلات المتفرقة. ويمكن إجمالها على النحو التالي:
1) الأعشار: يستوفى رسم العشر من الحاصلات الزراعية بنسبة 10%. وبين النظام لزوم إجراء مزايدات الأعشار بصورة علنية. ويتم تلزيم أعشار الزيتون لمدة سنتين، أما الأعشار الأخرى فلمدة سنة، وعند الضرورة تلتزم سنتين. أما القرى التي تم يتقدم لها أحد من الملتزمين فتدار أعشارها بصورة “الأمانة” بإشراف متصرفي الألوية وقائمقامي الأقضية، مع إعفاء الحطب والفحم والخضر* من رسم العشر.
وعلى الرغم من أن الاعشار كانت تعني أن يدفع الفلاح 10% من محصوله للملتزم أو الدولة عيناً أو نقداً، فإنه في الواقع كان يدفع أكثر من ذلك، لأن الدولة زادت ضريبة العشر حتى أوصلتها إلى 12% من أجل تنفيذ مشاريعها الإصلاحية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر.
2) الويركو: وهي كلمة تركية تعني الجزية أو الخراج أو المال الميري أو الرسم. وقد فرضت هذه الضريبة بموجب “خط كلخانه 1839”. وتقسم إلى ويركو الأملاك ـ وويركو التمتع. وتشمل الضريبة الخاصة بالويركو ضرائب أخرى مثل ضريبة المقطوعة، والضريبة النسبية، والضريبة المتحولة.
المزيد من المشاركات
3) ضريبة البدل العسكري: استوفى هذا البدل من غير المسلمين باسم الإعانة العسكرية. وراعت الدولة تحصيل هذه الضريبة من أصحاب التجارة أولاً، ثم من أصحاب الزراعة في الأوقات المناسبة لهم.
4) ضريبة المسقفات: وقد بدأت الدولة بجباية الضريبة منذ عام 1858، بعد تحرير المسقفات في المدن والقصبات والقرى. وفي عام 1910 أصدرت قانوناً يقضي بتحرير جميع المسقفات، وتحديد إيراد غير صاف لها، واستيفاء 12% من ذلك الإيراد لجميع المسقفات، 9% للطواحين والمعامل.
5) ضريبة المعارف: وكانت تجبي بنسبة 5% من قسم المسقفات، وتضاف إلى ضريبة الويركو، وتجبى معها. وفي عام 1869 أنشأت الدولة صندوق المعارف للإنفاق على إنشاء المدارس الرشدية والإعدادية وإصلاحها. ودفع رواتب المعلمين. وفي سنة 1885 زادت الدولة العشر بنسبة نصف في المئة حصة المعارف.
6) ضريبة العمال المكلفين: وفق نظام الطرق والمعابر في سنة 1869 كلفت الذكور (من 16-60 سنة) في المدن والقرى، مع حيوانات النقل والعربات التي فيها، العمل بمعدل أربعة أيام في السنة. ومنع النظام تعبيد الطرق في مواسم الزراعة، واشتراك الذين تبعد مناطق سكنهم أكثر من 12 ساعة سيراً على الأقدام. وبلغت قيمة البدل النقدي 16 قرشاً في السنة. وفي نهاية العهد العثماني تراوحت قيمة البدل بين 20 و30 قرشاً في السنة.
7) رسوم المواشي: استوفت الدولة رسوم المواشي في عام 1839 بنسبة 10% من إنتاجها. فاستوفت رسماً قدره أربعة قروش عن كل رأس غنم أو معز، وعشرة قروش عن كل رأس إبل أو جاموس. ومنح نهاية العهد العثماني تضاعفت هذه الرسوم، ووجدت الدولة صعوبة في تحصيلها.
8) الرسوم والجمارك: صدر نظام إيرادات الرسوم في عام 1862. وعند النظام الرسوم التي تؤخذ عن القهوة والأعشاب وصيد السمك وبيع الحيوانات، واحتكرت الدولة الدخان والملح. وفرضت رسما على الدخان الأجنبي المستورد يعادل 75% من قيمته الأصلية، ومنعت استيراد الملح الأجنبي، وأصبحت الدولة هي المنتج والبائع الوحيد للملح في جميع الولايات. وعملت على زيادة حصتها من الرسوم المفروضة على الواردات من 3% إلى 8%، وفي نهاية العهد العثماني بلغت 11%.
9) رسوم متفرقة: إضافة إلى الضرائب السابقة الدولة رسوماً أخرى مثل رسم صناعة الحرير والقطن، ورسوم دلالة العطارين، ورسوم المحاكم، وإصدار حيوانات السفر، ومستندات الصرف، والمسقفات (الطابو)، والانتقال، والرخص. وفي عام 1906 أصدرت الدولة قانوناً فرضت بموجبه رسوماً على تأسيس المحلات الصناعية والكفالات المالية وغيرها.
د- الضرائب في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني: بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين ثبتت الإدارة العسكرية جميع الضرائب التي كانت مفروضة في العهد العثماني. ونص اعلان نائب الحاكم العسكري في 27/2/1918 على أن “جميع التكاليف والرسوم التي كانت تجبيها الحكومة التركية قبل دخولها الحرب يصير مراعاتها وتحصيلها، وأن جميع المتأخرات من سنة 1933هـ التركية المالية يصير تحصيلها أيضاً حسبما كان جارياً قبل الحرب”.
وقد تذمر الأهالي من هذا الموضوع لأن البلاد كانت تعاني أزمة اقتصادية بسبب الحرب. فأصدرت الإدارة إعلانات أخرى أكدت إصرارها على تحصيل الضرائب السابقة، وهددت المتأخرين باتخاذ الإجراءات التي تكفل للإدارة إجبارهم على الدفع. لكن الأهالي بالرغم من ذلك، لم يقبلوا على الدفع بصورة جماعية.
المصدر: الموسوعة الفلسطينية