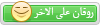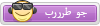بسم الله الرحمن الرحيم
في كل مرة تبدو فيها سوريا على وشك أن تستعيد ملامح الدولة المركزية، تنهض من بين طيات الجغرافيا والتاريخ قوى محلية تسحب البلاد إلى الوراء. ويبدو أن لعنة التمرد الطائفي لم تغادر سوريا قط، بل تتجدد في كل جيل بثوب مختلف، وإن بقيت الروح واحدة.
في مشهد لا يخلو من التكرار المأساوي، تتصدر محافظة السويداء من جديد واجهة الأحداث، ويعود أبناء الطائفة الدرزية لرفع السلاح لا في وجه محتل أجنبي، بل ضد الدولة السورية. ومع ما يُنقل عن تعاون بعض الزعامات المحلية الدرزية مع الكيان الصهيوني، وتلقيهم الدعم اللوجستي والتقني، يعود شبح التاريخ ليفتح أبوابه على مصراعيه، ويستدعي اسمًا لطالما ارتبط بمحاولة كسر هذا النمط الانفصالي: الجنرال أديب الشيشكلي.
قبل سبعين عامًا، واجه الشيشكلي المعضلة ذاتها: دولة هشّة، طوائف متناحرة، تدخلات أجنبية، وطائفة درزية تتمركز في الجبل، تحتفظ بسلاحها، وترفض الانصهار في جسد الوطن. حاول أن يُحكِم قبضة الدولة، أن يجعل من الجيش العمود الفقري لوحدة سوريا، وأن يكسر فكرة الزعامة الدينية والإقطاع الطائفي، لكن محاولته تلك قوبلت بتمرّد دموي، تغذّى بدعم خارجي وامتد حتى إسقاطه ونفيه.
قال الشيشكلي ذات مرة:
"لا يمكن أن تُبنى دولة على رمال الطوائف والمصالح الضيقة… الوطن لا يُقسم حسب عدد المآذن والكنائس!"
واليوم، وبعد عقود من الفوضى، وتفكك البلاد في أتون الحرب الأهلية، يظهر أن كلمات الشيشكلي لم تكن مجرد شعارات جنرال طموح، بل نبوءة مبكرة لما ستؤول إليه سوريا حين يُترك القرار السياسي رهينة للهويات المتصارعة.
فمن هو أديب الشيشكلي؟ وكيف حاول أن يبني جمهورية سورية حديثة؟ ولماذا كان جبل العرب هو الساحة التي بدأت منها نهايته؟ وهل كان مجرمًا ديكتاتورًا كما تصفه خصومه، أم رجل دولة حاول المستحيل في وطن ممزق؟ ثم… ماذا لو بقي في الحكم؟ هل كانت سوريا ستنجو من حربها الأهلية القادمة؟
هذا ما سنحاول سرده وتحليله في هذا الموضوع ان شاء الله.
سوريا قبل الشيشكلي – من الإرث العثماني إلى العثرات الوطنية
بين إرث الاستعمار وتمرد الداخل… كان الطريق إلى الشيشكلي مفروشًا بالأشواك
قبل أن يبرز اسم أديب الشيشكلي في المشهد السوري، كانت البلاد تمر بمرحلة عصيبة من التكوّن السياسي والاجتماعي، تجتاحها الرياح المتضاربة بين طموح الاستقلال وهشاشة الدولة الناشئة. فـ"سوريا الكبرى" التي حملت يومًا الحلم العربي القومي، أُجهضت مبكرًا على أعتاب الاستعمار، ودُفنت معها آمال الوحدة والكرامة.
سوريا ما قبل الاستقلال: شعب بلا سيادة
خلال العهد العثماني، عاشت بلاد الشام ضمن منظومة لا تعرف مركزية قوية في الداخل، لكنها حافظت على توازن هشّ بين المكونات الطائفية والاجتماعية، بفضل الإدارات المحلية ونظام الملل الذي أعطى بعض الامتيازات للطوائف الكبرى. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط السلطنة، بدأت خريطة المشرق تعاد تشكيلها، وسط طموحات استقلالية عربية اصطدمت بحقائق الهيمنة الغربية الجديدة.فرض الانتداب الفرنسي على سوريا عام 1920، بعد سحق حلم فيصل بن الحسين بقيادة مملكة عربية موحدة، كان إيذانًا بمرحلة جديدة من الصراع. عمد الفرنسيون إلى تقسيم البلاد إلى دويلات طائفية: دولة دمشق، دولة حلب، دولة العلويين، دولة الدروز، ولبنان الكبير. لم يكن هذا التقسيم اعتباطيًا، بل جزءًا من سياسة "فرّق تسد"، التي زرعت بذور الانقسام المزمنة في الجسد السوري.
"فرّق تسد… كانت تلك سياسة الفرنسيين، فصنعوا طوائفهم كما يشاؤون، ومزّقوا الجغرافيا والنفوس معًا"
— الصحفي السوري فارس الخوري، في إحدى جلسات الجمعية التأسيسية عام 1946
اقتصاديًا، كانت سوريا بلدًا زراعيًا يعتمد على محاصيل محدودة، يعاني من فقر البنية التحتية وسيطرة كبار الملاّك والعائلات التقليدية على مقدرات الاقتصاد. أما اجتماعيًا، فقد سادت العلاقات العشائرية والطائفية، وكانت الهوية الوطنية ما تزال في طور التشكل، تقاوم عوامل التفتت وتبحث عن نخبة تقودها إلى دولة مركزية حديثة.
"كنا نحيا في وطن مقسم اقتصاديًا كما هو مقسم سياسيًا، لا عدالة في الثروة ولا في الفرص، والريف يُترك لجوعه وغضبه"
— من مذكرات جمال الأتاسي
سياسيًا، كانت البلاد تعاني من تقلبات حادة؛ من مقاومة مسلحة (كما في الثورة السورية الكبرى 1925–1927 بقيادة سلطان الأطرش) إلى مساومات سياسية مع الفرنسيين قادتها طبقة من البرجوازية المدينية. لم تكن الحياة الحزبية مستقرة، بل شهدت انقسامات متواصلة وصراعات بين التيارات القومية، والشيوعية، والإسلامية، وحتى داخل التيار القومي نفسه.
"سوريا كانت تُحكم من الشوارع أكثر مما تُحكم من القصور… السياسة فيها كانت ضوضاء أكثر منها حُكمًا"
— الباحث الفرنسي جان بيير فيليو
أوضاع سوريا بعد الاستقلال (1946): الدولة الوليدة في مهب الرياح
حين خرجت القوات الفرنسية من سوريا عام 1946، بدا أن الحلم الذي راود السوريين طويلًا قد تحقّق أخيرًا. أصبح لسوريا علمها الخاص، وجيشها الوطني، وحكومتها المستقلة. لكن الاستقلال كان أشبه بقطرة ماء في صحراء ممتدة، إذ وجدت البلاد نفسها فجأة في مواجهة تركة ثقيلة من التخلّف، والتمزّق، والتبعية.
سياسيًا، دخلت سوريا حقبة من الصراعات الحزبية والانقلابات العسكرية، حيث تنازعت النخب المدنية والعسكرية على السلطة، وغاب الإجماع الوطني حول شكل الدولة ومسارها. برزت الأحزاب الكبرى مثل "الكتلة الوطنية"، و"الحزب القومي السوري الاجتماعي"، و"حزب البعث"، و"الإخوان المسلمين"، ولكنها كانت غارقة في الانقسامات الأيديولوجية والتناحر الشخصي. وبسبب هذا التناحر، أصبحت الديمقراطية السورية قصيرة النفس، وسرعان ما تحولت صناديق الاقتراع إلى فوهات بنادق.
اجتماعيًا، كانت سوريا موزّعة بين مدنٍ تتجه إلى الحداثة مثل دمشق وحلب، وأريافٍ ومناطق جبلية تعاني من الفقر، والعزلة، والجهل، وأحيانًا القبلية والطائفية. كان المجتمع السوري هشًا، متعددًا في طوائفه وأعراقه، ومفتقدًا لأي مشروع وطني يدمج هذه الفسيفساء في وحدة متماسكة. ورغم أن فكرة “الوطن السوري” بدأت تترسخ، إلا أن الولاءات الضيقة – الطائفية والقبلية والمناطقية – ظلت هي الأقوى.
اقتصاديًا، خرجت سوريا من الانتداب وهي تفتقر إلى البنية التحتية الحديثة، وتسيطر فيها الإقطاعيات على الزراعة، وتتحكم أقلية برجوازية في التجارة والصناعة. لم تكن هناك خطة واضحة للتنمية، ولا توزيع عادل للثروة، ولا تدخل حقيقي للدولة لإصلاح التفاوتات الطبقية. وفي بلد يعتمد أغلب سكانه على الزراعة، كانت غالبية الفلاحين يرزحون تحت ديون الإقطاعيين، بينما تغيب شبكات الري الحديثة والأسواق العادلة.
عسكريًا، وُلد الجيش السوري من رحم مدرسة عسكرية فرنسية النمط، لكنه كان صغيرًا في عدده، محدودًا في تسليحه، ويفتقر إلى عقيدة واضحة. ومع ذلك، سرعان ما أصبح لاعبًا سياسيًا حاسمًا. فقد رأى بعض الضباط – خصوصًا من الجيل الذي انتمى إلى "جيش الشرق" زمن الفرنسيين – أن لهم الحق في “تصحيح” المسار السياسي حين تضعف الحكومات المنتخبة، وهو ما مهد الطريق لزمن الانقلابات.
كان هذا هو المشهد الذي ظهر فيه أديب الشيشكلي... دولة فتية تتأرجح فوق حبل رفيع بين الأمل والانهيار، تبحث عن قائد قوي يُنقذها من الفوضى، ويمنحها مشروعًا وطنيًا متماسكًا. لكن، كما ستُظهر السنوات التالية، فإن الحلم سرعان ما يصطدم بالواقع، والتناقضات العميقة في جسد الوطن.
إرهاصات الصراع الذي ما زال مستمرًا…
ما بين التنازع على الهوية، والتشابك الإقليمي، لعبت الطوائف دورًا مركزيًا في تشكيل الواقع السوري. وبينما اعتبر البعض أن صعود العسكر كان محاولة لبناء دولة قوية تقف في وجه التفكك، رأى آخرون أنه أدى لمزيد من الانقسامات. والمفارقة أن جذور الكثير من هذه الإشكالات – بما فيها دور الطائفة الدرزية – ستعود لتطفو على السطح في العقود التالية، وتجد صداها مجددًا في تمرد جبل الدروز اليوم ضد الرئيس "أحمد الشرع"، ورفع أعلام إسرائيل في السويداء، في مشهد يكاد يعيد سرد تاريخ الخيانة بلونٍ معاصر.
"من لم يتعلّم من تاريخ جبل الدروز، سيظل يدفع ثمن ثقته كل مرة… حتى تُفهم الخيانة بوصفها جزءًا من مشروعٍ وليس نزوة"
— باحث سوري معاصر تعقيبًا على أحداث السويداء
كان هذا هو المسرح الذي سيظهر فيه أديب الشيشكلي، شابًا طموحًا، ابن الجنوب، ابن الجندية، حاملًا همّ الوحدة في قلبٍ تمزقه الطوائف.