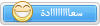اغتالت وأطاحت بـ 22 رئيساً.. هكذا حكمت فرنسا أفريقيا من وراء ستار لمدة 50 عاماً
مقال للباحث محمد السعيد
مقال للباحث محمد السعيد
مقدمة
يُخبرنا الصراع المشتعل في أفريقيا الوسطى بين الرئيس تواديرا المدعوم من روسيا والمعارضة المدعومة من فرنسا الكثير عن الطريقة التي تنظر بها القوى الكبرى إلى أفريقيا بوصفها ملعبا للنفوذ والصراعات بالوكالة، بل ولنهب الموارد والاستيلاء على خيرات الشعوب. ربما انتهى زمان الاستعمار رسميا، لكن قواه لا تزال تتحكَّم في أفريقيا من خلال الإمبراطوريات الاقتصادية والشركات الأمنية، والأنظمة الديكتاتورية التي لا تتردَّد في استدعاء القوى الأجنبية لضمان البقاء في السلطة. هي قصة قديمة إذن لكنها تتجدَّد كل يوم بصورة مختلفة، ليستمر معها الرجل الأبيض في الاستيلاء على خيرات أفريقيا، في أكبر سرقة علنية عرفها التاريخ.
نص المادة:
في ذلك التوقيت لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت الربيع العربي، حيث يموج العالم بالصخب بعد رحيل زين العابدين بن علي وحسني مبارك، في حين بدأ للتو القصف الدولي على ليبيا بهدف الإطاحة بالقذافي، بينما تتلاحق التطورات سريعا في اليمن وسوريا. في خضم هذا الصخب، وتحديدا في إبريل/نيسان 2011، كانت الطائرات الفرنسية تُحلِّق بكثافة في سماء أبيدجان، عاصمة ساحل العاج، مُرسِلة صواريخها لتُدمِّر مستودعات الأسلحة حول المدينة مُحوِّلة سماء البلاد الهادئة إلى عرض مرعب للألعاب النارية، وسرعان ما تحوَّلت الطائرات، بعد السيطرة على مطار أبيدجان، إلى القصر الرئاسي حيث يُقيم الرئيس "لوران غباغبو"، الذي كان قد لجأ للتو إلى المجلس الدستوري من أجل إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه "الحسن واتارا"، الذي يحظى بعلاقات جيدة مع فرنسا، واعتُرِف به رئيسا شرعيا للبلاد. وفي خضم الاشتباكات بين قوات الجيش الموالية لغباغبو والمسلحين الموالين للرئيس الجديد، انقسمت البلاد فعليا تحت سيطرة حكومتين، قبل أن تتدخَّل فرنسا من جديد بغطاء دولي وتقوم باعتقال "غباغبو"، وإرساله إلى المحاكمة أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
لم تكن عملية أبيدجان بحال خارجة عن سياق النشاط الفرنسي المستمر في أفريقيا، الذي لم يوقفه بحال النهاية "الرسمية" لعهود الاستعمار بحصول جميع الدول الأفريقية على استقلالها، فعلى مدار العقدين الماضيين نفَّذت فرنسا تدخُّلات عسكرية نشطة في كلٍّ من جيبوتي ومالي وأفريقيا الوسطى وتشاد، ناهيك بقواتها الموجودة بحكم الواقع في قائمة أخرى من البلدان كالسنغال وبوركينا فاسو والكونغو والجابون وغيرها، وهو نشاط لا يُغيِّر من طبيعته حقيقة أنه لا يحظى بحقه اللائق من التغطيات الإعلامية الغربية، نظرا لأن وسائل الإعلام في الغرب ربما لا تزال تستبطن تلك الرؤية الهيغلية، نسبة إلى الفيلسوف الألماني هيغل، حول أن العبودية هي "خاصية أفريقية ومصير محتوم للأفارقة"، وأن العبيد الأفارقة الذين اقتيدوا قسرا إلى الغرب لم يكونوا ليصبحوا أفضل حالا إذا ظلَّوا في بلادهم، تلك الصورة النمطية حول الحكم والسياسة والمجتمع في أفريقيا التي لا يزال العالم أسيرا لها إلى الآن.

جندي فرنسي في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى (رويترز)

"الاستبداد والفساد المستشري ليسا لازمين للثقافة الأفريقية كما يبدو. في الواقع فإن المجتمعات عديمة الدولة مثل الصومال والإيبو والتيف -قبائل في نيجيريا- تميَّزت دوما برفض أي سلطة مركزية، لذا لم يكن من الممكن أن يظهر بينهم حكام مستبدون، بدلا من ذلك فقد قامت هذه الأنظمة على القانون العرفي والعدالة بوصفها مبادئ حاكمة".
(اللورد بيتر باور، اقتصادي بريطاني شهير، في كتابه "بين الواقع والبلاغة: دراسة في اقتصادات التنمية")
في ظل هيمنة هذا المنظور "الهيغلي" في التعامل مع أفريقيا، فإن الحجة السابقة، ومثيلاتها، مما خطَّه بيتر باور لم تكن لتلقى على الأرجح نصيبها من الانتشار في مواجهة السرديات المُهيمنة في النظر إلى القارة، ليس فقط من قِبَل العوام ولكن أيضا من قِبَل كبار القادة والسياسيين حول العالم وفي مقدمتهم حتى رؤساء الدول "العظمى" حول العالم الذين لا يُدركون ربما أن غانا كانت يوما ما أكثر تطوُّرا معماريا من فيينا أو أمستردام قبل أن يُدمِّرها البريطانيون، وأن مدينة "تمبكتو" في مالي كانت يوما ما أكبر خمس مرات من لندن، وأن إمبراطور مالي "مانسا موسى" يذكره المؤرخون إلى اليوم بوصفه أغنى رجل في التاريخ. كما أن معظمهم لم يسمع يوما بنُظم السلطة في مشيخات مثل "فانتسي" و"موسي" و"شونا" و"خوزا"، حيث لم يكن من الممكن لرئيس أن يُملي سياسة أو قانونا مستقلا دون موافقة من مجالس الشيوخ والعشائر، أو حتى بملوك "الزولو" و"الشاكا" الأقوياء، الذين على الرغم من قوتهم لم يكونوا يملكون سوى تفويض الكثير من سلطاتهم.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحاجة إلى أن يعرف بعضا من هذا قبل أن يُصرِّح، بعنصريته المعتادة، أن الأفارقة "بحاجة إلى الاستعمار لمئة عام أخرى"، وأنهم لا يعرفون شيئا عن الحكم والقيادة بسبب "كسلهم وغبائهم وهوسهم بالطعام والجنس والعنف". ولكن ترامب لم يكن بحاجة إلى بذل مجهود كبير لاستكمال نقصه المعرفي حول أفريقيا، فهناك الكثير من الوثائق في مبنى مخابراته المركزية في لانجلي يُمكنها أن تخبره كيف أسهمت بلاده في رسم تلك الصورة التي يعتقدها اليوم عن أفريقيا، أما زعماء أوروبا فربما تكفيهم زيارة قصيرة إلى فرنسا، حيث يمكنهم قضاء بعض الوقت مع مَن تبقوا على قيد الحياة من خلية الظل التي كانت حتى وقت قريب -وربما لا تزال إلى الآن بأساليب مختلفة- تُدير مصالح باريس في أفريقيا.
تُعرف هذه الخلية إعلاميا باسم "فرانس أفريك"، وقد بدأت عملها مع تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا، ووصول "شارل ديغول" إلى السلطة عام 1958، حيث منح ديغول اتفاقا لـ 14 مستعمرة فرنسية سابقة في أفريقيا تحصل بموجبه على استقلالها في خلال عامين، مقابل اتفاق أمني مع فرنسا، اتضح فيما بعد أنه يشمل بنودا غير مُعلَنة، في مقدمتها وضع نسبة 85% من مدخولات هذه الدول تحت رقابة البنك المركزي الفرنسي، بوصفه نوعا من المقابل للبنية التحتية التي ادَّعى الاستعمار تشييدها، وقد جلبت فرنسا إلى خزائنها بموجب هذا الاتفاق قرابة 500 مليار دولار عاما بعد الآخر.
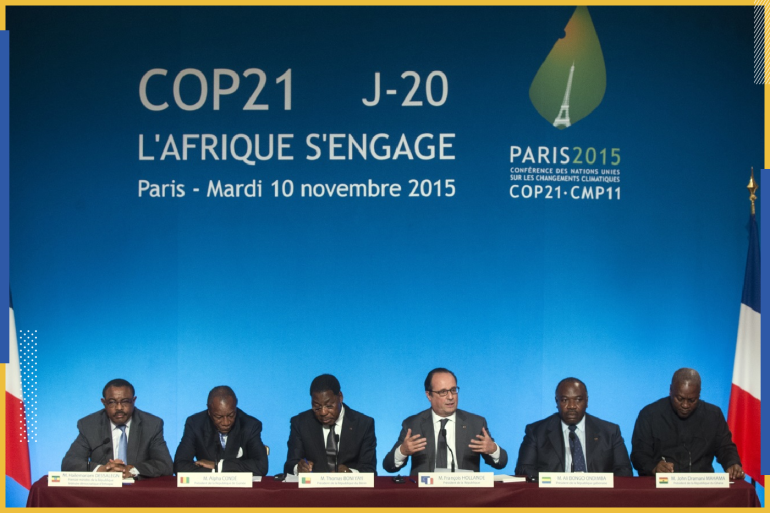
الرئيس الفرنسي هولاند مع رؤساء ورؤساء وزراء الدول الأفريقية في مؤتمر التنمية المستدامة في فرنسا (الأوروبية)
أعطى الاتفاق فرنسا أيضا الحقوق الحصرية في الحصول على أي مواد خام تُكتَشف في أراضي مستعمراتها السابقة، كما منح الشركات الفرنسية أولوية في أي أنشطة اقتصادية في هذه البلاد، في حين احتكرت باريس وحدها عقود التدريب العسكري وحقوق الأنشطة الأمنية في هذه البلدان التي أُجبرت، بموجب الاتفاق ذاته، على التحالف مع فرنسا في حال خوضها لأي حرب.
كُشِف عن هذه الشروط وغيرها في منتصف التسعينيات إثر الفضيحة الشهيرة التي عُرفت آنذاك باسم قضية "إلف"، نسبة إلى شركة البترول الوطنية الفرنسية "إلف آكتين" المعروفة بـ "توتال" حاليا، التي عملت بمنزلة ذراع استخباراتي لفرنسا في مستعمراتها السابقة، تحت قيادة وزير المحروقات الفرنسي السابق "بيير فيوما"، وفق الخطة التي هندسها أمين عام الإليزيه للشؤون الأفريقية، ورجل فرنسا الأول في أفريقيا، "جاك فوكار"، بأوامر مباشرة من الرئيس الفرنسي "شارل ديجول" شخصيا.
عُرِف فوكار في فرنسا آنذاك على أنه الرجل الوحيد الذي يُمكنه لقاء ديجول كل مساء، وكانت وظيفته تتلخَّص ببساطة في هندسة أنظمة الحكم في دول أفريقيا، وتثبيت الحكام أو الإطاحة بهم بما يتلاءم مع مصالح فرنسا. وكانت البداية في غينيا، حيث يحكم الرئيس "أحمد سيكوتوري" الذي قرَّر الاستقلال من جانب واحد عن فرنسا، وسرعان ما قرَّرت باريس معاقبته عبر حرمانه من "امتيازاتها الاستعمارية".
على الفور، غادر ثلاثة آلاف فرنسي غينيا، مُحمَّلين بأموالهم وأملاكهم ومُدمِّرين لكل ما لا يستطيعون حمله، كالمدارس وحضانات الأطفال، والمباني الإدارية والسيارات والمعدات، بل إنهم حرقوا مخازن الغذاء وقتلوا الماشية والأبقار، ولم تكتفِ فرنسا بذلك، بل عمدت إلى تدمير العُملة الغينية الجديدة من خلال إغراق السوق بالعُملات المُزوَّرة التي طُبعت في فرنسا، وسلَّحت مُعارضين غينيين من أجل الإطاحة بـ "سيكوتوري". أما في الكاميرون فقد فعلت فرنسا النقيض تماما، ودبَّرت عملية اغتيال المعارض الكاميروني الأبرز "فليكس مونيه"، في فيينا، بجرعة من التاليوم شديد السُّمية، من أجل تثبيت حكم الرئيس "أحجو" الذي كان يُعرف آنذاك على أنه "دُمية فرنسا".

شركة ألف الفرنسية (رويترز)
في الجابون، الدولة الغنية بالنفط التي حصلت شركة "إلف" على 70% من عائداتها النفطية بموجب اتفاق مع الحكومة، أعادت فرنسا حليفها الرئيس "ليون أمبا" إلى موقعه، بعد الانقلاب عليه من قِبَل صغار الضباط في الجيش، وسرعان ما دبَّرت وصول ألبير برنارد، المعروف بـ "عمر بونغو"، إلى السلطة خلفا لليون، من خلال تعيينه نائبا للرئيس عبر تعديل دستوري أُقِرَّ في سفارة الجابون في فرنسا. ويتولَّى اليوم "علي بونغو"، نجل "عمر بونغو"، السلطة في الجابون بتواطؤ فرنسي، وبموجب انتخابات صورية اعترفت المخابرات الفرنسية بأنها مُزوَّرة.
على النقيض أيضا حاولت فرنسا إسقاط نظام "ماثيو كريكو" الشيوعي في بنين، مُستغِلَّةً فريقا من المرتزقة بقيادة "كلب الحرب" الشهير "بوب دينار"، ولكن أُحبِطت المحاولة بواسطة الجيش البنيني، في حين أنها ثبَّتت نظاما شيوعيا آخر هو نظام "دينيس ساسو" في الكونغو برازافيل، بسبب موافقته على تأمين حصة شركة "إلف" في النفط الكنغولي، وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الفرنسي السابق "فرانسوا هولاند" والرئيس الحالي "إيمانويل ماكرون" مرارا نهاية عصر شبكات "فرانس أفريك"، وأن فرنسا بدَّلت سياستها الاستعمارية في أفريقيا، فإن الواقع يُخبرنا أن لعبة النفوذ لا تزال تجري على قدم وساق في القارة السمراء من الشرق إلى الغرب، وأنها تأخذ أشكالا جديدة، وتستقطب في كل يوم لاعبين جُدد إلى الرقعة.

"تستغرق الدورة بين اكتشاف النفط في منطقة ما وبداية إنتاجه نحو ثماني سنوات، والسماح بحدوث تغيرات في السلطة كل عام يضر بمصالح الطاقة الخاصة بنا، لذا فإننا نبحث دوما عن الاستقرار".
(بيير فيوما، وزير المحروقات الفرنسي الأسبق)
ربما تُمثِّل فرنسا النموذج الأسوأ والأكثر صراحة في حماية مصالحها على حساب الشعوب الأفريقية، إلا أن دولا مثل بريطانيا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال، ومن بعدهم الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم تكن أقل شراسة، ففي حين رفعت جميعها شعارات حول أحقية الأفارقة في التمتُّع بحقوق الإنسان والديمقراطية وعائدات التنمية، أُسوة بمواطني دولهم، دول العالم الأول، فإنها جميعا ظلَّت تستبطن هذا التصوُّر الذي يرى دوما أن جميع الأمم متساوية، ولكن بعضها يبقى "أقل مساواة" من الآخرين، كما يقول "جورج أورويل".

شباب أفريقي في احتجاجات ومسيرات لتسليط الضوء على البطالة والمشاكل الاجتماعية (رويترز)
ومع ذهاب زمن التدخُّلات المباشرة وانقلابات وضح النهار، فإن التلاعب الغربي بمستقبل الأفارقة صار يتخذ أشكالا أقل مباشرة ولكنها ربما أكثر ضراوة، غير أن هذا لم يجعل الشباب الأفريقي غافلا عن إدراك حقيقة أن بلاده لا تزال مُستعمَرة بصور مختلفة، حيث جاءت تظاهرات طلاب الجامعات في جنوب أفريقيا تحت شعار "أسقِطوا رودس" لتُعبِّر دوما عن هذه الحقيقة: أفريقيا لا تزال رهينة القوى الأجنبية، حتى وإن كان ذلك في جنوب أفريقيا التي قطعت شوطا طويلا من أجل تحرير إرادتها. وقد اختار الشباب النيجيري المُحتج ضد البطالة وقلة فرص العمل التظاهر عام 2016 أمام مقر شركة "شيفرون" الأميركية، في مشهد لا يخلو من رمزية تاريخية واضحة.
تمتلك شركات النفط الأجنبية في أفريقيا تاريخا طويلا في دعم الحكام المُستبدِّين حفاظا على مصالحها، على حساب تطلُّعات الشعوب الأفريقية، ففي منتصف التسعينيات، وتحديدا في دلتا النيجر، قدَّمت شركة "شل" الأموال لصالح الديكتاتورية العسكرية في نيجيريا من أجل قمع تظاهرات شعوب المنطقة ضد أنشطة الشركة المُتسبِّبة في تدمير البيئة والقضاء على مواردها الطبيعية، دون أي استفادة مُقابلة لهذه الشعوب من عائدات ثرواتها، بل تَبيَّن فيما بعد أن "شل" قدَّمت رشاوى للمُدَّعين العامين والشهود من الأجل الحكم بإعدام المناضل النيجيري "كين سرو"، وقادة الاحتجاجات في المنطقة الغنية بالنفط، وقُدِّر مجموع الأموال التي دفعتها الشركة من أجل هذه الأنشطة بنحو 383 مليون دولار. وبالرجوع في التاريخ قليلا، فإن شركة "إلف" الفرنسية كان لها السبق في هذا المسار، حين وظَّفت عوائد النفط الجابوني لدعم الحرب الأهلية في "بيافرا"، التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص.
ولكن شركات النفط لم تكن المُمثِّل الأوحد لقوى الاستعمار الجديد في أفريقيا، فحيثما وجدت الشركات الأجنبية ومصالحها، ترافقها الأنظمة الديكتاتورية والقمع المُتوسع. وتبقى الكارثة الأكبر التي تلتهم أفريقيا في الوقت الراهن، وتستنزف مليارات الدولارات من مواردها الاقتصادية، هي تلك الإمبراطورية المتنامية للشركات الأمنية الخاصة، التي تنشر عشرات الآلاف من الجنود المرتزقة الذين تكمن مهمتهم في حماية مصالح الشركات الدولية والأنظمة الداعمة لها، وتتوسَّع توسُّعا أخطبوطيا إلى درجة أنها توشك على التهام أفريقيا بأكملها.

تشمل القائمة مجموعة كبيرة من الشركات الأميركية والأوروبية والمحلية، بل والإسرائيلية أيضا، تأتي في مُقدِّمتها شركة "أكاديمي" وريث الإمبراطورية الأشهر في عالم مرتزقة الحروب "بلاك ووترز"، نبدأ رحلتنا من شركة "داينكورب" الأميركية، التي تُوظِّف 17 ألف شخص بحجم أعمال يتجاوز 200 مليار دولار، وانتزعت في عام 2014 عقدا لتدريب قوات حفظ السلام في السودان. وقد صرَّح مدير تطوير الأعمال في الشركة عام 2008 أن أفريقيا هي الهدف المثالي لها، وأنها أبرمت عقودا هناك بقيمة 1.2 مليار دولار على مدار 5 سنوات مع الأمم المتحدة وشركات النفط والتعدين.
وهناك أيضا شركة "ساند لاين" البريطانية التي عملت لصالح الحكومة لقمع التمرُّد في جزيرة بوغانفيل في غينيا، مقابل مديونية قُدِّرت بـ 36 مليون دولار، في حين تولَّت شركة "أو بي إس" الفرنسية مسؤولية تأمين رئيس أفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزي من هجوم قاده معارضو السيليكا، فيما تدخَّلت شركات "إكزيكوتيف أوتكمس" (شركة جنوب أفريقية حُلَّت عام 1998)، وشركة "لفدان" (الإسرائيلية)، وشركة "ميليتاري بروفشيونال رسورسيز" (أميركية)، في الأزمات ذات الطابع الاقتصادي بين الشركات الكبرى والشعوب المُتمرِّدة، مثل أزمة النفط في أنغولا، وأزمة الماس في سيراليون. وتُمارِس شركة "جي فور إس" الأميركية، ثاني أكبر شركة أمنية في العالم، سُدس أنشطتها العالمية في أفريقيا، في دول جنوب السودان وأنغولا ونيجيريا وزيمبابوي ضمن قائمة تضم 29 بلدا أفريقيا، ما يجعلها أكبر الشركات الأجنبية العاملة في أفريقيا على الإطلاق.
ومع توسُّع كعكة الأنشطة الأمنية مدفوعة الأجر في القارة، فقد عمدت بعض دول أفريقيا إلى تأسيس شركات المرتزقة الأمنية الخاصة بها التي تعمل لحساب الأنظمة الحاكمة والشركات الدولية، مثل شركة "أفينت" في زيمبابوي وشركة "تلي سيرفيس" في أنغولا وغيرها، وفي الواقع فإن بلومبيرغ تُقدِّر أن أعداد قوات الأمن الخاصة العاملة في جنوب أفريقيا مثلا يبلغ تقريبا ضِعْف عدد القوات الشرطية الحكومية، بواقع 446 ألف شرطي مسلح خاص مقابل 227 ألفا هو إجمالي عدد قوات الأمن الحكومية. ومع التاريخ الطويل للأعمال القذرة مدفوعة الأجر التي مارستها الشركات الأمنية الكبرى، من العراق إلى أميركا الجنوبية وحتى في أفريقيا نفسها، فإن التوسًّع المحموم لهذه الشركات والشبكة القوية التي تضمّها مع شركات النفط والمعادن والأنظمة الديكتاتورية في أفريقيا تُمثِّل عائقا قويا نحو تطلُّعات الشباب الأفريقي نحو التغيير، وخاصة في الدول الغنية بالمواد الخام أو تلك الدول التي ترتبط بمصالح أمنية واقتصادية مع القوى الكبرى.

يُنظر إلى أفريقيا دوما على أنها قارة الفرص، بما يعني أن مصالح الدول الأجنبية في القارة السمراء تبقى مُرشَّحة للتوسُّع مهما اختلفت أشكال هذا التوسُّع، بما يعني أيضا أن القارة سوف تظل تجتذب القوى الطامحة إلى لعب دور عالمي، بشكل يُغيِّر خريطة النفوذ التقليدية فيها، التي طالما احتكرتها أوروبا، وخاصة بريطانيا وفرنسا، وأصبحت اليوم مُعرَّضة للتغيير باستمرار.
تعي الديناصورات الحاكمة لديكتاتوريات أفريقيا العتيقة هذه التطلُّعات، وهم يواصلون السعي إلى ضمان البقاء في السلطة من خلال الحفاظ على هوامش المناورة بين القوى الدولية. من بين أعتى الديكتاتوريات في أفريقيا، لا تزال هناك خمسة أنظمة تتمتَّع بالدعم الدبلوماسي الرسمي من قِبَل الولايات المتحدة، على رأسها أنظمة غينيا الاستوائية والكاميرون وتشاد وأوغندا، وتتمتَّع الأنظمة نفسها، بالإضافة إلى الجابون والكونغو، بالدعم الفرنسي، فيما يتمتَّع النظام الجديد في أفريقيا الوسطى، الوافد الجديد إلى القارة.
لا يقتصر الدعم على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية، فكلتا الدولتين، فرنسا والولايات المتحدة، تحرصان على تعزيز وجودهما العسكري المباشر في أفريقيا، حيث لا تزال فرنسا تحتفظ بثلاث قواعد عسكرية في كلٍّ من السنغال والجابون وجيبوتي، بينما تحتفظ بوجود قواتها على الأرض في قرابة عشر دول، تشمل أيضا تشاد ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج والصومال. وفي حين تستضيف جيبوتي القاعدة الأميركية الرسمية الوحيدة في أفريقيا، فإن القيادة الأفريقية الأميركية المشتركة "أفريكوم" تحافظ على عمليات مشتركة مع جميع الجيوش الأفريقية تقريبا، حيث تملك واشنطن علاقات عسكرية مباشرة مع 49 دولة من إجمالي 54 دولة أفريقية، في الوقت الذي أسَّست فيه قاعدة للطائرات بدون طيار في النيجر.

يأتي ذلك في وقت تُسارِع فيه الأنظمة الديكتاتورية، التي لا تحظى بالغطاء الغربي الآمن، نحو توطيد علاقاتها مع القوى الجديدة الوافدة إلى القارة، وفي مُقدِّمتها الصين، ويُمثِّل "روبرت موجابي"، رئيس زيمبابوي الراحل، أفضل الأمثلة على هذا التوجُّه، حين استضافه الرئيس الصيني "تشي جين بينغ" في القصر الرئاسي، نهاية عام 2015، ومنحه جائزة "كونفوشيوس للسلام"، ووصفت السفارة الصينية في زيمبابوي البلدين بأنهما "أصدقاء في السراء والضراء".
وفي الوقت الذي رفض فيه صندوق النقد الدولي تمويل نظام "دي سانتوس" في أنغولا، فإنه سرعان ما يَمَّم وجهه شطر بكين أيضا. ويبدو هذا التوجُّه مُميِّزا للسياسة الصينية منذ صعود تشي إلى السلطة، حيث حظي النظام في غينيا على سبيل المثال بعقود اقتصادية مع الصين بقيمة سبعة مليارات دولار، بعد شهر واحد من وصوله إلى السلطة مُرتكِبا مذابح دامية. وفي الوقت الذي تحوَّل فيه الرئيس السوداني السابق "عمر البشير" إلى فريسة مطاردة من القوى الغربية، فإن الصين سارعت إلى بناء قصر رئاسي جديد له في مطلع عام 2015.
لا يمكن إغفال الحديث عن دول الخليج وإيران ضمن قائمة اللاعبين الجدد في أفريقيا، بالأخص في السودان، وفي منطقة القرن الأفريقي في الصومال وإريتريا، حيث كثَّفت كلٌّ من السعودية والإمارات وجودهما العسكري هناك بالتزامن مع حرب اليمن، ويبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة شقَّت طريقها نحو الانضمام إلى نادي الكبار، بعد أن دشَّنت عمليات بناء أول قاعدة عسكرية لها في إريتريا على البحر الأحمر (أشارت تقارير حديثة إلى قيام الإمارات بتفكيك القاعدة مؤخرا)، وهو ما يعني بالضرورة تدفُّق الأموال الخليجية إلى نظام "أسياس أفورقي"، المسيطر على السلطة في إريتريا منذ حازت البلاد استقلالها عن إثيوبيا.

"جميع الحيوانات متساوون، ولكن بعضهم أكثر مساواة من بعض".
(جورج أورويل، رواية مزرعة الحيوانات)
يُخبرنا "موريس دولوناي"، سفير فرنسا السابق في الجابون، بعض التفاصيل حول طبيعة عمل شبكات "فرانس أفريك". في البداية أعطى "شارل ديغول" رجاله في أفريقيا ما تعارفوا على تسميته حينها بـ "الضوء البرتقالي"، وهو يعني رسالة ضمنية من ديجول مفادها: "افعلوا ما ترونه مناسبا، إذا نجحتم فسوف أدعمكم، وإذا فشلتم فأنا لا أعرف شيئا عنكم". يبدو إذن أن درس "الضوء البرتقالي" هو أهم ما يجب أن يتعلَّمه الشباب الأفريقي عن تاريخهم القريب، ففي الوقت الذي تمضي فيه أفريقيا الشابة في طريقها نحو الحرية، فإنها لن تعدم أن تسمع تلك الدعوات التي تشيد بحق الأفارقة في الحرية والتنمية والحكم التمثيلي والفرص العادلة. ولكن كما يُعلِّمنا التاريخ، فإن بعض الشعوب تبقى أكثر مساواة من بعض، والضوء البرتقالي حاضر دوما في الخلفية من أجل حماية المصالح العالمية، وآلات القمع جاهزة ومُعدَّة، والتجارب تُعلِّمنا أن الشعوب الطامحة ليس لها حلفاء إلا أنفسها.
حين تدخَّلت فرنسا للإطاحة بديكتاتور أبيدجان لوران غباغبو مطلع العقد السابق، وتثبيت الرئيس الجديد المنتخب الحسن واتارا، الذي يحكم البلاد إلى اليوم، فإنها لم تكن تضع نصب عينيها سوى مصالحها، فلا تزال باريس إلى اليوم لا تشعر بالكثير من الارتياح مع وجود رئيس مُعادٍ لها في إحدى مستعمراتها السابقة، وهي التي تورَّطت سلفا في اغتيال أو الإطاحة بـ 22 رئيسا أو رئيس وزراء أفريقي لضمان مصالحها. وعلى الرغم من أن فرنسا اليوم ليست فرنسا الأمس، وشبكات فرانس أفريك، أيًّا كان اسمها اليوم، هي في أفضل الأحوال نسخة باهتة من عصرها الذهبي، فإن حظ أفريقيا مع الغرب لا يبدو أفضل حالا، في ظل عالم كان يحكم القوة الأكبر فيه، الولايات المتحدة، حتى وقت قريب رجل يظن أن أكثر ما تستحقه أفريقيا هو قرن جديد من الاستعمار، بينما تُصِرُّ أفريقيا الشابة على المُضي قُدما في طريقها، منفردة، كما اعتادت دائما.
--------------------------------------------------------------------------------------------------