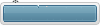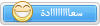تثبيت التطبيق
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
كل عام ومحمد نور عيوننا
- بادئ الموضوع "المغوار"
- تاريخ البدء
- الحالة
- مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عليه الصلاة و السلام......لكن
"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
وبعد: لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين قدر عظيم، فهم يحبونه ويوقرونه ويعظمونه أكثر من أهليهم وأولادهم بل حتى من أنفسهم …… لكن هذا الحب لابد أن يقترن بمتابعةٍ لسنته عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم، كما قال الحق سبحانه وتعالى : "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".[آل عمران:31] ومن المعروف عندنا معاشر المسلمين أنه لا يوجد شخص قد أحب نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل: حب أصحابه الكرام رضوان الله عليهم له، وقصصهم في التفاني في حبه معروفة مدونة في كتب السنة والسيرة، حتى كان الواحد منهم إذا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أهله وأولاده يتركهم ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقاً إليه.
القول بأن الاحتفال بالمولد بدعة منكرة قول صائب ؛ وذلك لأنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بيوم مولده ، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، مع أن سبب الاحتفال بالمولد موجود، ومع ذلك لم يفعلوه ولم يفعله من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، ولو كان في مثل هذه الاحتفالات خير لفعله الصحابة، ولأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذه الاحتفالات ليست بمشروعة، وأنها من الأمور المحدثة، وأول من أحدثها هم الفاطميون في القرن السادس الهجري عند ظهور الدولة الفاطمية. (العبيديون) وقد كانت تصرفاتهم مشبوهة، ومن العلماء من أخرجهم من الملة ولا شك في ضلالهم وبعدهم عن منهج السلف الصالح، نسأل الله العافية والثبات على السنة والبعد عن البدعة ، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). والله تعالى أعلم
"
"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
وبعد: لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين قدر عظيم، فهم يحبونه ويوقرونه ويعظمونه أكثر من أهليهم وأولادهم بل حتى من أنفسهم …… لكن هذا الحب لابد أن يقترن بمتابعةٍ لسنته عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم، كما قال الحق سبحانه وتعالى : "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".[آل عمران:31] ومن المعروف عندنا معاشر المسلمين أنه لا يوجد شخص قد أحب نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل: حب أصحابه الكرام رضوان الله عليهم له، وقصصهم في التفاني في حبه معروفة مدونة في كتب السنة والسيرة، حتى كان الواحد منهم إذا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أهله وأولاده يتركهم ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقاً إليه.
القول بأن الاحتفال بالمولد بدعة منكرة قول صائب ؛ وذلك لأنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بيوم مولده ، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، مع أن سبب الاحتفال بالمولد موجود، ومع ذلك لم يفعلوه ولم يفعله من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، ولو كان في مثل هذه الاحتفالات خير لفعله الصحابة، ولأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذه الاحتفالات ليست بمشروعة، وأنها من الأمور المحدثة، وأول من أحدثها هم الفاطميون في القرن السادس الهجري عند ظهور الدولة الفاطمية. (العبيديون) وقد كانت تصرفاتهم مشبوهة، ومن العلماء من أخرجهم من الملة ولا شك في ضلالهم وبعدهم عن منهج السلف الصالح، نسأل الله العافية والثبات على السنة والبعد عن البدعة ، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). والله تعالى أعلم
"
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
هو ليس احتفال بقدر ما هو تهنئة للجميع اخي العزيز
عليه افضل الصلاة و اتم التسليم ..
كل عام و كل الامة الاسلامية بخير و سلام و أمان ..
كل عام و كل الامة الاسلامية بخير و سلام و أمان ..
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد عدد ما سبح طير وطار وعدد ما تعاقب ليل ونهار وصلي عليه عدد حبات الرمل والتراب وصلي عليه عدد ما أشرق شمس النهار
حذَّر مُفتي عام المملكة، رئيس هيئة كِبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، من بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.
هيئة كِبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، من بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.
وقال مُفتي المملكة: "فلنحذر من الغلو فيه ولنعلم أن هذه الموالد وأمثالها من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن المحبة الصادقة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكون بالاتباع والاقتداء والتأسي به - صلى الله عليه وسلم - حيث قال تعالى "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّه وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبكُمْ وَاَللَّه غَفُور رَحِيم".
وأضاف المُفتي في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم، بجامع الإمام تركي بن عبد الله بمنطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض: "صلة المرء بنبيه - عليه الصلاة والسلام - صلة وثيقة على الدوام في ليله ونهاره وسره وجهره وفي منامه ويقظته وفي كل أحواله؛ حيث قال تعالي "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً".
وأردف: "من الخطأ أن يرى بعض المسلمين أن المحبة الصادقة تتمثل في ليلةٍ واحدةٍ من ليالي العام؛ يقولون فيها أذكاراً خاصّة وقصائد معيّنة؛ لأن هذا لم يكن موجوداً في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم - يعلم يوم مولده ويوم بعثه أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم - ومع ذلك لم يقيموا لذلك وزناً؛ لأن ما في قلوبهم من محبتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق هذه الأمور كلها، وكانت محبتهم محبة صادقة من اتباع السنة والعمل بها وتطبيقها والدفاع عنها".
وتابع: "محمد - صلى الله عليه وسلم - بُعث ليدلنا على الله، ويعرّفنا بالله، ويدعونا إليه، ولقد حذّرنا النبي - صلي الله عليه وسلم - من الغلو فيه والدليل قوله صلي الله وسلم "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله".
وعدّد المُفتي عبد العزيز آل الشيخ، حقوق النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا، من بينها: إيماننا به وأنه عبد الله ورسوله؛ أرسله الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وطاعته ومحبته وتوقيره أن نعلي سنته والدفاع عنها، ومحبته المحبة الصادقة المتمثّلة باتباع سنته - صلى الله عليه وسلم - والعمل بها واجتناب ما نهى عنه - عليه الصلاة والسلام، والرضا بحكمه والاستسلام له، وألا يقع حرجٌ من قضائه - صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أهمية الإكثار من ذكره والصلاة عليه - صلى الله عليه سلم، والشوق إلى لقائه، وردّ الشُبه عن سنته - صلى الله عليه وسلم -، ومحبة أنصاره وأهل بيته محبة صادقة في ذات الله لا غلو فيها، وبغض مَن يعادي الله ورسوله.
واختتم بقوله: "محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ واجبٌ، وهي من أصل الإيمان وكماله، ولا بد أن تكون محبته صادقةً وفوق محبة النفس والأهل والناس أجمعين، وذلك من خلال اتباع شريعته والعمل بها وتعظيمها بدلاً من الغلو في ذلك والكذب والافتراء
 هيئة كِبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، من بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.
هيئة كِبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، من بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.وقال مُفتي المملكة: "فلنحذر من الغلو فيه ولنعلم أن هذه الموالد وأمثالها من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن المحبة الصادقة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكون بالاتباع والاقتداء والتأسي به - صلى الله عليه وسلم - حيث قال تعالى "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّه وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبكُمْ وَاَللَّه غَفُور رَحِيم".
وأضاف المُفتي في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم، بجامع الإمام تركي بن عبد الله بمنطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض: "صلة المرء بنبيه - عليه الصلاة والسلام - صلة وثيقة على الدوام في ليله ونهاره وسره وجهره وفي منامه ويقظته وفي كل أحواله؛ حيث قال تعالي "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً".
وأردف: "من الخطأ أن يرى بعض المسلمين أن المحبة الصادقة تتمثل في ليلةٍ واحدةٍ من ليالي العام؛ يقولون فيها أذكاراً خاصّة وقصائد معيّنة؛ لأن هذا لم يكن موجوداً في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم - يعلم يوم مولده ويوم بعثه أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم - ومع ذلك لم يقيموا لذلك وزناً؛ لأن ما في قلوبهم من محبتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق هذه الأمور كلها، وكانت محبتهم محبة صادقة من اتباع السنة والعمل بها وتطبيقها والدفاع عنها".
وتابع: "محمد - صلى الله عليه وسلم - بُعث ليدلنا على الله، ويعرّفنا بالله، ويدعونا إليه، ولقد حذّرنا النبي - صلي الله عليه وسلم - من الغلو فيه والدليل قوله صلي الله وسلم "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله".
وعدّد المُفتي عبد العزيز آل الشيخ، حقوق النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا، من بينها: إيماننا به وأنه عبد الله ورسوله؛ أرسله الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وطاعته ومحبته وتوقيره أن نعلي سنته والدفاع عنها، ومحبته المحبة الصادقة المتمثّلة باتباع سنته - صلى الله عليه وسلم - والعمل بها واجتناب ما نهى عنه - عليه الصلاة والسلام، والرضا بحكمه والاستسلام له، وألا يقع حرجٌ من قضائه - صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أهمية الإكثار من ذكره والصلاة عليه - صلى الله عليه سلم، والشوق إلى لقائه، وردّ الشُبه عن سنته - صلى الله عليه وسلم -، ومحبة أنصاره وأهل بيته محبة صادقة في ذات الله لا غلو فيها، وبغض مَن يعادي الله ورسوله.
واختتم بقوله: "محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ واجبٌ، وهي من أصل الإيمان وكماله، ولا بد أن تكون محبته صادقةً وفوق محبة النفس والأهل والناس أجمعين، وذلك من خلال اتباع شريعته والعمل بها وتعظيمها بدلاً من الغلو في ذلك والكذب والافتراء
صل عليك الله يا علم الهدى يا نور الطريق إلى الحق المبين
صل عليك الله وسلم تسليما كثيرا وعلى من تبعك و والاك وصدقك
وكتب الله الهداية لمن في قلوبهم شك أو كفر بأمرك الهادي الحكيم الرشيد.
صل عليك الله يا علم الهدى يا نور ابن آدم الساري لآخر الزمان ... اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ورسولك صل الله عليه وسلم.
اللهم أهد من قلبه ذرة واحدة من حب للحق بصدق اللهم أجعل تلك الذرة وكأنها جبلا في قلبه ورده إليك مرد غير مخزي ولا فاضح و وحد أمتك وأهد من كتبت له الهداية من شعوب الأرض كلها وأنشر السلام والحق والصدق وحب الحق بين البشر جميعا ... والحمد لله رب العالمين.
وصل الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صل عليك الله وسلم تسليما كثيرا وعلى من تبعك و والاك وصدقك
وكتب الله الهداية لمن في قلوبهم شك أو كفر بأمرك الهادي الحكيم الرشيد.
صل عليك الله يا علم الهدى يا نور ابن آدم الساري لآخر الزمان ... اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ورسولك صل الله عليه وسلم.
اللهم أهد من قلبه ذرة واحدة من حب للحق بصدق اللهم أجعل تلك الذرة وكأنها جبلا في قلبه ورده إليك مرد غير مخزي ولا فاضح و وحد أمتك وأهد من كتبت له الهداية من شعوب الأرض كلها وأنشر السلام والحق والصدق وحب الحق بين البشر جميعا ... والحمد لله رب العالمين.
وصل الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل من حرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
هل انتم افضل من صلاح الدين الايوبي
وسليمان القانوني و عبدالقادر الجزائري
وعمر المختار اعظم المجاهدين و كبار قادة العالم الاسلامي كانوا يحتفلون بالمولد الشريف .
هل يستطيع مفتي عام المملكة ان يحرم اليوم الوطني وهل يستطيع ان يقول اليوم الوطني بدعه !!!
هل انتم افضل من صلاح الدين الايوبي
وسليمان القانوني و عبدالقادر الجزائري
وعمر المختار اعظم المجاهدين و كبار قادة العالم الاسلامي كانوا يحتفلون بالمولد الشريف .
هل يستطيع مفتي عام المملكة ان يحرم اليوم الوطني وهل يستطيع ان يقول اليوم الوطني بدعه !!!
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واجمعين
قولو وريا امين يارب العالمين
قولو وريا امين يارب العالمين
أللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واجمعين
كل من حرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
هل انتم افضل من صلاح الدين الايوبي
وسليمان القانوني و عبدالقادر الجزائري
وعمر المختار اعظم المجاهدين و كبار قادة العالم الاسلامي كانوا يحتفلون بالمولد الشريف .
هل يستطيع مفتي عام المملكة ان يحرم اليوم الوطني وهل يستطيع ان يقول اليوم الوطني بدعه !!!
اسألة تستطيع ان تتصل على برنامج يأتي على قناة المجد يوم الجمعه في المساء
وقل له هل يجوز الاحتفال بعيد غير عيدي الاضحى والفطر
او ماحكم الاحتفال بعيد غير عيدي الاضحى والفطر هل هو بدعه ام لا
ومن هم
صلاح الدين الايوبي
وسليمان القانوني و عبدالقادر الجزائري وعمر المختار
هل هم افضل من ابوبكر وعمر وعثمان وعلي
ونعلم ان اشد حب للرسول صلى الله عليه وسلم ابوبكر ومع ذالك لم يحتفل بمولده
قال ابن مسعود : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
عزيزي المشكله مو في الاحتفال الذي يحدث الان
المشكله بعد 100 سنه او اقل سوف يخرجون لك ناس يتفننون في البدع الشركية واخشى ان يصل بهم المطالف الى عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم
انظر الى الصوفية كيف نشأة وكيف اصبحت اليوم والله اعلم ماذا يفعلون في المستقبل
لا فرق بين الاحتفال بالمولد والاحتفال باليوم الوطني، كما قرر أهل العلم، وإليك ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في هذا الأمر، (فتوى رقم 9403- 3/59).كل من حرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
هل انتم افضل من صلاح الدين الايوبي
وسليمان القانوني و عبدالقادر الجزائري
وعمر المختار اعظم المجاهدين و كبار قادة العالم الاسلامي كانوا يحتفلون بالمولد الشريف .
هل يستطيع مفتي عام المملكة ان يحرم اليوم الوطني وهل يستطيع ان يقول اليوم الوطني بدعه !!!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أولاً: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أموراً منها: يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها: الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها: الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.
ثانياً: ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد، وعيد الأم، والعيد الوطني، لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار، وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً لمصلحة الأمة وضبط أمورها، كأسبوع المرور، وتنظيم مواعيد الدراسة، والاجتماع بالموظفين للعمل، ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فلا حرج فيه بل يكون مشروعاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم.
نعم هناك من افضل واتقى واهدى من صلاح الدين وعمر المختار وعبد القادر الجزائري الله يرحمهم
انهم الصحابة والتابعين لم يحتفلو يوم بمولدة لان حب المصطفى يكون بالاتباعة وليس ابتداع يوم لايأمر به
التعديل الأخير:
بين الأعياد الشرعية والأعياد البدعية
أيها المسلمون:
من رحمة الله تعالى بعباده، وتفضله على هذه الأمة الفاضلة المباركة أن شرع لها العيدين الكبيرين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعل عيدها الأسبوعي الجمعة، وهداها لهذه الأعياد المباركة بعد أن ضلت عنها الأمم الضالة، وجعل العيدين الحوليين عوضًا وبدلاً عن أيام الجاهلية وأعيادها.
روى أنس - رضي الله عنه - فقال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟!"، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما؛ يوم الأضحى ويوم الفطر". رواه أبو داود.
وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- قال - عليه الصلاة والسلام -: "إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا". رواه مسلم.
وفي حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام". رواه أبو داود.
وهذه الأحاديث تفيد أن الأعياد ليست من العوائد التي يتواطأ الناس عليها فحسب، حتى يشرع الناس فيها ما يشرعون، ويخترعون منها ما يخترعون، ويتبعون غيرهم فيها، ولكن الأعياد من الدين والشرائع، فوجب الوقوف فيها وفي شعائرها عند النصوص، وكل عيد يخترع، أو يوم يعظم لم يرد في الشرع أنه عيد فهو من أمر الجاهلية، ولو ساغ للناس أن يخترعوا أعيادًا من عند أنفسهم لأقرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة على اليومين الجاهليين اللذين كانا عيدًا لهم، ولو كان كذلك لما أخبرهم أن الله تعالى قد أبدلهم بهما العيدين الشرعيين؛ والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه.
وهكذا عمل أهل الصدر الأول من المسلمين حتى ماتت في مجتمعاتهم كل الأعياد والأيام التي اعتادوها في جاهليتهم؛ امتثالاً لأمر الله تعالى، واكتفاءً بما شرعه لهم من أعياد عما أحدثه الناس وابتدعوه.
إن كل عيد يصاحبه - ولابد - جملة من الاحتفالات والشعائر والمراسم، وهذا عند كل الأمم السابقة والحاضرة، ويتضمن ذلك تعظيم اليوم الذي يتخذ عيدًا، لميزة تميز بها حسب شريعة، أو عادة من اتخذوه عيدًا، وأعياد أهل الإسلام قد توجت بأعظم الشعائر الربانية التي فيها صلاح البشرية، فعيد الأسبوع تضمن خطبة الجمعة وصلاتها، وما في التبكير إليها وحضورها من الفضل العظيم، وفضائل الجمعة في الشريعة كثيرة، وخصائصه من بين أيام الأسبوع عديدة، فاستحق أن يكون عيدًا لأن الله تعالى قد رضيه للمسلمين عيدًا.
وعيد الفطر قد توج بشهر الصوم رابع أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام، فاستحق أن يكون عيدًا لأن الله تعالى شرعه للمسلمين عيدًا، يفرحون فيه بطاعة ربهم، وإتمام صيامهم، ويشكرون فيه المنعم عليهم.
وعيد الأضحى قد توج بالنسك الأعظم، والحج الأكبر، خامس أركان الإسلام، وكان خاتمة أيام هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، فاستحق أن يكون عيدًا لأن الله تعالى جعله للمسلمين عيدًا.
وأي أعياد غيرها، أو أيام من السنة تعظم وتتخذ عيدًا، وترسم لها المراسم، ويحتفل الناس فيها، فهي من أمر الجاهلية، ولا يحبها الله تعالى لعباده، ولا يرضاها لهم أعيادًا، سواء أتعلقت بذكريات أشخاص عظماء، أم معارك خالدة، أم أوطان عزيزة، أم غير ذلك، ولو جاز أن يتخذ للأشخاص عيد لكان أحق الناس بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي ما وطئ الثرى خير منه، ولا لأحد من الناس علينا من الفضل كفضله، ومع ذلك ما أمر أن يُتَّخَذَ له عيد، ولا فعله الصحابة - رضي الله عنهم - مع عظيم محبتهم وتوقيرهم له.
ولو جاز أن يتخذ للمعارك عيد لكانت غزوة بدر أولى المعارك بذلك؛ إذ هي أعظم معركة في التاريخ البشري كله، وأول فرقان بين الحق والباطل في هذه الأمة.
ولو جاز أن يتخذ للأوطان أعياد لكان قيام دولة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة أولى بذلك من غيرها، بعد أن هاجر المهاجرون، وتآخى المسلمون، وصار لهم شوكة وقوة.
وما منع من اتخاذ تلك الأيام الخالدة في الإسلام أعيادًا إلا لأن الله تعالى لم يرتضها للمسلمين أعيادًا، فتركها المسلمون مع عظيم محبتهم لها، وشغفهم بها؛ طاعة لله تعالى، ورضًا بما شرعه لهم من الأعياد العظيمة المباركة، واكتفاءً بها عن أي أعياد أخرى مهما كانت، فلهم الأجر الكبير على الطاعة والاتباع، كما أن لغيرهم الوزر والإثم على المخالفة والابتداع.
إن حب الأوطان، والإخلاص لها، وصدق الانتماء إليها، لن يكون بابتداع ما لم يأذن به الله تعالى، ومخالفة أمره، وإنما يكون ذلك باتباع شرعه سبحانه، وإقامة دينه، ومجانبة معصيته، وطاعة الولاة في المعروف، والصدق في النصح لهم، وعدم مجاملتهم أو مداهنتهم في الحق، ودلالتهم على البر، ونهيهم عن الإثم.
إن حب الأوطان، وصدق الانتماء إليها يكون في التناصح بين الراعي والرعية، والتواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، ولا خير في رعية لا يبذلون النصح لولاتهم، ولا خير في ولاة لا يقبلون نصح الناصحين من رعاياهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة"، قالوا: لمن؟! قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". رواه مسلم.
إن حب الأوطان لا يكون إلا بالسعي فيما يصلحها، ولا إصلاح إلا في دين الله تعالى، ووفق شريعته، وكل ما عارض الشريعة فليس بإصلاح، ولكنه الفساد والإفساد.
إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم أكبر أمرًا، وأعلى شأنًا من مجرد التعلق بتراب أو حصى، أو رسم أيام لذلك.
إنها عقد وثيق، وميثاق غليظ، على التعاضد والتعاون، والنصح والنصرة، والسمع والطاعة، ولزوم الجماعة.
ومن أراد حصر العلاقة بين الحاكم والمحكوم في تراب وحصى، واختزالها في أيام يحتفى بها فيها، فهو يضعفها ويصدعها، ويفرغها من مضامينها الشرعية
ومن خان الله تعالى فطرح دينه، ورام تبديل شريعته، فخيانته لغير الله تعالى أهون، وبيعه لوطنيته التي يصيح بها أجدر وأحرى، ولا مبدأ لديه وإنما هو مع من يدفع أكثر.
حمى الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين من شرور أصحاب هذه التوجهات المشبوهة، والأفكار المنحرفة، ورد كيدهم عليهم.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/spotlight/0/58560/#ixzz3NkIkuVuJ
أيها المسلمون:
من رحمة الله تعالى بعباده، وتفضله على هذه الأمة الفاضلة المباركة أن شرع لها العيدين الكبيرين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعل عيدها الأسبوعي الجمعة، وهداها لهذه الأعياد المباركة بعد أن ضلت عنها الأمم الضالة، وجعل العيدين الحوليين عوضًا وبدلاً عن أيام الجاهلية وأعيادها.
روى أنس - رضي الله عنه - فقال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟!"، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما؛ يوم الأضحى ويوم الفطر". رواه أبو داود.
وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- قال - عليه الصلاة والسلام -: "إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا". رواه مسلم.
وفي حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام". رواه أبو داود.
وهذه الأحاديث تفيد أن الأعياد ليست من العوائد التي يتواطأ الناس عليها فحسب، حتى يشرع الناس فيها ما يشرعون، ويخترعون منها ما يخترعون، ويتبعون غيرهم فيها، ولكن الأعياد من الدين والشرائع، فوجب الوقوف فيها وفي شعائرها عند النصوص، وكل عيد يخترع، أو يوم يعظم لم يرد في الشرع أنه عيد فهو من أمر الجاهلية، ولو ساغ للناس أن يخترعوا أعيادًا من عند أنفسهم لأقرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة على اليومين الجاهليين اللذين كانا عيدًا لهم، ولو كان كذلك لما أخبرهم أن الله تعالى قد أبدلهم بهما العيدين الشرعيين؛ والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه.
وهكذا عمل أهل الصدر الأول من المسلمين حتى ماتت في مجتمعاتهم كل الأعياد والأيام التي اعتادوها في جاهليتهم؛ امتثالاً لأمر الله تعالى، واكتفاءً بما شرعه لهم من أعياد عما أحدثه الناس وابتدعوه.
إن كل عيد يصاحبه - ولابد - جملة من الاحتفالات والشعائر والمراسم، وهذا عند كل الأمم السابقة والحاضرة، ويتضمن ذلك تعظيم اليوم الذي يتخذ عيدًا، لميزة تميز بها حسب شريعة، أو عادة من اتخذوه عيدًا، وأعياد أهل الإسلام قد توجت بأعظم الشعائر الربانية التي فيها صلاح البشرية، فعيد الأسبوع تضمن خطبة الجمعة وصلاتها، وما في التبكير إليها وحضورها من الفضل العظيم، وفضائل الجمعة في الشريعة كثيرة، وخصائصه من بين أيام الأسبوع عديدة، فاستحق أن يكون عيدًا لأن الله تعالى قد رضيه للمسلمين عيدًا.
وعيد الفطر قد توج بشهر الصوم رابع أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام، فاستحق أن يكون عيدًا لأن الله تعالى شرعه للمسلمين عيدًا، يفرحون فيه بطاعة ربهم، وإتمام صيامهم، ويشكرون فيه المنعم عليهم.
وعيد الأضحى قد توج بالنسك الأعظم، والحج الأكبر، خامس أركان الإسلام، وكان خاتمة أيام هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، فاستحق أن يكون عيدًا لأن الله تعالى جعله للمسلمين عيدًا.
وأي أعياد غيرها، أو أيام من السنة تعظم وتتخذ عيدًا، وترسم لها المراسم، ويحتفل الناس فيها، فهي من أمر الجاهلية، ولا يحبها الله تعالى لعباده، ولا يرضاها لهم أعيادًا، سواء أتعلقت بذكريات أشخاص عظماء، أم معارك خالدة، أم أوطان عزيزة، أم غير ذلك، ولو جاز أن يتخذ للأشخاص عيد لكان أحق الناس بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الذي ما وطئ الثرى خير منه، ولا لأحد من الناس علينا من الفضل كفضله، ومع ذلك ما أمر أن يُتَّخَذَ له عيد، ولا فعله الصحابة - رضي الله عنهم - مع عظيم محبتهم وتوقيرهم له.
ولو جاز أن يتخذ للمعارك عيد لكانت غزوة بدر أولى المعارك بذلك؛ إذ هي أعظم معركة في التاريخ البشري كله، وأول فرقان بين الحق والباطل في هذه الأمة.
ولو جاز أن يتخذ للأوطان أعياد لكان قيام دولة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة أولى بذلك من غيرها، بعد أن هاجر المهاجرون، وتآخى المسلمون، وصار لهم شوكة وقوة.
وما منع من اتخاذ تلك الأيام الخالدة في الإسلام أعيادًا إلا لأن الله تعالى لم يرتضها للمسلمين أعيادًا، فتركها المسلمون مع عظيم محبتهم لها، وشغفهم بها؛ طاعة لله تعالى، ورضًا بما شرعه لهم من الأعياد العظيمة المباركة، واكتفاءً بها عن أي أعياد أخرى مهما كانت، فلهم الأجر الكبير على الطاعة والاتباع، كما أن لغيرهم الوزر والإثم على المخالفة والابتداع.
إن حب الأوطان، والإخلاص لها، وصدق الانتماء إليها، لن يكون بابتداع ما لم يأذن به الله تعالى، ومخالفة أمره، وإنما يكون ذلك باتباع شرعه سبحانه، وإقامة دينه، ومجانبة معصيته، وطاعة الولاة في المعروف، والصدق في النصح لهم، وعدم مجاملتهم أو مداهنتهم في الحق، ودلالتهم على البر، ونهيهم عن الإثم.
إن حب الأوطان، وصدق الانتماء إليها يكون في التناصح بين الراعي والرعية، والتواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، ولا خير في رعية لا يبذلون النصح لولاتهم، ولا خير في ولاة لا يقبلون نصح الناصحين من رعاياهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة"، قالوا: لمن؟! قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". رواه مسلم.
إن حب الأوطان لا يكون إلا بالسعي فيما يصلحها، ولا إصلاح إلا في دين الله تعالى، ووفق شريعته، وكل ما عارض الشريعة فليس بإصلاح، ولكنه الفساد والإفساد.
إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم أكبر أمرًا، وأعلى شأنًا من مجرد التعلق بتراب أو حصى، أو رسم أيام لذلك.
إنها عقد وثيق، وميثاق غليظ، على التعاضد والتعاون، والنصح والنصرة، والسمع والطاعة، ولزوم الجماعة.
ومن أراد حصر العلاقة بين الحاكم والمحكوم في تراب وحصى، واختزالها في أيام يحتفى بها فيها، فهو يضعفها ويصدعها، ويفرغها من مضامينها الشرعية
ومن خان الله تعالى فطرح دينه، ورام تبديل شريعته، فخيانته لغير الله تعالى أهون، وبيعه لوطنيته التي يصيح بها أجدر وأحرى، ولا مبدأ لديه وإنما هو مع من يدفع أكثر.
حمى الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين من شرور أصحاب هذه التوجهات المشبوهة، والأفكار المنحرفة، ورد كيدهم عليهم.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/spotlight/0/58560/#ixzz3NkIkuVuJ
- الحالة
- مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
المواضيع المشابهة
- الردود
- 0
- المشاهدات
- 250
- الردود
- 0
- المشاهدات
- 273
- الردود
- 1
- المشاهدات
- 327
- الردود
- 8
- المشاهدات
- 789