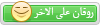دارفور: جذور المأساة:
---------------------------
تمثّل دارفور اليوم إحدى أكثر التجارب الإفريقية تعقيدا في فهم واستيعاب العلاقة بين التاريخ والعنف، ذلك أن الأزمة التي انفجرت على شكل حرب إثنيةٍ مدمرة ليست سوى الطور الأخير في مسار تاريخي طويل أعاد تعريف الإنسان والمجال والسلطة داخل بنية استعمارية لم تفكك بعد. بل تم إعادة إنتاجها في الدولة التي ظنت أنها تحررت من الاستعمار، نتيجة جهل وطمع النخب المستبطنة للمفاهيم الاستعمارية.
إنّ فهم جذور هذه المأساة لا يعني العودة إلى الماضي فحسب، بل تفكيك الآليات التي جعلت من العنف لغة لإدارة الاختلاف، ومن الهوية أداة للسيطرة السياسية، فالأزمة السودانية لا تفكك وتحل إلا بفهمها من منطق التكوين التاريخي الذي أنتجها، لا من منطق الحدث الذي فجّرها، وهذه الفقرات محاولة لتقديم جينيالوجيا الأزمة وإبراز تناسل العنف من مرحلة لأخرى، وتغذيه من الفشل المستمر الذي يعيد إنتاج المشكلة بل يعمقها عندما يضيف لها ما يعزز انتقاما جديدا.
من الخطأ النظر إلى دارفور كحرب قبلية أو نزاع عسكري على السلطة فحسب، فالإقليم لم يخلق في الحرب، بل تم إنتاجه في عملية متواصلة من "الترسيم المعرفي" الذي مارسه الاستعمار البريطاني، حين رسم حدود الإقليم والهوية معا في الوقت ذاته، وقد كانت لحظة الإلحاق بالسودان الإنجليزي–المصري عام 1916 نقطة التحول الكبرى، فقد واجه البريطانيون فضاء هشّا سياسيا لكنه متماسك عرفيا، فاختاروا تحويل العرف إلى نظام إداري والقبيلة إلى وحدة حكم محلية ليمكنهم ضبطه والسيطرة عليه.
لقد كان الحكم غير المباشر مشروعا معرفيا قبل أن يكون تقنيا كما شرح ذلك بعمق محمود ممداني في كتابيه: دارفور منقذونوناجون؛ لا مستوطن ولا مواطن؛ فقد أعاد البريطانيون صياغة المجتمعات وفق تصنيفٍ أنثروبولوجي صارم: العرب بدو رحل ينتمون إلى العروبة، والفور والزغاوة والمساليت مزارعون أفارقة سود/زرق مرتبطون بالأرض، هذا التصنيف جعل العرق أساس الشرعية، وحول علاقة الإنسان بالأرض إلى علاقة بالهوية، فصار من يملك الانتماء الصحيح هو وحده صاحب الحق في الأرض، ومع أن البحث الأنثروبولوجي الذي أقامه البريطانيون على علو العرق السامي على الحامي قد فضل العربي الأبيض الذكي على السوداني المتوحش المتخلف، إلا أن الممجد معرفيا (العربي) صار مهانا ماديا (دون سلطة)، والمهان معرفيا (الإفريقي) ممكن ماديا (نظام القبيلة).
لنشرح ذلك من خلال تحليلات محمود ممداني:
يرى ممداني أن أصل المأساة في دارفور لا يكمن في العداء بين العرب والأفارقة، بل في البنية التي صنعها الاستعمار البريطاني حين أعاد تنظيم المجتمع على أسس هويّاتية، فالحكم البريطاني لم يفرض سيطرته بالقوة العسكرية وحدها، بل عبر نظام جعل من القبيلة وحدةً سياسية وإدارية، فتمّ تقسيم السكان إلى أصلاء يملكون الأرض ووافدين بلا حقوقٍ سياسية، وهو تقسيم لم يكن موجوداً بهذا الشكل في المجتمع المحلي، وبهذا أوجد الاستعمار ما يسميه ممداني "نظام المواطنة المزدوج": مواطن في المركز ورعية في الأطراف. ومنذ تلك اللحظة، تحوّل الانتماء الاجتماعي إلى قانونٍ سياسي، وصار العِرق أداة للسيطرة الإدارية.
إن ما فعله البريطانيون تجاوز حدود الإدارة إلى تصنيع الأعراق ذاتها، وذلك بتحويل القبائل إلى وحداتٍ جغرافيةٍ مغلقة – ما عُرف بنظام دار القبيلة– جعلوا الهوية شرطا للوجود السياسي، فمن لا دار له لا صوت له، ومن لا قبيلة له لا أرض له.
هنا حدث ما يسميه ممداني التسييس البنيوي للهوية، إذ لم تعد الإثنية توصيفا ثقافيا بل تصنيفا قانونيا، ومن رحم هذه البنية نشأت لاحقا ثنائيات العرب والزرقة، التي لم تكن نتاج اختلافاتٍ ثقافية طبيعية، بل إعادة إنتاجٍ سياسية لخرائط السلطة التي رسمها الاستعمار في سجلاته الإدارية.
هكذا نشأت البنية الكولونيالية التي فرّقت بين المواطن والتابع بتعبير ممداني، وجعلت من الهوية معيارا للحقوق، ومنذ تلك اللحظة بدأ تاريخ دارفور الحديث لا من فوهة البندقية بل من سجل القبائل، حيث تحوّل العرق إلى بنية سيادية تُنتج العنف باستمرار.
مع وصول جعفر نميري إلى الحكم عام 1969 ظهر مشروع تحديثي حاول كسر البنية القبلية، لكنه ما لبث أن أعاد تفعيل الإدارة الأهلية لضبط الأطراف، فخلقت هذه الازدواجية بين دولة مركزية حديثة ومجتمع قبليٍّ مُدار بالولاء فراغا في السلطة، وفي هذه الفجوة تمدّد الخطاب القومي العربي الإقليمي، خاصة مع صعود معمر القذافي في ليبيا، ذلك أن القذافي لم يتعامل مع دارفور كجوارٍ جغرافي؛ بل كامتداد أيديولوجي لمشروع الحزام العربي الذي يربط الصحراء الكبرى ببلاد النيل، في مواجهة ما اعتبره الزنوجة السياسية المدعومة من فرنسا في تشاد وإفريقيا الوسطى، وهكذا تحوّل الانتماء العربي إلى أداة حرب إقليمية، وعاد المقاتلون من الصراع الليبي-التشادي محمّلين بوعيٍ هويّاتيٍ مسلّح، فتمت عسكرة الهوية وتحويلها إلى مشروع ثأري مفتوح.
حين وصل الإسلاميون إلى السلطة عام 1989، أخذت الدولة شكلاً جديدا يجمع بين الخطاب الديني والممارسة الإثنية، إذ أن التمركز الذي بدأ منذ نميري للسلطة عند نخبة نيلية عربية جعل أقساما هامة من الفور والزواغة ينظرون لخطاب الشريعة على أنه مجرد غطاء مصلحي لدولة تمارس عنفها بلغة القبيلة، وأن قوات الدفاع الشعبي التي أنشئت لتأمين الأطراف إنما تعبر عن تحالفات أساسها الانتماء العرقي المموه بالدين.
صار منطق الحكم في السودان يقوم على معادلة بسيطة وخطيرة: المركز يهيمن بالأيديولوجيا، والطرف يراقب بالعنف، ومع تراكم الإفقار والجفاف وانسداد الأفق السياسي، اندلعت حركات المعارضة المسلحة في مطلع الألفية، فتحوّل الصراع من نزاع حول الأرض إلى صراع حول الذاكرة والهوية، وقد ردّ النظام بتسليح مليشيات الجنجويد، وهي في جوهرها إعادة تدوير لقوات قديمة داعمة للقذافي عرقيا تشربت الانتماء الهوياتي العربي ومحاولة التموقع سلطويا، فصارت الحرب مواجهة بين السودان الإفريقي والسودان العربي؛ وهي ثنائية لم يعرفها المجتمع السوداني إلا بعد أن أنتجتها الدولة الحديثة.
عندما انفجرت الحرب في 2003 لم تكن تمردا محليا بل انهياراً شاملا للشرعية الوطنية، فالمجازر التي ارتكبها الجنجويد لم تكن خارج الدولة بل تجسيدا لها في شكلها الميليشياوي أما اتفاقات أبوجا والدوحة وجوبا، فقد أعادت إنتاج النخب ذاتها بتسويات على السلطة لا على العدالة، فبقي الإقليم في حالة تهميشٍ جديدٍ بوجه قانوني.
لقد برزت بين المتمردين شخصيات رئيسية شكلت العمود الفقري للحركات المسلحة، مع مرجعيات قبلية وأيديولوجية محددة، والتذكير بها يبين آليات عرقنة السياسية وتلغيم الدولة في الطرف المقابل للجنجويد أيضا:
1- عبد الواحد محمد نور كان قائد حركة تحرير السودان، وجاء من قبائل الفور، متمركزا على الدفاع عن حقوق الأفارقة في مواجهة الجنجويد والدولة المركزية، مع خط أيديولوجي يدمج الهوية الإثنية بالعدالة السياسية.
2- خليل إبراهيم، قاد حركة العدل والمساواة، وكان ممثلاً للزغاوة، مؤسسا تنظيمه على فكرة مقاومة التهميش الاقتصادي والسياسي، مع التمسك بمبدأ المساواة بين القبائل الأفريقية والأقليات.
3- حسن أبو شمالة من قبائل المساليت، الذي لعب دورا في تنسيق الفصائل المحلية والدفاع عن مناطق المساليت ضد الجنجويد، مع تركيز على حماية الأرض والمجتمع المحلي، وكان له حضور رمزي في التحالفات مع حركة العدل والمساواة.
يضاف لمن سبق قيادات محلية صغيرة من الزغاوة والفور مثل عبد الله كاكا ومحمد ناصر، الذين كانوا مسؤولين عن تنظيم وحدات مقاتلة محلية وربط المجتمعات القبلية بالمشروع السياسي المركزي لحركات التمرد، مع إبقاء المرجعية الإثنية واضحة ضمن الاستراتيجية القتالية والسياسية.
هذه القيادات لم يكونوا مجرد زعماء عسكريين، بل حاملي مشروع سياسي- إثني يسعى لإعادة تمثيل المجتمعات الأفريقية في بنية الدولة، وكان كل منهم رمزا لمقاومة الهامشية التي رسّختها سياسات الاستعمار والدولة الوطنية اللاحقة.
بعد سقوط البشير عام 2019، تهاوت الدولة المركزية من الداخل، وبرز حميدتي بوصفه الوريث الفعلي لمنطق الجنجويد، وتحولت قوات الدعم السريع إلى رمز لاستمرار العنف كوسيلة حكم، ومع الحرب بين البرهان وحميدتي عام 2023، بدا أن الصراع في الخرطوم هو امتدادٌ لصدى دارفور القديمة بلغة جديدة وتمويل مختلف، فيما تجد القبائل الإفريقية نفسها أمام معركة وجودية ضد قوة أكثر تنظيماً وتمويلا، وهكذا يعيد التاريخ إنتاج نفسه كجريمةٍ دائريةٍ لا تنتهي.
هل هذا الصدى القادم من الماضي يفسر وحده عنف اليوم؟
في الحقيقة أن كثيرا من الماء جرى في نيل السودان، فالصراع اتخذ أبعادا جديدة أضيفت للبعد العرقي الذي يشحن ويحشد، إن تفكك الجيش في سياق صراع سياسي عنيف جعل الأزمة تتخذ صورة الصراع على السلطة والثروة والمصادر الطبيعية، فقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي -التي تمثل امتداد الجنجويد- صارت فاعلاً سياسياً مستقلا، يمتلك القدرة على التحكم في شبكات تهريب الأسلحة والذهب والمنتجات الزراعية، وقوتهم لم تعد أداة قمع محلية فقط، بل أصبحت منصة للتأثير على العاصمة والضغط على النخبة الحاكمة، وهو ما يغيّر قواعد اللعبة جذرياً مقارنة بعام 2003، وما حققوه في الفاشر يربط الماضي بالمستقبل.
في المقابل، القبائل الإفريقية الكبرى: الفور، الزغاوة، المساليت تواجه معضلة مزدوجة: التاريخ الطويل من العداء مع الجنجويد وضرورة حماية الأرض والموارد، ما يدفع بعضها أحياناً للتحالف مع الجيش النظامي بقيادة البرهان رغم الاحتكاك التاريخي، وهذه التحالفات المؤقتة تكشف عن طبيعة الصراع اليوم كشبكة مصالح معقدة، حيث الهوية الإثنية ليست العامل الوحيد، بل تستخدم أحيانا كغطاء لتأمين النفوذ والسيطرة على الموارد.
لقد تداخل الصراع المحلي مع أجندات إقليمية ودولية: الإمارات تمول وتدعّم قوات الدعم السريع، ومصر تدعم البرهان، بينما القوى الغربية تراقب من زاوية مصالح الأمن والطاقة، والدول المجاورة توازن بين الحذر والدعم الانتقائي للمجموعات المختلفة، والشعب يدفع ضريبة قاسية نتيجة إجرام عسكرييه وارتزاق نخبته، ومع أنه قد تتدخل قوى تنهي أزمة النخب، وتؤجل صراعا جديدا، لكن الحقيقة العميقة أن الأزمة في جوهرها ليست حول من يحكم السودان، بل حول من يملك الحق في أن يكون سودانيا.
إن خطابات الهوية الصدامية تستمد شرعيتها من ذاكرة الجراح لا من مشروع العدالة، ولذلك فكل تسوية سياسية لا تعالج البنية المعرفية التي شرعنت التمايز العرقي تظل مجرد هدنةٍ مؤقتة، والمخرج الحقيقي يمرّ عبر إعادة كتابة تاريخ السودان من خارج القوالب الإثنية التي فرضها الاستعمار، لأن الاستعمار لا ينتهي بخروج جيوشه، بل بخروج لغته من داخلنا.
من مفاجآت التاريخ أن النظام الاسلامي في السودان أنشأ الجنجويد وحاول تأطيرها دينيا، فكان هؤلاء في سنوات الحرب مع دارفور والجنوب بمثابة: الإخوة المجاهدون، وهاهم الاسلاميون اليوم يحاربونهم على أتهم ميليشيات مرتزقة، لأن البنية القبلية العميقة التي استثارها القذافي ورعاها التجييش القبلي أصلب من الايديولوجيا التي لم تعد مغرية منذ أن تفكك تحالف الترابي-البشير.
---------------------------
تمثّل دارفور اليوم إحدى أكثر التجارب الإفريقية تعقيدا في فهم واستيعاب العلاقة بين التاريخ والعنف، ذلك أن الأزمة التي انفجرت على شكل حرب إثنيةٍ مدمرة ليست سوى الطور الأخير في مسار تاريخي طويل أعاد تعريف الإنسان والمجال والسلطة داخل بنية استعمارية لم تفكك بعد. بل تم إعادة إنتاجها في الدولة التي ظنت أنها تحررت من الاستعمار، نتيجة جهل وطمع النخب المستبطنة للمفاهيم الاستعمارية.
إنّ فهم جذور هذه المأساة لا يعني العودة إلى الماضي فحسب، بل تفكيك الآليات التي جعلت من العنف لغة لإدارة الاختلاف، ومن الهوية أداة للسيطرة السياسية، فالأزمة السودانية لا تفكك وتحل إلا بفهمها من منطق التكوين التاريخي الذي أنتجها، لا من منطق الحدث الذي فجّرها، وهذه الفقرات محاولة لتقديم جينيالوجيا الأزمة وإبراز تناسل العنف من مرحلة لأخرى، وتغذيه من الفشل المستمر الذي يعيد إنتاج المشكلة بل يعمقها عندما يضيف لها ما يعزز انتقاما جديدا.
من الخطأ النظر إلى دارفور كحرب قبلية أو نزاع عسكري على السلطة فحسب، فالإقليم لم يخلق في الحرب، بل تم إنتاجه في عملية متواصلة من "الترسيم المعرفي" الذي مارسه الاستعمار البريطاني، حين رسم حدود الإقليم والهوية معا في الوقت ذاته، وقد كانت لحظة الإلحاق بالسودان الإنجليزي–المصري عام 1916 نقطة التحول الكبرى، فقد واجه البريطانيون فضاء هشّا سياسيا لكنه متماسك عرفيا، فاختاروا تحويل العرف إلى نظام إداري والقبيلة إلى وحدة حكم محلية ليمكنهم ضبطه والسيطرة عليه.
لقد كان الحكم غير المباشر مشروعا معرفيا قبل أن يكون تقنيا كما شرح ذلك بعمق محمود ممداني في كتابيه: دارفور منقذونوناجون؛ لا مستوطن ولا مواطن؛ فقد أعاد البريطانيون صياغة المجتمعات وفق تصنيفٍ أنثروبولوجي صارم: العرب بدو رحل ينتمون إلى العروبة، والفور والزغاوة والمساليت مزارعون أفارقة سود/زرق مرتبطون بالأرض، هذا التصنيف جعل العرق أساس الشرعية، وحول علاقة الإنسان بالأرض إلى علاقة بالهوية، فصار من يملك الانتماء الصحيح هو وحده صاحب الحق في الأرض، ومع أن البحث الأنثروبولوجي الذي أقامه البريطانيون على علو العرق السامي على الحامي قد فضل العربي الأبيض الذكي على السوداني المتوحش المتخلف، إلا أن الممجد معرفيا (العربي) صار مهانا ماديا (دون سلطة)، والمهان معرفيا (الإفريقي) ممكن ماديا (نظام القبيلة).
لنشرح ذلك من خلال تحليلات محمود ممداني:
يرى ممداني أن أصل المأساة في دارفور لا يكمن في العداء بين العرب والأفارقة، بل في البنية التي صنعها الاستعمار البريطاني حين أعاد تنظيم المجتمع على أسس هويّاتية، فالحكم البريطاني لم يفرض سيطرته بالقوة العسكرية وحدها، بل عبر نظام جعل من القبيلة وحدةً سياسية وإدارية، فتمّ تقسيم السكان إلى أصلاء يملكون الأرض ووافدين بلا حقوقٍ سياسية، وهو تقسيم لم يكن موجوداً بهذا الشكل في المجتمع المحلي، وبهذا أوجد الاستعمار ما يسميه ممداني "نظام المواطنة المزدوج": مواطن في المركز ورعية في الأطراف. ومنذ تلك اللحظة، تحوّل الانتماء الاجتماعي إلى قانونٍ سياسي، وصار العِرق أداة للسيطرة الإدارية.
إن ما فعله البريطانيون تجاوز حدود الإدارة إلى تصنيع الأعراق ذاتها، وذلك بتحويل القبائل إلى وحداتٍ جغرافيةٍ مغلقة – ما عُرف بنظام دار القبيلة– جعلوا الهوية شرطا للوجود السياسي، فمن لا دار له لا صوت له، ومن لا قبيلة له لا أرض له.
هنا حدث ما يسميه ممداني التسييس البنيوي للهوية، إذ لم تعد الإثنية توصيفا ثقافيا بل تصنيفا قانونيا، ومن رحم هذه البنية نشأت لاحقا ثنائيات العرب والزرقة، التي لم تكن نتاج اختلافاتٍ ثقافية طبيعية، بل إعادة إنتاجٍ سياسية لخرائط السلطة التي رسمها الاستعمار في سجلاته الإدارية.
هكذا نشأت البنية الكولونيالية التي فرّقت بين المواطن والتابع بتعبير ممداني، وجعلت من الهوية معيارا للحقوق، ومنذ تلك اللحظة بدأ تاريخ دارفور الحديث لا من فوهة البندقية بل من سجل القبائل، حيث تحوّل العرق إلى بنية سيادية تُنتج العنف باستمرار.
مع وصول جعفر نميري إلى الحكم عام 1969 ظهر مشروع تحديثي حاول كسر البنية القبلية، لكنه ما لبث أن أعاد تفعيل الإدارة الأهلية لضبط الأطراف، فخلقت هذه الازدواجية بين دولة مركزية حديثة ومجتمع قبليٍّ مُدار بالولاء فراغا في السلطة، وفي هذه الفجوة تمدّد الخطاب القومي العربي الإقليمي، خاصة مع صعود معمر القذافي في ليبيا، ذلك أن القذافي لم يتعامل مع دارفور كجوارٍ جغرافي؛ بل كامتداد أيديولوجي لمشروع الحزام العربي الذي يربط الصحراء الكبرى ببلاد النيل، في مواجهة ما اعتبره الزنوجة السياسية المدعومة من فرنسا في تشاد وإفريقيا الوسطى، وهكذا تحوّل الانتماء العربي إلى أداة حرب إقليمية، وعاد المقاتلون من الصراع الليبي-التشادي محمّلين بوعيٍ هويّاتيٍ مسلّح، فتمت عسكرة الهوية وتحويلها إلى مشروع ثأري مفتوح.
حين وصل الإسلاميون إلى السلطة عام 1989، أخذت الدولة شكلاً جديدا يجمع بين الخطاب الديني والممارسة الإثنية، إذ أن التمركز الذي بدأ منذ نميري للسلطة عند نخبة نيلية عربية جعل أقساما هامة من الفور والزواغة ينظرون لخطاب الشريعة على أنه مجرد غطاء مصلحي لدولة تمارس عنفها بلغة القبيلة، وأن قوات الدفاع الشعبي التي أنشئت لتأمين الأطراف إنما تعبر عن تحالفات أساسها الانتماء العرقي المموه بالدين.
صار منطق الحكم في السودان يقوم على معادلة بسيطة وخطيرة: المركز يهيمن بالأيديولوجيا، والطرف يراقب بالعنف، ومع تراكم الإفقار والجفاف وانسداد الأفق السياسي، اندلعت حركات المعارضة المسلحة في مطلع الألفية، فتحوّل الصراع من نزاع حول الأرض إلى صراع حول الذاكرة والهوية، وقد ردّ النظام بتسليح مليشيات الجنجويد، وهي في جوهرها إعادة تدوير لقوات قديمة داعمة للقذافي عرقيا تشربت الانتماء الهوياتي العربي ومحاولة التموقع سلطويا، فصارت الحرب مواجهة بين السودان الإفريقي والسودان العربي؛ وهي ثنائية لم يعرفها المجتمع السوداني إلا بعد أن أنتجتها الدولة الحديثة.
عندما انفجرت الحرب في 2003 لم تكن تمردا محليا بل انهياراً شاملا للشرعية الوطنية، فالمجازر التي ارتكبها الجنجويد لم تكن خارج الدولة بل تجسيدا لها في شكلها الميليشياوي أما اتفاقات أبوجا والدوحة وجوبا، فقد أعادت إنتاج النخب ذاتها بتسويات على السلطة لا على العدالة، فبقي الإقليم في حالة تهميشٍ جديدٍ بوجه قانوني.
لقد برزت بين المتمردين شخصيات رئيسية شكلت العمود الفقري للحركات المسلحة، مع مرجعيات قبلية وأيديولوجية محددة، والتذكير بها يبين آليات عرقنة السياسية وتلغيم الدولة في الطرف المقابل للجنجويد أيضا:
1- عبد الواحد محمد نور كان قائد حركة تحرير السودان، وجاء من قبائل الفور، متمركزا على الدفاع عن حقوق الأفارقة في مواجهة الجنجويد والدولة المركزية، مع خط أيديولوجي يدمج الهوية الإثنية بالعدالة السياسية.
2- خليل إبراهيم، قاد حركة العدل والمساواة، وكان ممثلاً للزغاوة، مؤسسا تنظيمه على فكرة مقاومة التهميش الاقتصادي والسياسي، مع التمسك بمبدأ المساواة بين القبائل الأفريقية والأقليات.
3- حسن أبو شمالة من قبائل المساليت، الذي لعب دورا في تنسيق الفصائل المحلية والدفاع عن مناطق المساليت ضد الجنجويد، مع تركيز على حماية الأرض والمجتمع المحلي، وكان له حضور رمزي في التحالفات مع حركة العدل والمساواة.
يضاف لمن سبق قيادات محلية صغيرة من الزغاوة والفور مثل عبد الله كاكا ومحمد ناصر، الذين كانوا مسؤولين عن تنظيم وحدات مقاتلة محلية وربط المجتمعات القبلية بالمشروع السياسي المركزي لحركات التمرد، مع إبقاء المرجعية الإثنية واضحة ضمن الاستراتيجية القتالية والسياسية.
هذه القيادات لم يكونوا مجرد زعماء عسكريين، بل حاملي مشروع سياسي- إثني يسعى لإعادة تمثيل المجتمعات الأفريقية في بنية الدولة، وكان كل منهم رمزا لمقاومة الهامشية التي رسّختها سياسات الاستعمار والدولة الوطنية اللاحقة.
بعد سقوط البشير عام 2019، تهاوت الدولة المركزية من الداخل، وبرز حميدتي بوصفه الوريث الفعلي لمنطق الجنجويد، وتحولت قوات الدعم السريع إلى رمز لاستمرار العنف كوسيلة حكم، ومع الحرب بين البرهان وحميدتي عام 2023، بدا أن الصراع في الخرطوم هو امتدادٌ لصدى دارفور القديمة بلغة جديدة وتمويل مختلف، فيما تجد القبائل الإفريقية نفسها أمام معركة وجودية ضد قوة أكثر تنظيماً وتمويلا، وهكذا يعيد التاريخ إنتاج نفسه كجريمةٍ دائريةٍ لا تنتهي.
هل هذا الصدى القادم من الماضي يفسر وحده عنف اليوم؟
في الحقيقة أن كثيرا من الماء جرى في نيل السودان، فالصراع اتخذ أبعادا جديدة أضيفت للبعد العرقي الذي يشحن ويحشد، إن تفكك الجيش في سياق صراع سياسي عنيف جعل الأزمة تتخذ صورة الصراع على السلطة والثروة والمصادر الطبيعية، فقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي -التي تمثل امتداد الجنجويد- صارت فاعلاً سياسياً مستقلا، يمتلك القدرة على التحكم في شبكات تهريب الأسلحة والذهب والمنتجات الزراعية، وقوتهم لم تعد أداة قمع محلية فقط، بل أصبحت منصة للتأثير على العاصمة والضغط على النخبة الحاكمة، وهو ما يغيّر قواعد اللعبة جذرياً مقارنة بعام 2003، وما حققوه في الفاشر يربط الماضي بالمستقبل.
في المقابل، القبائل الإفريقية الكبرى: الفور، الزغاوة، المساليت تواجه معضلة مزدوجة: التاريخ الطويل من العداء مع الجنجويد وضرورة حماية الأرض والموارد، ما يدفع بعضها أحياناً للتحالف مع الجيش النظامي بقيادة البرهان رغم الاحتكاك التاريخي، وهذه التحالفات المؤقتة تكشف عن طبيعة الصراع اليوم كشبكة مصالح معقدة، حيث الهوية الإثنية ليست العامل الوحيد، بل تستخدم أحيانا كغطاء لتأمين النفوذ والسيطرة على الموارد.
لقد تداخل الصراع المحلي مع أجندات إقليمية ودولية: الإمارات تمول وتدعّم قوات الدعم السريع، ومصر تدعم البرهان، بينما القوى الغربية تراقب من زاوية مصالح الأمن والطاقة، والدول المجاورة توازن بين الحذر والدعم الانتقائي للمجموعات المختلفة، والشعب يدفع ضريبة قاسية نتيجة إجرام عسكرييه وارتزاق نخبته، ومع أنه قد تتدخل قوى تنهي أزمة النخب، وتؤجل صراعا جديدا، لكن الحقيقة العميقة أن الأزمة في جوهرها ليست حول من يحكم السودان، بل حول من يملك الحق في أن يكون سودانيا.
إن خطابات الهوية الصدامية تستمد شرعيتها من ذاكرة الجراح لا من مشروع العدالة، ولذلك فكل تسوية سياسية لا تعالج البنية المعرفية التي شرعنت التمايز العرقي تظل مجرد هدنةٍ مؤقتة، والمخرج الحقيقي يمرّ عبر إعادة كتابة تاريخ السودان من خارج القوالب الإثنية التي فرضها الاستعمار، لأن الاستعمار لا ينتهي بخروج جيوشه، بل بخروج لغته من داخلنا.
من مفاجآت التاريخ أن النظام الاسلامي في السودان أنشأ الجنجويد وحاول تأطيرها دينيا، فكان هؤلاء في سنوات الحرب مع دارفور والجنوب بمثابة: الإخوة المجاهدون، وهاهم الاسلاميون اليوم يحاربونهم على أتهم ميليشيات مرتزقة، لأن البنية القبلية العميقة التي استثارها القذافي ورعاها التجييش القبلي أصلب من الايديولوجيا التي لم تعد مغرية منذ أن تفكك تحالف الترابي-البشير.