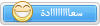تحولت إسطنبول إلى مركز عالمي لجماعة الإخوان المسلمين
لطالما اتهم الشيوعيون العرب بكونهم الأقل "ولاء" لأوطانهم وشعوبهم، وتغليبهم مصلحة "دولة المركز"، الاتحاد السوفياتي السابق، على مصالح بلدانهم، وأنهم يؤثرون تلقي "الأوامر والتعليمات" من موسكو، على بناء استراتيجيات خاصة بهم، منبثقة من صميم واقعهم "المعاش".
والحقيقة أن هذا "الاتهام" لم يكن محض افتراء، فقد نحت الحركة الشيوعية العربية فعليا طيلة سنوات الحرب الباردة، إلى التماهي مع السياسات السوفياتية والامتثال للقرارات التي كانت تصدر عن الكرملين، بما فيها تلك المتعلقة بأدق الشؤون الداخلية للأحزاب والقضايا الوطنية لبلدانها وشعوبها بدلالة إقدام الحزب الشيوعي المصري على حل نفسه إرضاء لطلب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من حلفائه السوفييت، وتدخل الراحل يفغيني بريماكوف ممثلا عن الحزب الشيوعي السوفياتي آنذاك، لحسم الخلاف داخل الحزب الشيوعي السوري في مطلع سبعينيات القرن الفائت، وغيرها كثير من الحالات المماثلة.
ستنتهي ظاهرة "الاستتباع" هذه، والتي كان يحلو للشيوعيين العرب إدراجها في سياق "الأممية البروليتارية"، مع نهاية حقبة السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، وسيسهم عاملان اثنان في رسم "خط النهاية" لهذه "الأممية"، أو بصورة أدق، إعطائها مضامين جديدة، تكاد تقتصر على "التضامن والتعاطف المتبادلين":
- ظهور "اليسار العربي الجديد" المنبثق أساسا من رحم الحركات القومية العربية والمنظمات الفلسطينية، وتنامي قدرته على مزاحمة الأحزاب الشيوعية والتأثير على برامجها وسياساتها.
- شيخوخة الاتحاد السوفياتي، ووصول "المباراة الدولية" بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي لحظة الحسم لصالح الأول، مع سقوط جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة.
هناك توجه إخواني عام، تتشاطره بعض الحركات السلفية، يعظم من دور "إسطنبول" كقيادة عالمية لمعسكر المسلمين السنة
لكن المنطقة العربية ستشهد في توقيت متزامن، نشوء نوع جديد من "الأممية"، إسلامية هذه المرة، صاحبت صعود الإسلام السياسي في المنطقة.
فإذا كانت "الأممية البروليتارية" قد استندت إلى مفهوم "وحدة الطبقة العاملة" عالميا، المعبر عنه بشعار "يا عمال العالم اتحدوا"، فإن "الأممية الإسلامية" ستسند إلى مفهوم عميق في الفكر والفلسفة الإسلاميين، وهو مفهوم "وحدة الأمة الإسلامية". ومع كلتا "الأمميتين"، ستتضاءل مكانة "المكون الوطني/القومي" في خطاب الأحزاب والحركات الأيديولوجية المستندة إلى النظريتين، الشيوعية والإسلامية.
لكن "الأممية الإسلامية" معطوفة على فهم خاص بالحركات الإسلامية، يعلي من شأن "أسلمة الفرد والمجتمع" على أية أولوية أخرى، من نوع "التحرر الوطني" و"تقرير المصير"، ما سيجعل من الحركات الإسلامية في المنطقة، في ذيل قائمة القوى والحركات الملتحقة بنضال الشعوب العربية المبكر من أجل التحرر من الاستعمار وإنجاز "الاستقلالات الوطنية". وربما توفر التجربة الفلسطينية على وجه الخصوص، النموذج الأكثر فجاجة لتجليات هذه المفاهيم وانعكاساتها على بنية وتكوين الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.
فالإخوان المسلمون في فلسطين، الذين لم يجدوا غضاضة في التماهي مع الهوية الوطنية الأردنية، والاندماج في صفوف الجماعة الإخوانية بعد وحدة الضفتين منتصف القرن الفائت، ظلوا في آخر الركب الفلسطيني المنادي باستعادة الهوية الوطنية والكيانية المستقلة للشعب الفلسطيني.
وعندما نشأت حركة حماس في نهاية العام 1987، العام الأول للانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى، لم يكن ذلك تعبيرا عن تجذر في "الوعي الوطني والقومي" لدى الجماعة، بقدر ما كان محاولة لملء الفراغ الناجم عن الهزائم المتتالية للحركة الوطنية الفلسطينية، وفي لحظة انتقال من نظام الحرب الباردة وتحالفاتها المعروفة، إلى نظام القطب الواحد، وما تميز به من بداية افتراق بين الإسلام السياسي بمنظماته ومدارسه المختلفة من جهة، والقطب العالمي الأوحد وحلفائه الإقليميين من جهة ثانية.
وبتأثير من فلسفة "الأممية الإسلامية" ومفهوم "وحدة الأمة الإسلامية"، لم يجد إسلاميو الأردن وفلسطين والعديد من الدول العربية، غضاضة أو إشكالية من أي نوع للتحشيد لـ "الجهاد العالمي" ضد الخطر الشيوعي في أفغانستان، وقد تحول بعض قادة إخوان فلسطين إلى زعماء لهذا "الجهاد العالمي" ومنظرين كبار له، من مثل الشيخ عبد الله عزام، الذي سيهجر بلدته المحتلة جنين في الضفة الغربية، إلى مدارس بيشاور وكهوف تورا بورا، على اعتبار أن مصلحة "الأمة" وأولوية أولوياتها، إنما تتجلى في "حفظ الدين" في مواجهة خطر "الشيوعية" الكافرة الزاحف... هنا تبرز أولوية "حفظ الدين" على "حفظ الأوطان" وتحررها.تستند "الأممية الإسلامية" إلى مفهوم عميق في الفكر والفلسفة الإسلاميين، وهو مفهوم "وحدة الأمة الإسلامية"
قبل أيام، أثارت تصريحات لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس والرجل المرشح بقوة لتولي منصب "المرشد العام" لجماعة الإخوان في العالم، جدلا واسعا في المنطقة، لم ينقطع أو يتوقف حتى اللحظة، حين أشاد بالاحتلال التركي لمنطقة عفرين السورية، وتمنى لتركيا الانتقال من نصر إلى آخر في سورية، مشيدا بقيادة الرئيس رجب أردوغان للعالم الإسلامي، ومثمنا الحقبة العثمانية في التاريخ العربي الحديث والمعاصر.
والحقيقة أن تصريحات مشعل تأتي انسجاما مع توجه إخواني عام، تتشاطره بعض الحركات السلفية، يعظم من دور "إسطنبول" كقيادة عالمية لمعسكر المسلمين السنة، وقد تحولت إسطنبول إلى مركز عالمي للجماعة الإخوانية المطاردة في بلدانها، وقبلة لكل الجماعات الإسلامية الأخرى، خصوصا في السنوات السبع الأخيرة، التي تميزت بارتفاع منسوب المكون الديني/المذهبي في خطاب حزب العدالة والتنمية التركي وخطابات رئيسه رجب طيب أردوغان التي لا تتوقف. علما بأن معظم هذه الحركات، سبق وأن نظرت بريبة وشك (وتشكيك) إلى تجربة الحزب في سنوات صعوده (2002 ـ 2010)، ولطالما أطلقت عليه اسم "الإسلامي الأميركي" أو "الإسلام العلماني".
وما ينطبق على الإسلام السياسي السني ينطبق بالقدر ذاته على بعض مدارس الإسلام السياسي الشيعي، والتي تدور في فلك "دولة المركز الشيعي": إيران. فخطاب هذه الحركات، يكاد يخلو تماما من مفاهيم من نوع "السيادة"، "الهوية" و"الاستقلال"، وتنظر إلى تعاظم الدور المقرر لإيران في دول كسورية والعراق ولبنان واليمن، بوصفه تجسيدا لانتصار "إرادة الأمة"، وتعبيرا عن صحة الخيارات والتوجهات التي تصدر عن "نظام ولاية الفقيه".
وتشير الاستعدادات التي تبديها قوى إسلامية، سنية وشيعية، سياسية ومسلحة، للقتال في شتى ساحات "حروب الوكالة" المندلعة في المنطقة، إلى استخفاف هذه الجماعات بمفاهيم "الولاء والانتماء الوطني"، وتغليبها مفهوم "الأممية الإسلامية" بطبعاتها المذهبية المختلفة، واعتبار "مصلحة" هذه الأمة، تتقدم على المصالح الوطنية "الضيقة" و"الظرفية". وهي بهذا المعنى، تعيد إنتاج تجربة الشيوعيين العرب مع شعار "الأممية البروليتارية"، بل وتذهب به إلى مستويات وأبعاد غير مسبوقة، وأشد خطورة.