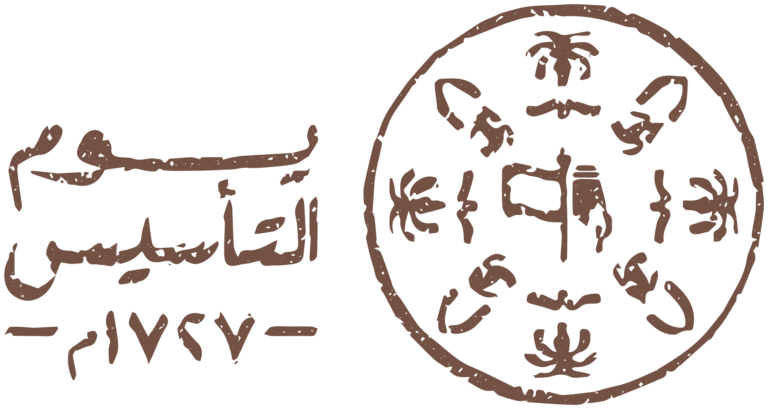الرؤية الاستراتيجية
نحو إعادة تنظيم العالم
زبيغنيو بريجنسكي
مع انتهاء عصر هيمنتها العالمية، يتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في إعادة تنظيم بنية القوة العالمية.
تشير خمسة حقائق أساسية بشأن عملية إعادة توزيع القوة السياسية العالمية الناشئة والصحوة السياسية العنيفة في الشرق الأوسط إلى قدوم عملية إعادة تنظيم عالمية جديدة.
الحقيقة الأولى هي أن الولايات المتحدة لا تزال الكيان الأكثر قوة على مستوى العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ولكن في ظل التحولات الجيوسياسية المعقدة في التوازنات الإقليمية، فإنها لم تعد القوة الإمبريالية العالمية. ولكن هذا لا ينطبق أيضا على أي قوة كبرى أخرى.
الحقيقة الثانية هي أن روسيا تمر الآن بمرحلة تشنجية جديدة من تراجعها الإمبراطوري. ورغم أن هذه العملية مؤلمة، فإن روسيا لا تستبعد بشكل قاتل ــ إذا تصرفت بحكمة ــ أن تصبح في نهاية المطاف دولة قومية أوروبية رائدة. ولكنها في الوقت الحالي تعمل بلا جدوى على تنفير بعض رعاياها السابقين في الجنوب الغربي الإسلامي لإمبراطوريتها الواسعة ذات يوم، فضلاً عن أوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا، ناهيك عن دول البلطيق.
الحقيقة الثالثة هي أن الصين تصعد بشكل مطرد، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ في الآونة الأخيرة، باعتبارها منافساً مساوياً لأميركا في نهاية المطاف؛ ولكنها حريصة في الوقت الراهن على عدم فرض أي تحد صريح على أميركا. وعلى الصعيد العسكري، يبدو أنها تسعى إلى تحقيق اختراق في جيل جديد من الأسلحة في حين تعمل بصبر على تعزيز قوتها البحرية التي لا تزال محدودة للغاية.
الحقيقة الرابعة هي أن أوروبا ليست الآن ولا من المرجح أن تصبح قوة عالمية. ولكنها قادرة على الاضطلاع بدور بناء في تولي زمام المبادرة فيما يتصل بالتهديدات العابرة للحدود الوطنية التي تهدد الرفاهة العالمية وحتى بقاء الإنسان. فضلاً عن ذلك فإن أوروبا منسجمة سياسياً وثقافياً مع المصالح الأميركية الأساسية في الشرق الأوسط وتدعمها، والثبات الأوروبي داخل حلف شمال الأطلسي يشكل ضرورة أساسية للتوصل إلى حل بناء في نهاية المطاف للأزمة الروسية الأوكرانية.
الحقيقة الخامسة هي أن الصحوة السياسية العنيفة التي يشهدها المسلمون في فترة ما بعد الاستعمار تشكل في جزء منها رد فعل متأخر على القمع الوحشي الذي يتعرضون له من حين إلى آخر على يد القوى الأوروبية في أغلب الأحوال. وهي تمزج بين الشعور المتأخر بالظلم والدافع الديني الذي يوحد أعداداً كبيرة من المسلمين ضد العالم الخارجي؛ ولكن في الوقت نفسه، ونظراً للانقسامات الطائفية التاريخية داخل الإسلام والتي لا علاقة لها بالغرب، فإن ظهور المظالم التاريخية مؤخراً يشكل أيضاً سبباً للانقسام داخل الإسلام.
إن هذه الحقائق الخمس، إذا نظرنا إليها مجتمعة باعتبارها إطاراً موحداً، فإنها تخبرنا بأن الولايات المتحدة لابد وأن تتولى زمام المبادرة في إعادة تنظيم بنية القوة العالمية على النحو الذي يسمح باحتواء العنف الذي يندلع داخل العالم الإسلامي، والذي يمتد أحياناً إلى ما هو أبعد من ذلك ـ وربما في المستقبل من أجزاء أخرى من ما كان يسمى بالعالم الثالث ـ دون تدمير النظام العالمي. وبوسعنا أن نرسم الخطوط العريضة لهذه البنية الجديدة من خلال شرح موجز لكل من الحقائق الخمس السابقة.
Fأولاً، لا يمكن لأميركا أن تكون فعّالة في التعامل مع العنف الحالي في الشرق الأوسط إلا إذا نجحت في تشكيل تحالف يضم، بدرجات متفاوتة، روسيا والصين أيضاً. ولتمكين مثل هذا التحالف من التبلور، لابد أولاً من تثبيط عزيمة روسيا عن الاعتماد على الاستخدام الأحادي للقوة ضد جيرانها ــ وخاصة أوكرانيا وجورجيا ودول البلطيق ــ ولابد من تخليص الصين من وهم الفكرة القائلة بأن السلبية الأنانية في مواجهة الأزمة الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط سوف تثبت أنها مفيدة سياسياً واقتصادياً لطموحاتها في الساحة العالمية. ولابد من توجيه هذه الدوافع السياسية قصيرة النظر نحو رؤية أكثر بعد نظر.
وثانياً، أصبحت روسيا للمرة الأولى في تاريخها دولة وطنية حقيقية ، وهو التطور الذي يتجاهله كثيرون رغم أهميته البالغة. فقد انتهت الإمبراطورية القيصرية، بسكانها المتعددي الجنسيات ولكن السلبيين سياسياً إلى حد كبير، مع الحرب العالمية الأولى، وحل محلها الاتحاد السوفييتي الذي أنشأه البلاشفة، والذي كان طوعياً على ما يبدو بين الجمهوريات الوطنية، وكانت السلطة في أيدي الروس فعلياً. وأدى انهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية عام 1991 إلى ظهور مفاجئ لدولة روسية في المقام الأول كخليفة له، وإلى تحول "الجمهوريات" غير الروسية في الاتحاد السوفييتي السابق إلى دول مستقلة رسمياً. والآن تعمل هذه الدول على تعزيز استقلالها، ويستغل الغرب والصين ـ في مجالات مختلفة وبطرق مختلفة ـ هذا الواقع الجديد لصالح روسيا. وفي الوقت نفسه، يعتمد مستقبل روسيا ذاتها على قدرتها على التحول إلى دولة قومية كبرى ومؤثرة تشكل جزءاً من أوروبا الموحدة. إن عدم القيام بذلك قد يكون له عواقب سلبية هائلة على قدرة روسيا على الصمود في وجه الضغوط الإقليمية والديموغرافية المتزايدة من الصين، التي تميل بشكل متزايد مع نمو قوتها إلى تذكر المعاهدات "غير المتكافئة" التي فرضتها موسكو على بكين في الماضي.
ثالثاً، يتطلب النجاح الاقتصادي المذهل الذي حققته الصين الصبر الدائم ووعي البلاد بأن التسرع السياسي من شأنه أن يؤدي إلى إهدار اجتماعي. وأفضل احتمال سياسي للصين في المستقبل القريب هو أن تصبح الشريك الرئيسي لأميركا في احتواء الفوضى العالمية من النوع الذي ينتشر إلى الخارج (بما في ذلك إلى الشمال الشرقي) من الشرق الأوسط. وإذا لم يتم احتواء هذه الفوضى فإنها سوف تلوث الأراضي الجنوبية والشرقية لروسيا فضلاً عن الأجزاء الغربية من الصين. والواقع أن العلاقات الوثيقة بين الصين والجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى، والدول الإسلامية التي نشأت بعد بريطانيا في جنوب غرب آسيا (وخاصة باكستان) وخاصة مع إيران (نظراً لأصولها الاستراتيجية وأهميتها الاقتصادية)، تشكل الأهداف الطبيعية للتوسع الجيوسياسي الإقليمي الصيني. ولكن ينبغي أن تكون هذه الأهداف أيضاً أهدافاً للتوافق الصيني الأميركي العالمي.
رابعاً، لن يعود الاستقرار المقبول إلى الشرق الأوسط ما دامت التشكيلات العسكرية المسلحة المحلية قادرة على حساب قدرتها على الاستفادة من إعادة تنظيم الأراضي في الوقت الذي تشجع فيه بشكل انتقائي العنف المتطرف. ولا يمكن احتواء قدرتها على التصرف بطريقة وحشية إلا من خلال ضغوط متزايدة الفعالية ــ ولكن انتقائية أيضاً ــ مستمدة من قاعدة التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، والتي تعمل بدورها على تعزيز احتمالات الاستخدام المسؤول للقوة من جانب الدول الأكثر رسوخاً في المنطقة (وهي إيران وتركيا وإسرائيل ومصر). وينبغي لهذه الدول أيضاً أن تتلقى دعماً أوروبياً أكثر انتقائية. وفي ظل الظروف العادية، كانت المملكة العربية السعودية لتكون لاعباً مهماً في هذه القائمة (( يتحدث في فترة ما قبل ظهور الامير محمد بن سلمان )) ، ولكن الميل الحالي للحكومة السعودية إلى تعزيز التعصب الوهابي، حتى في حين تشارك في جهود التحديث المحلية الطموحة، يثير شكوكاً خطيرة بشأن قدرة المملكة العربية السعودية على الاضطلاع بدور بناء مهم إقليمياً.
خامساً، لابد من التركيز على الجماهير التي استثارت سياسياً في العالم غير الغربي. إن الذكريات السياسية التي ظلت مكبوتة لفترة طويلة تعمل على تغذية الصحوة المفاجئة والمتفجرة التي يحركها المتطرفون الإسلاميون في الشرق الأوسط، ولكن ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم قد يكون مجرد بداية لظاهرة أوسع نطاقاً قد تنشأ في أفريقيا وآسيا، وحتى بين شعوب ما قبل الاستعمار في نصف الكرة الغربي في السنوات المقبلة.
لقد أدت المذابح التي ارتكبت بحق أسلافهم غير البعيدين على يد المستعمرين والباحثين عن الثروات من أوروبا الغربية (البلدان التي لا تزال حتى اليوم، ولو بشكل مؤقت على الأقل، الأكثر انفتاحاً على التعايش بين الأعراق المختلفة)، خلال القرنين الماضيين أو نحو ذلك، إلى مذابح بحق الشعوب المستعمرة على نطاق مماثل لجرائم النازية في الحرب العالمية الثانية: والتي شملت حرفياً مئات الآلاف وحتى الملايين من الضحايا. إن التأكيد على الذات السياسي المعزز بالغضب المؤجل والحزن يشكل قوة عاتية بدأت تطفو على السطح الآن، متعطشة للانتقام، ليس فقط في الشرق الأوسط الإسلامي ولكن أيضاً على الأرجح في أماكن أخرى من العالم.
لا يمكن تحديد الكثير من البيانات بدقة، ولكن إذا نظرنا إليها مجتمعة، فإنها صادمة. ولنكتف ببعض الأمثلة. ففي القرن السادس عشر ، وبسبب الأمراض التي جلبها المستكشفون الإسبان إلى حد كبير، انخفض عدد سكان إمبراطورية الأزتك الأصلية في المكسيك الحالية من 25 مليون نسمة إلى ما يقرب من مليون نسمة. وعلى نحو مماثل، في أمريكا الشمالية، مات ما يقدر بنحو 90% من السكان الأصليين في غضون السنوات الخمس الأولى من الاتصال بالمستوطنين الأوروبيين، وذلك في المقام الأول بسبب الأمراض. وفي القرن التاسع عشر ، تسببت الحروب المختلفة وإعادة التوطين القسري في مقتل 100 ألف شخص إضافي. وفي الهند في الفترة من 1857 إلى 1867، يُشتبه في أن البريطانيين قتلوا ما يصل إلى مليون مدني انتقاماً لتمرد الهنود في عام 1857. كما أدى استخدام شركة الهند الشرقية البريطانية للزراعة الهندية لزراعة الأفيون الذي فرض على الصين في الأساس إلى وفاة الملايين في وقت مبكر، ناهيك عن الخسائر الصينية المباشرة في حربي الأفيون الأولى والثانية. وفي الكونغو، التي كانت تحت سيطرة الملك البلجيكي ليوبولد الثاني، قُتل ما بين 10 و15 مليون إنسان في الفترة من عام 1890 إلى عام 1910. وفي فيتنام، تشير التقديرات الأخيرة إلى مقتل ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين مدني في الفترة من عام 1955 إلى عام 1975.
أما بالنسبة للعالم الإسلامي في القوقاز الروسي، فقد تم تهجير 90% من السكان الشركس المحليين قسراً في الفترة من 1864 إلى 1867، ومات ما بين 300 ألف و1.5 مليون شخص جوعاً أو قُتلوا. وفي الفترة من 1916 إلى 1918، قُتل عشرات الآلاف من المسلمين عندما أجبرت السلطات الروسية 300 ألف مسلم تركي على الفرار عبر جبال آسيا الوسطى إلى الصين. وفي إندونيسيا، في الفترة من 1835 إلى 1840، قتل المحتلون الهولنديون ما يقدر بنحو 300 ألف مدني. وفي الجزائر، بعد حرب أهلية دامت 15 عاماً من 1830 إلى 1845، تسببت الوحشية الفرنسية والمجاعة والمرض في مقتل 1.5 مليون جزائري، أي ما يقرب من نصف السكان. وفي ليبيا المجاورة، أجبر الإيطاليون سكان برقة على الذهاب إلى معسكرات الاعتقال، حيث لقي ما يتراوح بين 80 ألفاً و500 ألف شخص حتفهم بين عامي 1927 و1934.
وفي الآونة الأخيرة، تشير التقديرات إلى أن الاتحاد السوفييتي قتل في أفغانستان بين عامي 1979 و1989 نحو مليون مدني؛ وبعد عقدين من الزمان، قتلت الولايات المتحدة 26 ألف مدني خلال حربها التي دامت خمسة عشر عاماً في أفغانستان. وفي العراق، قتلت الولايات المتحدة وحلفاؤها 165 ألف مدني خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية. (قد يكون التفاوت بين عدد القتلى الذين ألحقهم المستعمرون الأوروبيون بالعراق وأفغانستان راجعاً جزئياً إلى التقدم التكنولوجي الذي أدى إلى الاستخدام الأكثر فعالية للقوة، وجزئياً أيضاً إلى التحول في المناخ المعياري العالمي). والأمر المذهل بنفس القدر الذي يبعث على الصدمة هو مدى سرعة الغرب في نسيان هذه الفظائع.
في عالم ما بعد الاستعمار اليوم، بدأت تظهر رواية تاريخية جديدة. ويتم استخدام الاستياء العميق ضد الغرب وإرثه الاستعماري في البلدان الإسلامية وخارجها لتبرير شعورهم بالحرمان وإنكار كرامتهم الذاتية. ويلخص الشاعر السنغالي ديفيد ديوب مثالاً صارخاً على تجربة ومواقف الشعوب المستعمرة في قصيدة "النسور":
في تلك الأيام،
عندما ركلتنا الحضارة في وجوهنا،
بنى النسور في ظل مخالبهم
نصبًا تذكاريًا ملطخًا بالدماء للوصاية...
في ظل كل هذا، فإن الطريق الطويل والمؤلم نحو تسوية إقليمية محدودة في البداية هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والصين والكيانات ذات الصلة في الشرق الأوسط. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذا يتطلب المثابرة والصبر في صياغة علاقات تعاونية مع بعض الشركاء الجدد (وخاصة روسيا والصين)، فضلاً عن الجهود المشتركة مع الدول الإسلامية الأكثر رسوخاً وتجذراً تاريخياً (تركيا وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية إذا تمكنت من فصل سياستها الخارجية عن التطرف الوهابي) { ما قبل السعودية الجديدة } في تشكيل إطار أوسع للاستقرار الإقليمي. ولا يزال بإمكان حلفائنا الأوروبيين، الذين كانوا مهيمنين في المنطقة في السابق، أن يكونوا مفيدين في هذا الصدد.
إن الانسحاب الأميركي الشامل من العالم الإسلامي، الذي يفضله الانعزاليون المحليون، قد يؤدي إلى نشوء حروب جديدة (على سبيل المثال، إسرائيل ضد إيران، والمملكة العربية السعودية ضد إيران، والتدخل المصري الكبير في ليبيا)، وقد يولد أزمة ثقة أعمق في الدور الأميركي المستقر عالميا. وبطرق مختلفة ولكنها غير متوقعة بشكل كبير، قد تكون روسيا والصين المستفيدين الجيوسياسيين من مثل هذا التطور حتى مع تحول النظام العالمي نفسه إلى الضحية الجيوسياسية الأكثر إلحاحا. وأخيرا وليس آخرا، في مثل هذه الظروف، سترى أوروبا المنقسمة والخائفة دولها الأعضاء الحالية تبحث عن رعاة وتتنافس مع بعضها البعض في ترتيبات بديلة ولكن منفصلة بين الثلاثي الأكثر قوة.
إن السياسة الأميركية البناءة لابد وأن تسترشد برؤية بعيدة المدى. ولابد وأن تسعى إلى تحقيق نتائج تعزز الإدراك التدريجي في روسيا (ربما بعد بوتن) بأن مكانها الوحيد كقوة عالمية مؤثرة هو في نهاية المطاف داخل أوروبا. ولابد وأن يعكس الدور المتزايد للصين في الشرق الأوسط الإدراك المتبادل بين الولايات المتحدة والصين بأن الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط تشكل اختباراً تاريخياً بالغ الأهمية لقدرتهما على تشكيل وتعزيز الاستقرار العالمي الأوسع نطاقاً.
إن البديل عن الرؤية البناءة، وخاصة السعي إلى تحقيق نتيجة أحادية الجانب مفروضة عسكرياً وأيديولوجياً، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى عبث مطول ومدمر للذات. وبالنسبة لأميركا، قد يستلزم هذا صراعاً مستمراً، وإرهاقاً، وربما حتى انسحاباً محبطاً إلى عزلتها التي كانت سائدة قبل القرن العشرين . وبالنسبة لروسيا، قد يعني هذا هزيمة كبرى، مما يزيد من احتمالات التبعية بطريقة أو بأخرى للهيمنة الصينية. وبالنسبة للصين، قد ينذر هذا بالحرب ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل وأيضاً، ربما بشكل منفصل، مع اليابان أو الهند أو كليهما. وفي كل الأحوال، فإن مرحلة مطولة من الحروب العرقية شبه الدينية المستمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع التعصب الذاتي من شأنها أن تولد إراقة دماء متصاعدة داخل المنطقة وخارجها، وقسوة متزايدة في كل مكان.
الحقيقة هي أنه لم تكن هناك قوة عالمية "مهيمنة" حقًا حتى ظهور أمريكا على الساحة العالمية. كانت بريطانيا العظمى الإمبراطورية قريبة من أن تصبح قوة مهيمنة، لكن الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية لم تفلساها فحسب، بل دفعت أيضًا إلى ظهور قوى إقليمية منافسة. كان الواقع العالمي الجديد الحاسم هو ظهور أمريكا على الساحة العالمية باعتبارها اللاعب الأكثر ثراءً والأقوى عسكريًا في نفس الوقت. خلال الجزء الأخير من القرن العشرين، لم تقترب أي قوة أخرى حتى من ذلك.
إن هذا العصر يقترب من نهايته الآن. ورغم أنه من غير المرجح أن تتمكن أي دولة في المستقبل القريب من مضاهاة التفوق الاقتصادي والمالي الأميركي، فإن أنظمة الأسلحة الجديدة قد تمنح بعض الدول فجأة الوسائل اللازمة للانتحار في احتضان مشترك مع الولايات المتحدة، أو حتى الانتصار. ودون الخوض في تفاصيل تكهنية، فإن الاستحواذ المفاجئ من جانب بعض الدول على القدرة على جعل أميركا أدنى عسكرياً من شأنه أن يعني نهاية الدور العالمي لأميركا. ومن المرجح أن تكون النتيجة فوضى عالمية. ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة أن تصمم سياسة تجعل واحدة على الأقل من الدولتين اللتين تشكلان تهديداً محتملاً شريكة في السعي إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي ثم العالمي الأوسع نطاقاً، وبالتالي احتواء الخصم الأقل قابلية للتنبؤ ولكنه الأكثر احتمالاً للتجاوز. وفي الوقت الحالي، فإن روسيا هي الأكثر احتمالاً للتجاوز، ولكن في الأمد الأبعد قد تكون الصين.
وبما أن الأعوام العشرين المقبلة قد تكون المرحلة الأخيرة من التحالفات السياسية التقليدية المألوفة التي اعتدنا عليها، فإن الاستجابة لابد وأن تتبلور الآن. وخلال بقية هذا القرن سوف تضطر البشرية أيضاً إلى الانشغال على نحو متزايد بالبقاء على قيد الحياة في حد ذاته بسبب التقاء التحديات البيئية. ولا يمكن معالجة هذه التحديات بمسؤولية وفعالية إلا في إطار من التكيف الدولي المتزايد. ولابد وأن يستند هذا التكيف إلى رؤية استراتيجية تدرك الحاجة الملحة إلى إطار جيوسياسي جديد.
زبيغنيو بريجنسكي مستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وكان مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر من عام 1977 إلى عام 1981. وهو مؤلف كتاب " الرؤية الاستراتيجية: أميركا وأزمة القوة العالمية" .