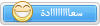البرامج الصاروخية تتزاحم في الشرق الأوسط، وكذلك الاستراتيجيات المعتمدة لمواجهة انتشار الصواريخ البالستية وأنظمة ضبط التكنولوجيا الصاروخية. في إيران وسورية وإسرائيل، كما في السعودية واليمن والإمارات، سباق محموم لاقتناء الصواريخ القصيرة المدى وطويلها، و«حزب الله» و«حماس» وبعض المجموعات الإسلامية المتشدّدة سائرة في الركب لأغراض باتت معروفة. ما قصّة هذا السباق؟
الأخبار تقول إن صاروخ «شهاب ـ ٣» الإيراني (١٣٠٠ ـ ١٥٠٠ كيلومتر)، والقادر على قطع مساره من ارتفاع ٢٥٨٥١ متراً، هو أول نموذج متطوّر صمّم بالاستناد الى صاروخي «جوري ـ ٢» الباكستاني «ونو ـ دونغ» الكوري الشمالي، بالتعاون مع روسيا والصين. وبالاضافة الى «شهاب ـ ٣» تواصل إيران برنامج تطوير قدراتها الصاروخية الهجومية التي تضم عائلة كاملة من الصواريخ البالستية المخصّصة لبلوغ مدى أكثر، ومنها «زلزال ١» و«زلزال ٢» و«زلزال ٣» التي يراوح مداها بين ٣٠٠ و٨٠٠ كيلومتر، كما أن إيران تقوم بتجارب على الطراز المعروف بـ«شهاب ٤» الذي يعتقد أنه نسخة عن الصاروخ السوفياتي القديم «سي سي ٤ ـ ساندال» الذي يصل مداه الى ٣ آلاف كيلومتر، وكذلك «شهاب ٥» الذي تقول مصادر الاستخبارات الغربية أنه نسخة عن الصاروخ الكوري الشمالي «تايبو دونغ ١» ويقدّر مداه بـ٥ آلاف كيلومتر.
والأخبار تقول إن «شهاب ٣» صاروخ يتمتّع بمزايا تجعل منه إضافة نوعية الى ترسانة الصواريخ الإيرانية، أبرزها، الى جانب سرعته، قدرته على حمل رأس حربية يراوح وزنها بين ٦٧٠ كلغ وألف كيلوغرام، الأمر الذي يشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل، حسبما ذكر خبراء إسرائيليون.
في الأخبار المحدودة التداول، حتى الآن، إن روسيا التي تحلم بالعودة الى أجواء السبعينيات من القرن الفائت، أبرمت مع أكثر من بلد عربي صفقات صواريخ متطوّرة، وأن سورية تسلّمت الدفعات الأولى من راجمات صواريخ مضادة للطائرات أطلق عليها صانعوها اسم «بانستير» أي الدرع، وهي معروفة باسم «بانستير إس ـ ١» أو «إس. إيه ٢٢» كما يسمّيها الغربيون، وهي عبارة عن منظومة تحتوي كل منها على راجمة بـ١٢ صاروخاً مضادة للطائرات ومدفعين من عيار ٣٠ ملليمتراً ومحطّة رادار.
وفي هذا السياق، يقول الأميركيون إن الغارة الجوّيّة التي استهدفت الشمال السوري في أيلول (سبتمبر) الفائت، كان القصد منها استكشاف القدرة الرادعة لهذه المنظومة.
ويبلغ مدى صاروخ «بانتسير إس ـ ١» ١٢٠٠ متر في حدّه الأدنى و٢٠ ألف متر في حدّه الأقصى، وهو قادر على تدمير أهداف يراوح ارتفاعها بين ١٥ متراً و١٥ ألف متر. والمنظومة تتعامل مع أهداف تبلغ سرعتها القصوى ألف متر في الثانية، ويراوح المدى المجدي للمدفعين التابعين للمنظومة ـ حسب ما أوردته وكالة نوڤوستي الروسية ـ بين ٢٠٠ و٤٠٠٠ متر، ويقال إن سورية تعاقدت على شراء ٥٠ منظومة من هذا الطراز، أو ربما ٣٤ الى ٣٦ منظومة.
وهناك تسريبات صحفية مفادها أن سورية يمكن أن تسلّم عشراً من هذه المنظومات الى إيران، مقابل دفعة من الصواريخ الإيرانية المتوسطة المدى (شهاب ٣)، الأمر الذي يستبعده الروس، لأن موسكو تشترط في عقد مثل هذه الصفقات أن لا يتمّ نقلها الى بلد آخر، علماً أن الإمارات العربية المتحدة تعاقدت، هي الأخرى، على شراء ٥٠ منظومة من النوع نفسه، ويقال إنها تسلّمت ١٢ منها حتى الآن، وأن الدفعتين المتبقّيتين سوف تسلّمان في العام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
وتشمل صفقة الأسلحة التي وقّعتها روسيا مع الجزائر في آذار (مارس) ٢٠٠٦ ٣٨ منظومة من طراز «بانستير إس ـ ١»، وهناك معلومات غير رسمية تفيد أن الصين واليونان بدأتا مفاوضات مع روسيا لشراء هذا النوع من الصواريخ، علماً أن الجيش الروسي سوف يضعها في الخدمة الفعلية اعتباراً من العام المقبل.
كل هذا يعني أن قواعد الحرب والسلام تتغيّر في الشرق الأوسط، وأن معادلة السلام الاستراتيجي صارت من الماضي. وقد برهنت حرب تموز (يوليو) ٢٠٠٦ بين إسرائيل و«حزب الله» أن إسرائيل ليست بالضرورة، أو أنها لم تعد، الدولة التي لا تقهر في المنطقة. ورغم أن الإسرائيليين يميلون الى التعايش مع نتائج هذه المعركة، ورغم أن القرار ١٧٠١ يشكّل في النهاية رافعة دولية لحماية إسرائيل، فإن أصواتاً في تل أبيب بدأت تطالب بخلق فرص لعملية سياسية واسعة وتهيئة المناخ لحوار مع سورية.
ويبدو أن دمشق أمسكت بطرف الخيط عندما شاركت في مؤتمر آنابوليس، لأنها فهمت الرسالة، رغم أنها لا تزال تشدّد خطابها السياسي، علماً أنها لا توفّر أي فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية. ويؤكّد خبير عسكري سوري أن بلاده تملك ترسانة ضخمة من الأسلحة الصاروخية المتوسطة المدى وبعيدها، الكورية والروسية الصنع، وأنها طوّرت نموذجاً من هذه الصواريخ، لزيادة قدرته التدميرية في استهداف المراكز الحيوية والبنى التحتية في إسرائيل. الخبير نفسـه يؤكّد أن قدرات الصواريخ السورية كبيرة، وأن دقّة إصابتهـا عالية، ووزن العبوة التي تحملها تتجـاوز نصف طن، ثم إن قدرتهـا على اختراق الأجـواء الإسـرائيليـة عالية بسبب وجود مواد عازلة لا تكشفها الرادرات ولا يستطيع «الباتريوت» (الصاروخ المضاد للصواريخ) التصدّي لها، وإذا هي اكتشفت فإن إسقاطها صعب للغاية، لأن المدة التي تحتاجها للوصول الى أهدافها لا تزيد على ٩٠ ثانية.
وفي معلومات أخرى، إن أي حرب تنشب بين سورية وإسرائيل سوف تكون مواجهة تخرج على الاطار التقليدي، وقد تستعمل فيها أسلحة بيولوجية أو كيميائية، وأن مطالبة سورية بإدراج الجولان على جدول أعمال «آنابوليس ٢» تنستند، في جملة ما تسند إليه، الى هذه الاحتمالات. في الوقت نفسه، تتحدّث تقارير غربية استخباراتية عن أن سورية بدأت وضع خطّة عاجلة لبناء ملاجئ ذات مواصفات خاصة تستوعب الآلاف في مختلف المحافظات، كما تستوعب مخازن كبيرة من المواد التموينية، في الوقت الذي تمسك بأوراقها التفاوضية في لبنان وفلسطين والعراق، وكذلك بتحالفها الاستراتيجي مع إيران.
تهافت دولي
المهم في الأمر، أن الظاهرة لا تقتصر على إيران وسورية وإسرائيل، وإنما تندرج في إطار سباق الأسلحة الصاروخية البرّيّة والبحريّة والجوّيّة على امتداد «الشرق الأوسط الكبير» (باكستان ضمناً)، بحيث لم تعد هناك فترة قصيرة تفصل بين إجراء تجربة صاروخية في بلد، وإجراء تجربة مماثلة في بلد مجاور، أو في بلد آخر يقع في أقاصي الأرض، مع ثلاث مفارقات رئيسية:
أولاً: إن استخدام الأسلحة الصاروخية وانتشار تقنيّاتها، لم تعد محصورة أو محدّدة بمحيط الدول والجيوش النظامية، وإنما أصبح في استطاعة التنظيمات شبه العسكرية أو الميليشيات الحصول على مختلف أنواع الأسلحة الصاروخية.ثانياً: إن الدول الكبرى، وعبر سياستها غير الثابتة وغير المستقرة، كثيراً ما تمارس الدور الحاسم في انتشار الأسلحة الصاروخية وتقنيّاتها، مثل تسليح أميركا تنظيم طالبان (بصواريخ ستينغر) إبّان الحرب ضد قوّات الاتحاد السوفياتي. ثالثاً: إن سوق السلاح في العالم لا يستطيع فرض قيود صارمة ضد انتشار الأسلحة الصاروخية، أو ضد انتشار تقنيّاتها، أو الحصول على مكوّنات هذه الأسلحة مثل ما يحدث في فلسطين والعراق، فهل يمكن الحدّ من تطوّر الأسلحة والتقانة في ظل انتشار المعرفة الصناعية، وفي ظل الاستخدامات المزدوجة للتقنيات العلمية؟؟ يمكن هنا تجاوز تجربة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في مجال صناعة صواريخ القسّام، وكذلك ما يُقال عن تجربة «حزب الله» في تطوير وصناعة أسلحة صاروخية يمكن لها ضرب العمق الإسرائيلي، وما يماثل ذلك من التجارب المحدودة، والتي تبرهن على توافر القدرة لدى كل الشعوب، لتطوير أسلحة صاروخية من كل الأنواع والقدرات، والتوقُّف عند تجربة خاصة، ربما حدثت تجارب كثيرة مماثلة لها من حيث وصول الأسلحة الصاروخية إلى عناصر أو حتى خلايا منظّمة لا تتوافر لها القدرة على استخدام هذه الأسلحة، أو ربما معرفة خصائصها ومزاياها؛ وخلاصة التجربة كما أُعلن في العاصمة الأردنية (عمّان) (يوم ١٤ آذار / مارس ٢٠٠٦) على النحو التالي: «أحال المدّعي العام الأردني ستة سوريين وأردنياً موقوفين منذ ثمانية أشهر على المحكمة، بتهمة تدبير إطلاق ثلاثة صواريخ على بارجة أميركية في خليج العقبة، (يوم التاسع من أيلول /سبتمبر ٢٠٠٥)، مما أدّى إلى قتل عسكري أردني وإصابة آخر. وكشفت لائحة الاتهام أن العملية شارك فيها ١٢ شخصاً أهمهم: عبد الله السحلي، ومحمد حسن وأولاده الخمسة الذين قَدِمَ اثنان منهم من العراق وبحوزتهما سبعة صواريخ كاتيوشا جرى تهريبها داخل خزّان سيارة مرسيدس، من أجل مهاجمة السفارتين الأميركية والإسرائيلية في عمّان، قبل أن يتحوّلوا مصادفة إلى العملية لضرب البارجة الأميركية». ويصبح لزاماً بعد ما سبق عرضه، التوقُّف عند قصة (صواريخ بيونغ يانغ)، فقد بقيت كوريا الشمالية على رأس (محور الشر) بسبب امتلاكها السلاح النووي، والصواريخ القادرة على حمل النار النوويّة إلى داخل الولايات المتحدة الأميركية، وقد أفادت الولايات المتحدة الأميركية من هذا التحدّي لدعم مشروعها (الدرع الصاروخية)، ولفرض رقابة دائمة على كوريا، «فقد أعلنت كوريا الديمقراطية (يوم ١ شباط / فبراير ٢٠٠٦) أن الولايات المتحدة أجرت خلال شهر كانون الثاني (يناير) وحده أكثر من ١٩٠ طلعة تجسّسية فوق أراضيها، وكانت الطائرات من أنواع: يو ٢، و آر سي ١٣٥، و آي بي ٣»، واعتبرت (بيونغ يانغ) أن ذلك يزيد في حالة التوتّر، وردّت على ذلك (يوم ١٤ آذار / مارس ٢٠٠٦) باستعدادها لاجتياح كوريا الجنوبية، وردّت كوريا الجنوبية والقوّات الأميركية على هذا التحدّي الاستفزازي وأمثاله بمناورات عسكرية مشتركة.
سباق التسلّح الجديد في المنطقة يشكّل جزءاً من هذا التهافت على المستوى العالمي، ومبيعات الأسلحة الإيرانية تشكّل جزءاً من مبيعات أكثر اتّساعاً تتولاها الدول الكبرى وإسرائيل، والحديث عن إطلاق قمر صناعي إيراني يشكّل بدوره امتداداً لإطلاق أقمار أخرى معظمها إسرائيلي الى الفضاء الخارجي، وعائلة «شهاب» الصاروخية الإيرانية هي الردّ المباشر على عائلة «حيتس» الإسرائيلية، والحملة الإسرائيلية المتواصلة على إيران. والبرامج التسليحية الإيرانية ذات أهداف مزدوجة: إثارة المخاوف الإقليمية من الدور الإيراني الجديد وتبرير التسلح الإسرائيلي المتزايد. وليس سرّاً أن الولايات المتحدة وقّعت اتفاقية مع إسرائيل خلال العام ٢٠٠٧، تقضي بتزويد الدولة العبرية بأسلحة قيمتها الاجمالية ٣٠ مليار دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة، وأن المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل ارتفعت بمعدّل ٢٥ بالمئة عما كانت عليه في السنوات الأخيرة. وتنصّ الصفقة على أن يشتري الإسرائيليون ربع حاجاتهم من السوق المحلّيّة، وأن يخصّصوا الاعتمادات الباقية لشراء الأسلحة الأميركية المتطوّرة. والاعلان الأميركي عن صفقات «متوازنة» مع السعودية ومصر والأردن وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات، يشكّل محاولة لتغطية الانحياز المفضوح الى ضمان التفوّق الإسرائيلي.
ولا يمكن التوقّف عند هذا الحد في الكلام على السباق الصاروخي، من دون أن نعرج ولو بسرعة، على سباق آخر لم يتناوله الاعلام العسكري بقدر كاف من الاهتمام حتى الآن، هو السباق الى اقتناء الطائرات والصواريخ الأسرع من الصوت التي لا يمكن اعتراضها من قبل أي منظومة دفاعية في العالم.
في هذا السياق، يقول الخبير العسكري جاسبيت سينغ (المركز الدولي لدراسات أميركا والغرب)، إنه واحد من أعمق التطوّرات التي سوف تؤدّي الى تغيير الصورة الاستراتيجية الدولية في غضون العقد المقبل أو نحوه، وهو رواية من روايات الخيال العلمي تتحوّل اليوم الى حقيقة واقعة.
ويضيف: في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سجّلت طائرة وكالة «ناسا» من طراز إيه ـ ٤٣ إكس رقماً قياسياً عالمياً في السرعة بلغ ١٠ (ماخ)، وهو ما يعادل ضعف سرعة الصوت ١٠ مرات، وذلك عند طيرانها على ارتفاع ٣٤ كيلومتراً (١١٠ آلاف قدم).
ويمكن القول على سبيل التبسيط، إن سرعة تلك الطائرة تساوي سرعة مركبة تسير بسرعة ١١ ألف كيلومتر في الساعة!... وهو ما يمثّل إنجازاً علمياً هائلاً في الحقيقة. وهذه المركبة الصغيرة هي جزء من برنامج «ناسا» المسمّى «هيپر إكس» الذي تبلغ تكلفته ٢٣٠ مليون دولار، والذي يهدف إلى تطوير ما أصبح يصطلح على تسميّته بـ«المركبة العابرة للأجواء»، والتي يرمز إليها على سبيل الاختصار بالحروف «تي إيه ڤي» وهي الحروف الأولى من اسمها باللغة الإنكليزية.
وستستخدم «ناسا» في تلك الطائرة التقنيّة المعروفة بتقنيّة (المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت)، وهي تقنيّة تقوم فيها السرعة الفائقة بضغط كمّيّات الهواء القليلة المتاحة لإنتاج كمّيّات كافية من الأوكسيجين)، لتحقيق احتراق مزيج الهواء ـ الوقود في السرعات الفائقة (الأسرع من الصوت)... ومن الواضح أن هذه التقنيّة قد أصبحت الآن على حافة النضوج.
وهناك استخدامان على الأقل لتقنيّات المركبات العابرة للأجواء: الاستخدام الأول هو استخدامها في إطلاق طائرة فضائية تستخدم في عدد من الأغراض المدنية والعلمية. أما الاستخدام الثاني فهو استخدامها في أدوار عسكرية ـ استراتيجية. فنظراً الى عدم وجود هواء ولا أوكسيجين في الجوّ، فإن وقود الصواريخ يجب أن يحتوي على الهواء والأوكسيجين ضمن مكوّناته. لذلك نجد أن المركبات العادية التي يتم إطلاقها في الفضاء، غالباً ما تكون مضطرة إلى حمل كمّيّات كبيرة من وقود الصواريخ، حتى يتم إطلاقها للفضاء الخارجي وهو ما يتمّ بتكلفة باهظة للغاية.
والمركبات التي تعمل بطاقة المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت، قابلة للاستخدام في عمليات شبيهة بالعمليات التي تقوم بها الطائرات العادية، بشرط أن تقوم المصانع التي تنتجها بتوفير إمكانيات المرونة والسلامة والسعر المناسب لمهام الطيران الفائقة السرعة التي تتم في طبقات الجوّ العليا، أو في مدارات حول الأرض.
ونظراً الى أنها ليست في حاجة إلى حمل أجهزة الأكسدة الخاصة بها ـ كما يحدث بالنسبة الى الصواريخ ـ فإن المركبات التي تعمل بطاقة المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت، يمكن أن تكون صغيرة الحجم، وقادرة بالتالي على حمل المزيد من الأحمال الصافية.
وهذا النوع من الطائرات قادر على الاقلاع من مطارات حربية عادية، وعلى قطع المسافة بين أوروبا والهند في أقل من ٣٠ دقيقة! وهي تحمل على متنها أسلحة يمكن استخدامها لضرب أهداف أرضية من مسافات بعيدة، قبل أن تعود إلى قواعدها. كما يمكنها ـ بدلاً من ذلك ـ أن تواصل طيرانها، وتدخل الفضاء الخارجي، وتقوم بوضع أقمار اصطناعية في مدارات حول الأرض.
بالتزامن تقريباً مع الاختبار الذي أجري في ١٥ تشرين الأول (نوفمبر) لاختبار المركبة إيه ـ ٤٣ إكس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقوم بتطوير (تقنيّات منظومات صواريخ نوويّة جديدة، لا تمتلك مثلها القوى النوويّة الأخرى ولن تمتلك مثلها). ويعتقد بشكل عام، بأن بوتين يشير إلى الصواريخ الباليستية «آر إس ـ ١٢ إم توپول إم» المجددة، والتي يمكن إطلاقها من منصّات متحرّكة.
كما تخطّط روسيا أيضاً لوضع عشرات من صواريخ «إس إس ـ ١٩» التي يحمل كل واحد منها ست رؤوس حربية في الخدمة، من دون أن تقوم بخرق أية اتفاقية من الاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها.
ولكن الشيء الذي كان من الواضح أن بوتين يشير إليه بشكل محدّد هو الرأس الحربيّة/ أو المركبة المناورة، التي تمّ اختبارها في شباط (فبراير) الماضي، والتي يجري إعدادها حالياً للدخول في الخدمة. وقد يفيد أن نتذكر هنا أن روسيا قد أجرت اختبارات ناجحة لنسختها من المركبات العابرة للأجواء «تي إيه ڤي» والتي أطلقت عليها اسم الرأس الحربية الذرية المناورة، وذلك قبل أن تقوم الولايات المتحدة بعدها بإجراء اختبار ناجح لمركبتها إيه ـ ٤٣ إكس التي تزيد سرعتها على سرعة الصوت سبع مرات، في الشهر التالي.
ومن المعروف أن روسيا مهتمة بالصواريخ الأسرع من الصوت وبعمليات تطويرها، حيث قامت بنشر صواريخ سطح ـ جو بعيدة المدى منذ عقدين من الزمان. وفي شباط (فبراير) ٢٠٠٤، زعمت روسيا أنها قد قامت بإجراء اختبارات ناجحة على رأس حربية ذرّيّة استراتيجية، أسرع من الصوت، وقادرة على المناورة، ولا يمكن اعتراضها من قبل أية منظومة دفاعية في أي دولة من دول العالم.
وهذا الصاروخ الذي يعمل بطاقة المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت، يشبه الصواريخ التي تقوم أميركا بتطويرها حالياً وهي نوع من الصواريخ الباليستية، التي تقوم خلال المراحل الأخيرة من هبوطها بإطلاق رأس حربيّة نووية موضوعة في حامل صغير يعمل بطاقة المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت، يمكنه بدوره أن يواصل الطيران كصاروخ (تطوافي) قادر على تغيير مساره والارتفاع به، وعلى التغلّب على أي منظومة دفاع صاروخية، لأن الصواريخ التي ستعترضه لن تكون قادرة على المناورة بكفاية كي تتمكّن من إصابته.
وهناك دول أخرى تعمل أيضاً على تطوير تقنيات الدفع النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت. وسيؤدّي هذا كلّه إلى ترك الدول التي لا توجد لديها الامكانية للتوصّل إلى هذه التقنية، تحت رحمة الدول القليلة التي تمتلكها، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا بالطبع. ويجب النظر إلى هذه التطوّرات في ضوء الاتجاه الجديد الرامي إلى عسكرة الفضاء، وما يشكّله ذلك من تداعيات على سباق التسلّح بشكل عام. وإذا ما وضعنا في اعتبارنا أن المؤسّسات المتعدّدة الأطراف العاملة في مجال الحدّ من الأسلحة قد أصبحت موشكة على الانهيار، فإن هناك على ما يبدو القليل مما يمكن عمله من أجل إبطاء سرعة هذه الاتجاهات.
الأخبار تقول إن صاروخ «شهاب ـ ٣» الإيراني (١٣٠٠ ـ ١٥٠٠ كيلومتر)، والقادر على قطع مساره من ارتفاع ٢٥٨٥١ متراً، هو أول نموذج متطوّر صمّم بالاستناد الى صاروخي «جوري ـ ٢» الباكستاني «ونو ـ دونغ» الكوري الشمالي، بالتعاون مع روسيا والصين. وبالاضافة الى «شهاب ـ ٣» تواصل إيران برنامج تطوير قدراتها الصاروخية الهجومية التي تضم عائلة كاملة من الصواريخ البالستية المخصّصة لبلوغ مدى أكثر، ومنها «زلزال ١» و«زلزال ٢» و«زلزال ٣» التي يراوح مداها بين ٣٠٠ و٨٠٠ كيلومتر، كما أن إيران تقوم بتجارب على الطراز المعروف بـ«شهاب ٤» الذي يعتقد أنه نسخة عن الصاروخ السوفياتي القديم «سي سي ٤ ـ ساندال» الذي يصل مداه الى ٣ آلاف كيلومتر، وكذلك «شهاب ٥» الذي تقول مصادر الاستخبارات الغربية أنه نسخة عن الصاروخ الكوري الشمالي «تايبو دونغ ١» ويقدّر مداه بـ٥ آلاف كيلومتر.
والأخبار تقول إن «شهاب ٣» صاروخ يتمتّع بمزايا تجعل منه إضافة نوعية الى ترسانة الصواريخ الإيرانية، أبرزها، الى جانب سرعته، قدرته على حمل رأس حربية يراوح وزنها بين ٦٧٠ كلغ وألف كيلوغرام، الأمر الذي يشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل، حسبما ذكر خبراء إسرائيليون.
في الأخبار المحدودة التداول، حتى الآن، إن روسيا التي تحلم بالعودة الى أجواء السبعينيات من القرن الفائت، أبرمت مع أكثر من بلد عربي صفقات صواريخ متطوّرة، وأن سورية تسلّمت الدفعات الأولى من راجمات صواريخ مضادة للطائرات أطلق عليها صانعوها اسم «بانستير» أي الدرع، وهي معروفة باسم «بانستير إس ـ ١» أو «إس. إيه ٢٢» كما يسمّيها الغربيون، وهي عبارة عن منظومة تحتوي كل منها على راجمة بـ١٢ صاروخاً مضادة للطائرات ومدفعين من عيار ٣٠ ملليمتراً ومحطّة رادار.
وفي هذا السياق، يقول الأميركيون إن الغارة الجوّيّة التي استهدفت الشمال السوري في أيلول (سبتمبر) الفائت، كان القصد منها استكشاف القدرة الرادعة لهذه المنظومة.
ويبلغ مدى صاروخ «بانتسير إس ـ ١» ١٢٠٠ متر في حدّه الأدنى و٢٠ ألف متر في حدّه الأقصى، وهو قادر على تدمير أهداف يراوح ارتفاعها بين ١٥ متراً و١٥ ألف متر. والمنظومة تتعامل مع أهداف تبلغ سرعتها القصوى ألف متر في الثانية، ويراوح المدى المجدي للمدفعين التابعين للمنظومة ـ حسب ما أوردته وكالة نوڤوستي الروسية ـ بين ٢٠٠ و٤٠٠٠ متر، ويقال إن سورية تعاقدت على شراء ٥٠ منظومة من هذا الطراز، أو ربما ٣٤ الى ٣٦ منظومة.
وهناك تسريبات صحفية مفادها أن سورية يمكن أن تسلّم عشراً من هذه المنظومات الى إيران، مقابل دفعة من الصواريخ الإيرانية المتوسطة المدى (شهاب ٣)، الأمر الذي يستبعده الروس، لأن موسكو تشترط في عقد مثل هذه الصفقات أن لا يتمّ نقلها الى بلد آخر، علماً أن الإمارات العربية المتحدة تعاقدت، هي الأخرى، على شراء ٥٠ منظومة من النوع نفسه، ويقال إنها تسلّمت ١٢ منها حتى الآن، وأن الدفعتين المتبقّيتين سوف تسلّمان في العام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
وتشمل صفقة الأسلحة التي وقّعتها روسيا مع الجزائر في آذار (مارس) ٢٠٠٦ ٣٨ منظومة من طراز «بانستير إس ـ ١»، وهناك معلومات غير رسمية تفيد أن الصين واليونان بدأتا مفاوضات مع روسيا لشراء هذا النوع من الصواريخ، علماً أن الجيش الروسي سوف يضعها في الخدمة الفعلية اعتباراً من العام المقبل.
كل هذا يعني أن قواعد الحرب والسلام تتغيّر في الشرق الأوسط، وأن معادلة السلام الاستراتيجي صارت من الماضي. وقد برهنت حرب تموز (يوليو) ٢٠٠٦ بين إسرائيل و«حزب الله» أن إسرائيل ليست بالضرورة، أو أنها لم تعد، الدولة التي لا تقهر في المنطقة. ورغم أن الإسرائيليين يميلون الى التعايش مع نتائج هذه المعركة، ورغم أن القرار ١٧٠١ يشكّل في النهاية رافعة دولية لحماية إسرائيل، فإن أصواتاً في تل أبيب بدأت تطالب بخلق فرص لعملية سياسية واسعة وتهيئة المناخ لحوار مع سورية.
ويبدو أن دمشق أمسكت بطرف الخيط عندما شاركت في مؤتمر آنابوليس، لأنها فهمت الرسالة، رغم أنها لا تزال تشدّد خطابها السياسي، علماً أنها لا توفّر أي فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية. ويؤكّد خبير عسكري سوري أن بلاده تملك ترسانة ضخمة من الأسلحة الصاروخية المتوسطة المدى وبعيدها، الكورية والروسية الصنع، وأنها طوّرت نموذجاً من هذه الصواريخ، لزيادة قدرته التدميرية في استهداف المراكز الحيوية والبنى التحتية في إسرائيل. الخبير نفسـه يؤكّد أن قدرات الصواريخ السورية كبيرة، وأن دقّة إصابتهـا عالية، ووزن العبوة التي تحملها تتجـاوز نصف طن، ثم إن قدرتهـا على اختراق الأجـواء الإسـرائيليـة عالية بسبب وجود مواد عازلة لا تكشفها الرادرات ولا يستطيع «الباتريوت» (الصاروخ المضاد للصواريخ) التصدّي لها، وإذا هي اكتشفت فإن إسقاطها صعب للغاية، لأن المدة التي تحتاجها للوصول الى أهدافها لا تزيد على ٩٠ ثانية.
وفي معلومات أخرى، إن أي حرب تنشب بين سورية وإسرائيل سوف تكون مواجهة تخرج على الاطار التقليدي، وقد تستعمل فيها أسلحة بيولوجية أو كيميائية، وأن مطالبة سورية بإدراج الجولان على جدول أعمال «آنابوليس ٢» تنستند، في جملة ما تسند إليه، الى هذه الاحتمالات. في الوقت نفسه، تتحدّث تقارير غربية استخباراتية عن أن سورية بدأت وضع خطّة عاجلة لبناء ملاجئ ذات مواصفات خاصة تستوعب الآلاف في مختلف المحافظات، كما تستوعب مخازن كبيرة من المواد التموينية، في الوقت الذي تمسك بأوراقها التفاوضية في لبنان وفلسطين والعراق، وكذلك بتحالفها الاستراتيجي مع إيران.
تهافت دولي
المهم في الأمر، أن الظاهرة لا تقتصر على إيران وسورية وإسرائيل، وإنما تندرج في إطار سباق الأسلحة الصاروخية البرّيّة والبحريّة والجوّيّة على امتداد «الشرق الأوسط الكبير» (باكستان ضمناً)، بحيث لم تعد هناك فترة قصيرة تفصل بين إجراء تجربة صاروخية في بلد، وإجراء تجربة مماثلة في بلد مجاور، أو في بلد آخر يقع في أقاصي الأرض، مع ثلاث مفارقات رئيسية:
أولاً: إن استخدام الأسلحة الصاروخية وانتشار تقنيّاتها، لم تعد محصورة أو محدّدة بمحيط الدول والجيوش النظامية، وإنما أصبح في استطاعة التنظيمات شبه العسكرية أو الميليشيات الحصول على مختلف أنواع الأسلحة الصاروخية.ثانياً: إن الدول الكبرى، وعبر سياستها غير الثابتة وغير المستقرة، كثيراً ما تمارس الدور الحاسم في انتشار الأسلحة الصاروخية وتقنيّاتها، مثل تسليح أميركا تنظيم طالبان (بصواريخ ستينغر) إبّان الحرب ضد قوّات الاتحاد السوفياتي. ثالثاً: إن سوق السلاح في العالم لا يستطيع فرض قيود صارمة ضد انتشار الأسلحة الصاروخية، أو ضد انتشار تقنيّاتها، أو الحصول على مكوّنات هذه الأسلحة مثل ما يحدث في فلسطين والعراق، فهل يمكن الحدّ من تطوّر الأسلحة والتقانة في ظل انتشار المعرفة الصناعية، وفي ظل الاستخدامات المزدوجة للتقنيات العلمية؟؟ يمكن هنا تجاوز تجربة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في مجال صناعة صواريخ القسّام، وكذلك ما يُقال عن تجربة «حزب الله» في تطوير وصناعة أسلحة صاروخية يمكن لها ضرب العمق الإسرائيلي، وما يماثل ذلك من التجارب المحدودة، والتي تبرهن على توافر القدرة لدى كل الشعوب، لتطوير أسلحة صاروخية من كل الأنواع والقدرات، والتوقُّف عند تجربة خاصة، ربما حدثت تجارب كثيرة مماثلة لها من حيث وصول الأسلحة الصاروخية إلى عناصر أو حتى خلايا منظّمة لا تتوافر لها القدرة على استخدام هذه الأسلحة، أو ربما معرفة خصائصها ومزاياها؛ وخلاصة التجربة كما أُعلن في العاصمة الأردنية (عمّان) (يوم ١٤ آذار / مارس ٢٠٠٦) على النحو التالي: «أحال المدّعي العام الأردني ستة سوريين وأردنياً موقوفين منذ ثمانية أشهر على المحكمة، بتهمة تدبير إطلاق ثلاثة صواريخ على بارجة أميركية في خليج العقبة، (يوم التاسع من أيلول /سبتمبر ٢٠٠٥)، مما أدّى إلى قتل عسكري أردني وإصابة آخر. وكشفت لائحة الاتهام أن العملية شارك فيها ١٢ شخصاً أهمهم: عبد الله السحلي، ومحمد حسن وأولاده الخمسة الذين قَدِمَ اثنان منهم من العراق وبحوزتهما سبعة صواريخ كاتيوشا جرى تهريبها داخل خزّان سيارة مرسيدس، من أجل مهاجمة السفارتين الأميركية والإسرائيلية في عمّان، قبل أن يتحوّلوا مصادفة إلى العملية لضرب البارجة الأميركية». ويصبح لزاماً بعد ما سبق عرضه، التوقُّف عند قصة (صواريخ بيونغ يانغ)، فقد بقيت كوريا الشمالية على رأس (محور الشر) بسبب امتلاكها السلاح النووي، والصواريخ القادرة على حمل النار النوويّة إلى داخل الولايات المتحدة الأميركية، وقد أفادت الولايات المتحدة الأميركية من هذا التحدّي لدعم مشروعها (الدرع الصاروخية)، ولفرض رقابة دائمة على كوريا، «فقد أعلنت كوريا الديمقراطية (يوم ١ شباط / فبراير ٢٠٠٦) أن الولايات المتحدة أجرت خلال شهر كانون الثاني (يناير) وحده أكثر من ١٩٠ طلعة تجسّسية فوق أراضيها، وكانت الطائرات من أنواع: يو ٢، و آر سي ١٣٥، و آي بي ٣»، واعتبرت (بيونغ يانغ) أن ذلك يزيد في حالة التوتّر، وردّت على ذلك (يوم ١٤ آذار / مارس ٢٠٠٦) باستعدادها لاجتياح كوريا الجنوبية، وردّت كوريا الجنوبية والقوّات الأميركية على هذا التحدّي الاستفزازي وأمثاله بمناورات عسكرية مشتركة.
سباق التسلّح الجديد في المنطقة يشكّل جزءاً من هذا التهافت على المستوى العالمي، ومبيعات الأسلحة الإيرانية تشكّل جزءاً من مبيعات أكثر اتّساعاً تتولاها الدول الكبرى وإسرائيل، والحديث عن إطلاق قمر صناعي إيراني يشكّل بدوره امتداداً لإطلاق أقمار أخرى معظمها إسرائيلي الى الفضاء الخارجي، وعائلة «شهاب» الصاروخية الإيرانية هي الردّ المباشر على عائلة «حيتس» الإسرائيلية، والحملة الإسرائيلية المتواصلة على إيران. والبرامج التسليحية الإيرانية ذات أهداف مزدوجة: إثارة المخاوف الإقليمية من الدور الإيراني الجديد وتبرير التسلح الإسرائيلي المتزايد. وليس سرّاً أن الولايات المتحدة وقّعت اتفاقية مع إسرائيل خلال العام ٢٠٠٧، تقضي بتزويد الدولة العبرية بأسلحة قيمتها الاجمالية ٣٠ مليار دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة، وأن المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل ارتفعت بمعدّل ٢٥ بالمئة عما كانت عليه في السنوات الأخيرة. وتنصّ الصفقة على أن يشتري الإسرائيليون ربع حاجاتهم من السوق المحلّيّة، وأن يخصّصوا الاعتمادات الباقية لشراء الأسلحة الأميركية المتطوّرة. والاعلان الأميركي عن صفقات «متوازنة» مع السعودية ومصر والأردن وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات، يشكّل محاولة لتغطية الانحياز المفضوح الى ضمان التفوّق الإسرائيلي.
ولا يمكن التوقّف عند هذا الحد في الكلام على السباق الصاروخي، من دون أن نعرج ولو بسرعة، على سباق آخر لم يتناوله الاعلام العسكري بقدر كاف من الاهتمام حتى الآن، هو السباق الى اقتناء الطائرات والصواريخ الأسرع من الصوت التي لا يمكن اعتراضها من قبل أي منظومة دفاعية في العالم.
في هذا السياق، يقول الخبير العسكري جاسبيت سينغ (المركز الدولي لدراسات أميركا والغرب)، إنه واحد من أعمق التطوّرات التي سوف تؤدّي الى تغيير الصورة الاستراتيجية الدولية في غضون العقد المقبل أو نحوه، وهو رواية من روايات الخيال العلمي تتحوّل اليوم الى حقيقة واقعة.
ويضيف: في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سجّلت طائرة وكالة «ناسا» من طراز إيه ـ ٤٣ إكس رقماً قياسياً عالمياً في السرعة بلغ ١٠ (ماخ)، وهو ما يعادل ضعف سرعة الصوت ١٠ مرات، وذلك عند طيرانها على ارتفاع ٣٤ كيلومتراً (١١٠ آلاف قدم).
ويمكن القول على سبيل التبسيط، إن سرعة تلك الطائرة تساوي سرعة مركبة تسير بسرعة ١١ ألف كيلومتر في الساعة!... وهو ما يمثّل إنجازاً علمياً هائلاً في الحقيقة. وهذه المركبة الصغيرة هي جزء من برنامج «ناسا» المسمّى «هيپر إكس» الذي تبلغ تكلفته ٢٣٠ مليون دولار، والذي يهدف إلى تطوير ما أصبح يصطلح على تسميّته بـ«المركبة العابرة للأجواء»، والتي يرمز إليها على سبيل الاختصار بالحروف «تي إيه ڤي» وهي الحروف الأولى من اسمها باللغة الإنكليزية.
وستستخدم «ناسا» في تلك الطائرة التقنيّة المعروفة بتقنيّة (المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت)، وهي تقنيّة تقوم فيها السرعة الفائقة بضغط كمّيّات الهواء القليلة المتاحة لإنتاج كمّيّات كافية من الأوكسيجين)، لتحقيق احتراق مزيج الهواء ـ الوقود في السرعات الفائقة (الأسرع من الصوت)... ومن الواضح أن هذه التقنيّة قد أصبحت الآن على حافة النضوج.
وهناك استخدامان على الأقل لتقنيّات المركبات العابرة للأجواء: الاستخدام الأول هو استخدامها في إطلاق طائرة فضائية تستخدم في عدد من الأغراض المدنية والعلمية. أما الاستخدام الثاني فهو استخدامها في أدوار عسكرية ـ استراتيجية. فنظراً الى عدم وجود هواء ولا أوكسيجين في الجوّ، فإن وقود الصواريخ يجب أن يحتوي على الهواء والأوكسيجين ضمن مكوّناته. لذلك نجد أن المركبات العادية التي يتم إطلاقها في الفضاء، غالباً ما تكون مضطرة إلى حمل كمّيّات كبيرة من وقود الصواريخ، حتى يتم إطلاقها للفضاء الخارجي وهو ما يتمّ بتكلفة باهظة للغاية.
والمركبات التي تعمل بطاقة المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت، قابلة للاستخدام في عمليات شبيهة بالعمليات التي تقوم بها الطائرات العادية، بشرط أن تقوم المصانع التي تنتجها بتوفير إمكانيات المرونة والسلامة والسعر المناسب لمهام الطيران الفائقة السرعة التي تتم في طبقات الجوّ العليا، أو في مدارات حول الأرض.
ونظراً الى أنها ليست في حاجة إلى حمل أجهزة الأكسدة الخاصة بها ـ كما يحدث بالنسبة الى الصواريخ ـ فإن المركبات التي تعمل بطاقة المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت، يمكن أن تكون صغيرة الحجم، وقادرة بالتالي على حمل المزيد من الأحمال الصافية.
وهذا النوع من الطائرات قادر على الاقلاع من مطارات حربية عادية، وعلى قطع المسافة بين أوروبا والهند في أقل من ٣٠ دقيقة! وهي تحمل على متنها أسلحة يمكن استخدامها لضرب أهداف أرضية من مسافات بعيدة، قبل أن تعود إلى قواعدها. كما يمكنها ـ بدلاً من ذلك ـ أن تواصل طيرانها، وتدخل الفضاء الخارجي، وتقوم بوضع أقمار اصطناعية في مدارات حول الأرض.
بالتزامن تقريباً مع الاختبار الذي أجري في ١٥ تشرين الأول (نوفمبر) لاختبار المركبة إيه ـ ٤٣ إكس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقوم بتطوير (تقنيّات منظومات صواريخ نوويّة جديدة، لا تمتلك مثلها القوى النوويّة الأخرى ولن تمتلك مثلها). ويعتقد بشكل عام، بأن بوتين يشير إلى الصواريخ الباليستية «آر إس ـ ١٢ إم توپول إم» المجددة، والتي يمكن إطلاقها من منصّات متحرّكة.
كما تخطّط روسيا أيضاً لوضع عشرات من صواريخ «إس إس ـ ١٩» التي يحمل كل واحد منها ست رؤوس حربية في الخدمة، من دون أن تقوم بخرق أية اتفاقية من الاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها.
ولكن الشيء الذي كان من الواضح أن بوتين يشير إليه بشكل محدّد هو الرأس الحربيّة/ أو المركبة المناورة، التي تمّ اختبارها في شباط (فبراير) الماضي، والتي يجري إعدادها حالياً للدخول في الخدمة. وقد يفيد أن نتذكر هنا أن روسيا قد أجرت اختبارات ناجحة لنسختها من المركبات العابرة للأجواء «تي إيه ڤي» والتي أطلقت عليها اسم الرأس الحربية الذرية المناورة، وذلك قبل أن تقوم الولايات المتحدة بعدها بإجراء اختبار ناجح لمركبتها إيه ـ ٤٣ إكس التي تزيد سرعتها على سرعة الصوت سبع مرات، في الشهر التالي.
ومن المعروف أن روسيا مهتمة بالصواريخ الأسرع من الصوت وبعمليات تطويرها، حيث قامت بنشر صواريخ سطح ـ جو بعيدة المدى منذ عقدين من الزمان. وفي شباط (فبراير) ٢٠٠٤، زعمت روسيا أنها قد قامت بإجراء اختبارات ناجحة على رأس حربية ذرّيّة استراتيجية، أسرع من الصوت، وقادرة على المناورة، ولا يمكن اعتراضها من قبل أية منظومة دفاعية في أي دولة من دول العالم.
وهذا الصاروخ الذي يعمل بطاقة المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت، يشبه الصواريخ التي تقوم أميركا بتطويرها حالياً وهي نوع من الصواريخ الباليستية، التي تقوم خلال المراحل الأخيرة من هبوطها بإطلاق رأس حربيّة نووية موضوعة في حامل صغير يعمل بطاقة المحرّك النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت، يمكنه بدوره أن يواصل الطيران كصاروخ (تطوافي) قادر على تغيير مساره والارتفاع به، وعلى التغلّب على أي منظومة دفاع صاروخية، لأن الصواريخ التي ستعترضه لن تكون قادرة على المناورة بكفاية كي تتمكّن من إصابته.
وهناك دول أخرى تعمل أيضاً على تطوير تقنيات الدفع النفّاث التضاغطي الأسرع من الصوت. وسيؤدّي هذا كلّه إلى ترك الدول التي لا توجد لديها الامكانية للتوصّل إلى هذه التقنية، تحت رحمة الدول القليلة التي تمتلكها، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا بالطبع. ويجب النظر إلى هذه التطوّرات في ضوء الاتجاه الجديد الرامي إلى عسكرة الفضاء، وما يشكّله ذلك من تداعيات على سباق التسلّح بشكل عام. وإذا ما وضعنا في اعتبارنا أن المؤسّسات المتعدّدة الأطراف العاملة في مجال الحدّ من الأسلحة قد أصبحت موشكة على الانهيار، فإن هناك على ما يبدو القليل مما يمكن عمله من أجل إبطاء سرعة هذه الاتجاهات.